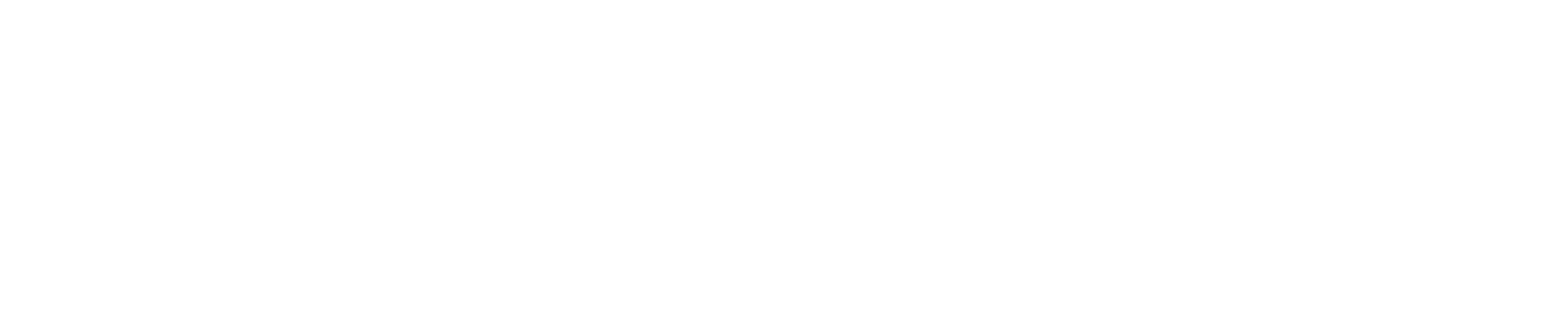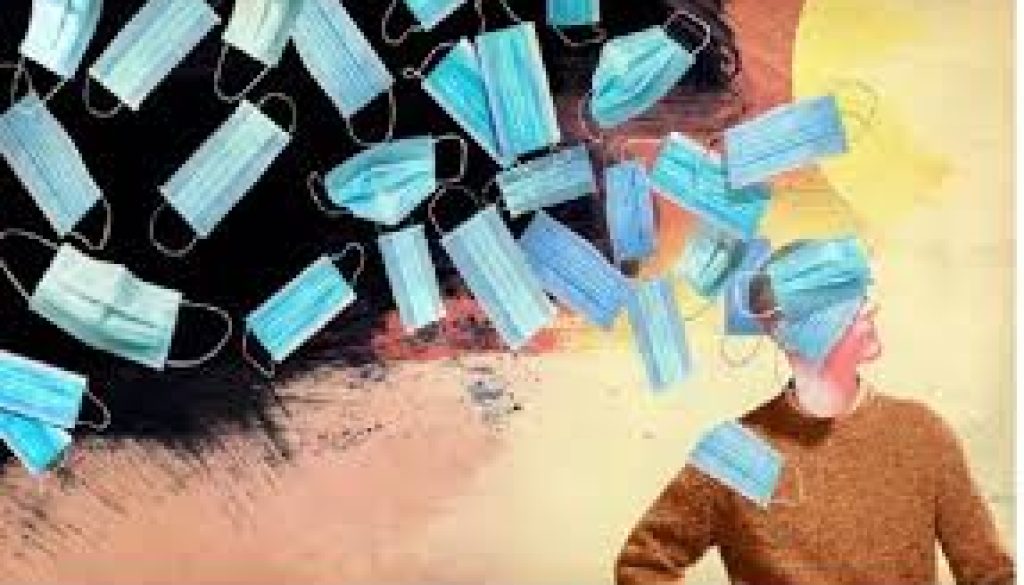ما بعد كورونا.. خارطة جديدة للعالم لا تزال تتشكل أمام الأعين
(البيان)-28/04/2025
بعد انقضاء خمس سنوات، يثير استيائي قول البعض «لقد استمتعت بفترة جائحة كورونا». ويبدو أن العديد من المنتمين إلى ما يُعرف بـ«النخبة الرقمية» يحيون في عالم موازٍ، بعيد كل البعد عن وطأة المعاناة التي ألمت بملايين البشر جراء الجائحة، وبمنأى عن التداعيات الواسعة والمختلفة التي لا تزال تتكشف فصولها حتى يومنا هذا.
من الطبيعي أن نرغب في طي هذه الصفحة، فلماذا نستمر في اجترار ذكريات تلك الفترة المروعة؟ تكمن الإجابة جزئياً في احتمال مواجهتنا لجائحة أخرى، وجزئياً لأن معاناتنا لم تكن متساوية. وقبل ظهور اللقاح، تخبط صانعو السياسات في التعامل مع وضع غير مسبوق، بينما فقد الشباب مراحل محورية من تطورهم. كذلك، فقد خاطر العاملون في القطاعات الحيوية بأرواحهم للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، في حين تقوقع الكثير من واضعي القواعد في اجتماعات «زوم» افتراضية.
لا غرابة إذن في ظهور تداعيات طويلة المدى على الثقة العامة، فقد أظهر استطلاع في فبراير أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتقدون أن الجائحة عمقت الانقسامات في بلادهم، أما في المملكة المتحدة، فقد بلغت نسبة من يصرحون بأنهم «لا يثقون بالمرة تقريباً» بالحكومة في تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية رقماً قياسياً بلغ 45%، بزيادة 22 نقطة عما كانت عليه خلال ذروة الجائحة، كما تراجعت الثقة في المؤسسة الشرطية بشكل ملحوظ.
هل يمكن أن يفسر هذا جزئياً التحول السياسي نحو اليمين؟ فالتضخم والنزعة المعادية للسلطة القائمة ومعدلات الهجرة القياسية، وكلها عوامل أسهمت في صعود الأحزاب الشعبوية في أوروبا وأمريكا، غير أن حالة التشكيك العميق التي تتبناها هذه الحركات تجاه المؤسسات والأحزاب التقليدية، فضلاً عن موقفها من اللقاحات وتغير المناخ، قد تكون مستمدة جزئياً من تداعيات أزمة كورونا.
وقد كشفت دراسة لافتة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عام 2021 أنه في حين اعتقدت أغلبية المستجيبين أن صناع السياسات سعوا للحد من انتشار الفيروس، رأت أقليات كبيرة أن الإغلاق والقيود الأخرى كانت مدفوعة بالرغبة في إحكام السيطرة، خاصة في دول جنوب وشرق أوروبا، حيث أفادت الأغلبية بتأثرها الشخصي من الجائحة (نحو ثلثي المستجيبين في البرتغال وبولندا وإسبانيا والمجر)، وكان المتضررون اقتصادياً الأكثر ميلاً للقول إن القيود كانت مفرطة القسوة، والأكثر تشكيكاً في النوايا وراء الإغلاق، وينطبق الأمر ذاته على الشباب، الذين كانوا أكثر عرضة من كبار السن للإبلاغ عن تضررهم الشديد.
في كتاب حديث، يقدم عالما السياسة بجامعة برينستون ستيفن ماسيدو وفرانسيس لي طرحاً مثيراً مفاده أن جماعة الأكاديميين التقدميين ملزمة بالتعامل بجدية أكبر مع مشاعر الاستياء العام، ويعبران عن شعورهما العميق بالأسى لاستمرار الانقسامات الحزبية حول الجائحة، رغم الفرصة السانحة للتعلم من المقاربات المتباينة التي اعتمدتها الولايات الأمريكية المختلفة.
فقد سارعت الولايات ذات التوجه الجمهوري «الحمراء» إلى إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية بوتيرة أسرع من نظيراتها الديمقراطية «الزرقاء»، وحظي طلاب المدارس العامة في الولايات ذات الميول الجمهورية بتعليم حضوري يفوق بنسبة 60% ما حصل عليه نظراؤهم في الولايات ذات التوجه الديمقراطي خلال العام الدراسي 2020 ـ 2021.
ومع ذلك، يؤكد المؤلفان عدم وجود «فارق جوهري» في معدلات الوفيات بين الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين حتى ظهور اللقاح، لتتحول الدفة بعدها بشكل دراماتيكي، حيث أصبح الجمهوريون أكثر عرضة للوفاة جراء كوفيد – بسبب انخفاض إقبالهم على التطعيم.
وبدلاً من استخلاص الاستنتاجات الواضحة تمسك كل طرف بمواقفه المسبقة، فقد تباهى الحزبان بسجلاتهما في إدارة الأزمة.
وتنسجم هذه العصبية القبلية مع فقاعات التواصل الاجتماعي التي دُفع الشباب إليها نتيجة الحرمان القسري من التفاعل الاجتماعي المباشر، حيث قضى الشبان والشابات ساعات طويلة بمفردهم عبر الإنترنت، مستهلكين محتوى متبايناً في جوهره: فهل لهذا صلة بالفجوة المتنامية في توجهاتهم الحالية؟ لقد شكل الفضاء الرقمي بوتقة مثالية لنظريات المؤامرة التي يزدهر عليها الخطاب الشعبوي، وقد سهلت السلطات هذا المسار عبر تشويه صورة كل من تجرأ على التشكيك، ولو بصورة معتدلة، في جدوى حظر السفر أو إغلاق المدارس، أو حتى التساؤل عن احتمالية تسرب الفيروس من مختبر.
وسيكون من الخطأ أن نعزو صعود دونالد ترامب إلى هذه العوامل وحدها – أو لأي حزب منفرد، غير أننا قد نكون على أعتاب مرحلة أيديولوجية جديدة، تمزج فيها الأحزاب بين النزعة القومية وعدم الثقة بالمؤسسات التقليدية، والتشكيك في شركات التكنولوجيا العملاقة والمنظومة العلمية.
ويتجاهل هذا الإعراض عن مواجهة ماضي الجائحة فئتين رئيسيتين تعانيان في صمت، أولاهما من حرموا وداع أحبائهم في لحظاتهم الأخيرة، حيث تحولت حياة هؤلاء إلى جحيم من الأفكار المؤرقة، وباتوا فريسة لاضطراب ما بعد الصدمة، يطاردهم شبح الندم وفكرة قاسية مفادها أن أقاربهم المنعزلين فقدوا رغبتهم في الحياة حين وجدوا أنفسهم وحيدين.
أما الفئة الثانية، فهم ضحايا «كوفيد طويل الأمد» الذين يكابدون أعراضاً مزمنة أنهكت أجسادهم وأرواحهم. وجسّدت كيت واينبيرغ هذه المعاناة ببراعة في كتابها الصادر مؤخراً «لا شيء خاطئاً معها»، ولعل لجوءها إلى تقديم محنتها الشخصية في ثوب روائي يعكس حجم الإنكار المجتمعي لواقع هؤلاء المرضى وتجاربهم المريرة.
ورغم أن العالم استفاض في الحديث عن آثار الجائحة الظاهرة، من فواجع وتحولات رقمية وأطفال تضرروا نفسياً وتعليمياً، إلا أن ثمة تداعيات أخرى تتكشف يوماً بعد يوم، مما يستوجب منا رصدها بعناية إذا ما أردنا مواجهة الجائحة القادمة بحكمة وجاهزية أفضل.