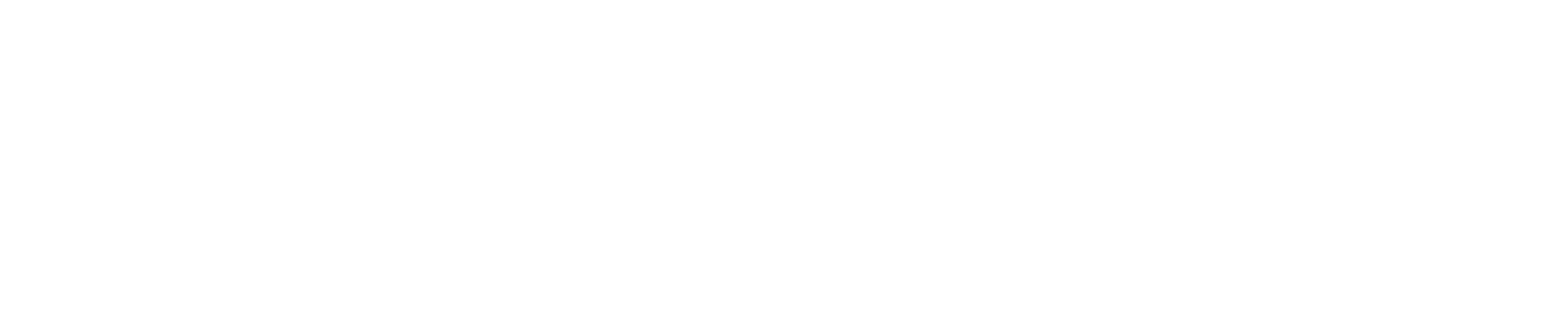فلسفة المصارف الإسلامية
برز في النصف الثاني من القرن العشرين مصطلح المصارف الإسلامية كنظام مصرفي له أصوله ومبادؤه وقواعده المستقلة، وأصبحت الصناعة المالية الإسلامية اليوم واقعاً ماثلاً للعيان، تحتل مكانة متميّزة في النظام المالي العالمي، وقد تميّزت المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية بفلسفتها وأساليبها الإستثمارية التي واكبت النظام المالي الحديث وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قامت بتوظيف الأموال وإستثمارها بإشراك العميل بالربح والخسارة، وممارسة المتاجرة مباشرة، بخلاف المصارف التجارية.
وقد حظيت المصارف الإسلامية بإهتمام العديد من دول العالم المتقدم، نتيجة لما حققته من نجاحات كبيرة في إدارة الأموال بما يحقق التنمية الإجتماعية وإعادة توزيع الدخول وبشكل يتوافق مع متطلّبات الإستقرار النقدي والإقتصادي.
إن الكثير من المسلمين رفضوا التعامل مع البنوك التجارية التي يركز أسلوب عملها على المتاجرة في الديون بالإقتراض والإقراض إعتماداً على آلية سعر الفائدة التي حرّمها الدين الإسلامي بشكل لا يقبل النقاش، إلى جانب عدم إكتراث البنوك التجارية بما تقوم بتمويله من مشروعات وما تقدمه من خدمات وإن كانت مخالفة لقناعات المسلمين، لذلك فإن تأسيس البنوك الإسلامية جاء من منطلق الدعوة إلى إيجاد مصارف بديلة للمصارف التجارية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بطرق وأساليب موافقة للشريعة الإسلامية، كما برزت الحاجة الى تأسيس مصارف تقوم بتشجيع الإستثمار وعدم الإكتناز وجذب المدّخرات المعطلة التي إمتنع أصحابها عن توظيفها في البنوك التجارية، وتقديمها كتمويلات لتأخذ مسارها الصحيح في الدورة الإقتصادية.
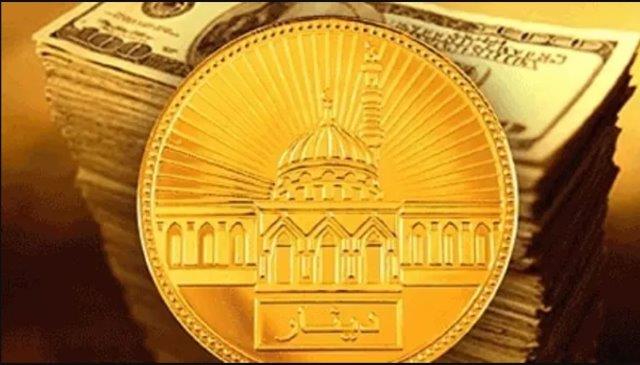
وتركّز المصارف الإسلامية على توظيف المال في مسار قائم على مشروعات حقيقية وليس في عقود خيارات ومشتقات او بيع وتأجير النقد، الذي يُعتبر حراماً في نظر المسلمين وهو مسبب رئيسي لتفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الأزمات.
تتميّز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية في 3 محاور رئيسية هي أسلوب الوساطة القائم على المشاركة بالربح والخسارة، فهي تعامل أصحاب الفائض المالي على أنهم شركاء في عائد إستثمار أموالهم وتعيد تقديمها لأصحاب العجز المالي على أنهم شركاء في عائد إستثمارها وليس وساطة مديونية قائمة على المتاجرة بالديون. والأمر الثاني بأن طبيعة النشاط المستهدف هو الإقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات وليس النشاط المالي الذي لا يخلق ثروة حقيقية.
والأمر الأهم هو أن إستحقاق العائد في المصارف الإسلامية مقترن بالمخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم وليس بضمان رأس المال وتأجيره وفق سعر ثابت.
وقد ظهرت المصارف الإسلامية في سبعينات القرن الماضي، حيث تأسس بنك دبي الإسلامي في العام 1975، ثم بنك فيصل المصري وبيت التمويل الكويتي في العام 1977، ثم البنك الإسلامي الأردني في العام 1978 ثم توالت المصارف الإسلامية، وفي ثمانينيات القرن الماضي ظهرت محاولات رائدة لأسلمة النظام المصرفي من قبل الحكومات، حيث قامت حكومات (إيران، باكستان، السودان) بتحويل بنوكها المركزية للعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وظهرت مجاميع دولية إسلامية أبرزها مجموعة البركة ومجموعة بنوك فيصل.
وفي مطلع القرن الحالي، إنتشرت ظاهرة التحوُّل من البنوك التجارية إلى البنوك الإسلامية، مثل بنك الشارقة في العام 2002 وبنك الجزيرة السعودي في العام 2005، وتم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي مؤسسات دولية داعمة للصناعة المالية الإسلامية ذات طابع إشرافي تهدف الى زيادة التنظيم وتوحيد المعايير للإرتقاء بمستوى البنوك الإسلامية.
وقد ركّزت المصارف الإسلامية على أسس وقواعد أبرزها (النقود وسيلة وليست سلعة، لا قيمة للزمن إذا لم يصاحبه عمل أو إنتاج، الربح مشاع % وغير مضمون، الدين لا يباع). ويُعتبر المصرف الإسلامي شاملاً لأنه يقدم تمويلاته وخدماته لكافة القطاعات (التجارية، العقارية، الصناعة والزراعة) وتتصف تمويلاته بالتنوّع ما بين تمويل نقدي وتمويل سلعي وتتعدد آجال تمويلاته ما بين القصير ومتوسط وطويل الأجل، مما يُضفي عليه صفة مؤسسة تمويلية. وتخضع كل عملياته وتعاملاته المالية الى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف التي تكون مستقلة عن الإدارة، إلى جانب أن المصرف يخضع أيضاً لهيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي للدولة التي يعمل بها.
من الجدير بالذكر، أن البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التجارية في تكوين (الإحتياطات) وهي أموال مقتطعة من الأرباح لتدعيم رأس المال، حيث يقوم المصرف الإسلامي بخلط أموال المساهمين مع أموال المودعين وتوظيفها معاً، وعندما تتحقق الأرباح سيتم توزيعها على الطرفين (المساهمين وأصحاب حسابات الإستثمار) والإحتياطات طالما أنها تستخدم لتدعيم رأس المال، ورأس المال يخص المساهمين فقط، ولا يشارك فيه أصحاب حسابات الإستثمار، فهذا يعني أن تؤخذ الإحتياطات من أرباح المساهمين فقط وليس من أرباح المصرف ككل، بحيث لا تُقتطع من أرباح أصحاب حسابات الإستثمار، لأنهم شركاء مع المصرف في الربح الذي نجم عن تشغيل أموالهم، أما الإحتياطات فبما أنها ستُوجّه لتدعيم رأس المال فهي تخص المساهمين وحدهم وتُعتبر حقاً من حقوقهم لذلك تؤخذ من أرباحهم.
كذلك ينطبق الحال نفسه على الأرباح المحتجزة التي تدخل ضمن حقوق المساهمين، لذلك يتم اقتطاعها حصراً من أرباح المساهمين وليس من أرباح حسابات الاستثمار، بينما تكون عملية تكوين المخصّصات من إجمالي أرباح المصرف (أرباح المساهمين وحسابات الاستثمار معاً) لان هذه المخصّصات يتم تكوينها لغرض مواجهة الأعباء والخسائر التي قد تحصل مستقبلاً، وتُعتبر حساباً مشتركاً ما بين المساهمين وأصحاب حسابات الإستثمار (المودعين) لأنها تُعتبر تكلفة أو إنفاقاً لم يُصرف بعد. وإذا ما أُتيح توظيفها لحين الحاجة إليها، فإن الأرباح التي قد تتولّد عنها لا تُضاف الى المساهمين وحدهم، ولكنها تُضاف الى مجمل أرباح المصرف وتوزّع بين المساهمين والمودعين أصحاب حسابات الإستثمار.