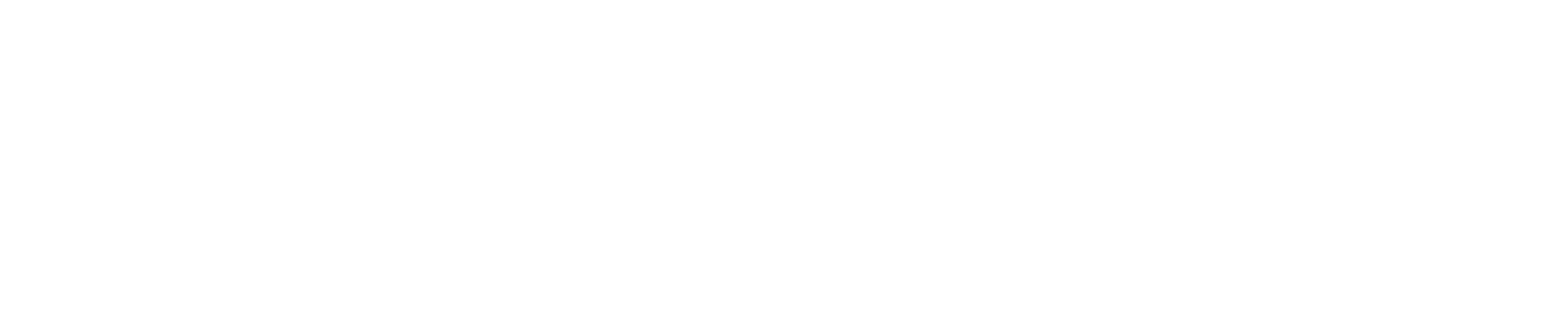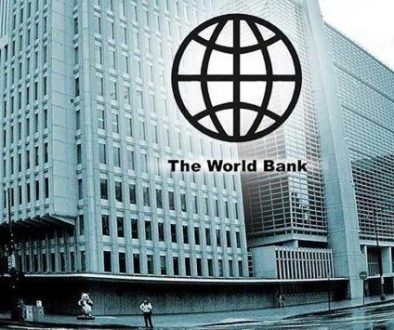QNB: القوى الإنكماشية ستظل مهيمنة على الإتجاهات المستقبلية للإقتصاد الكلي العالمي
 توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الإنكماشية طويلة الأمد، لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات، مهيمنة على إتجاهات المستقبلية للإقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الإرتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي.
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الإنكماشية طويلة الأمد، لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات، مهيمنة على إتجاهات المستقبلية للإقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الإرتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي.
وأشار البنك في تقريره إلى أن الإقتصاد العالمي لم يعد مستقراً في بيئة تضخمية أو إنكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية، موضحاً أن التغيُّرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تُعد من أكثر المؤشّرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الإقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الإقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معياراً أساسيا لقياس متانة الأوضاع الإقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الإستثمار، وتوجهات السياسات النقدية.
وأضاف التقرير: أن مستوى معيناً من التضخُّم يُعتبر أمراً طبيعياً، بل ضرورياً لدعم النمو الإقتصادي، في حين أن معدّلات التضخُّم المفرط أو الإنكماش الحاد قد تؤدي إلى إختلالات هيكلية وتداعيات إقتصادية طويلة الأمد.
وأفاد التقرير أن معدّلات التضخُّم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يُسمّى بالإعتدال الكبير (1990-2007) في غالبية الإقتصادات المتقدمة، تعكس عادة إقتصاداً حيوياً يحقق نمواً متوازناً.. كما أنه يُجبر البنوك المركزية على الإستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية.
وعلى العكس من ذلك، أوضح التقرير أن الإنكماش، أي الإنخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخُّم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي، يُعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل إنخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي.
وأضاف التقرير: «قد يبدو إنخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يُمكن أن يثبط الإستهلاك، ويؤخر الإستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالإقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة».
ولفت التقرير في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، بإعتبارها مثالاً بارزاً على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الإنكماش، مشيراً إلى أن إقتصادات كبرى أخرى واجهت تحدّيات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة «كوفيد-19» وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدّت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدّلات المعتادة إلاّ أن ما يلفت الإنتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء حيال ما إذا كان التضخُّم أو الإنكماش سيكونان محرّكين إقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل.
وافاد التقرير أن بعض المحلّلين يسلّطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخُّم إلى الواجهة كمصدر للقلق الإقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت «الإعتدال الكبير».
وأشار التقرير إلى أن الإستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وإنسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزّز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدّى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الإقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية.
وأكد أن العوامل المشار إليها تحوّلت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة، حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي إتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد المحسنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الإحتياطية البديلة، مما يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة.
وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (إنخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحوُّل الأخضر، والمنافسة الإستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحوُّلات حجة بعض المحلّلين بأن البيئة الإقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخُّم في المستقبل، حيث لن يكون إستقرار الأسعار أمراً يُستهان به.