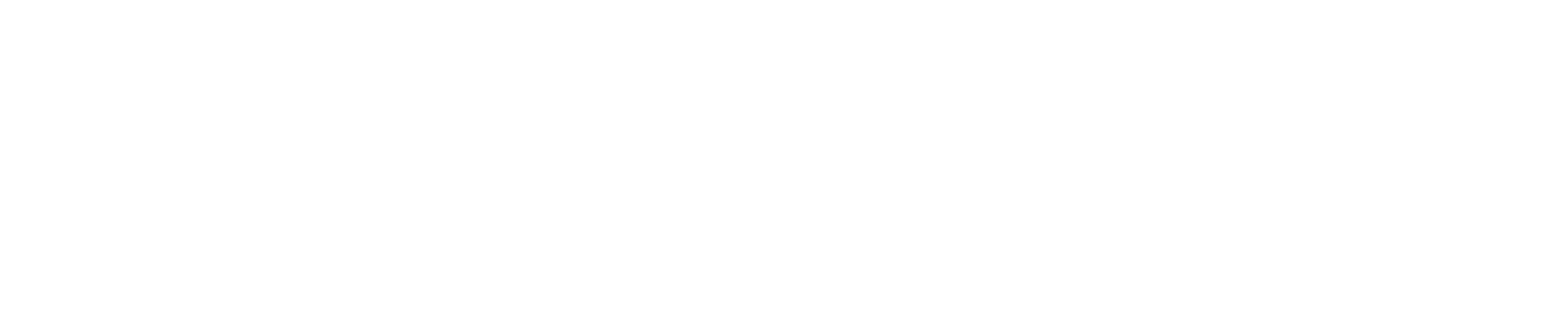التحوُّل المناخي والتمويل الأخضر في الدول العربية:
الأمن الغذائي العربي يُواجه تحدّيات متزايدة نتيجة تقلُّص المساحات الصالحة للزراعة
وتدهور التربة وإنخفاض إنتاجية المحاصيل
 تشهد المنطقة العربية مرحلة دقيقة في ظل التغيُّرات المناخية المتسارعة التي ألقت في ظلالها على مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية. فإرتفاع درجات الحرارة وتناقص معدّلات هطول الأمطار وتكرار موجات الجفاف والسيول لم تعد مجرّد ظواهر طبيعية عابرة، بل تحوّلت إلى عوامل هيكلية مؤثرة في إستقرار الإقتصادات العربية، لا سيما من حيث الأمن الغذائي والمائي. وتُعتبر هذه التحدّيات أشدّ خطورة على الدول العربية بسبب هشاشة مواردها الطبيعية وإعتمادها الكبير على الإستيراد لتلبية إحتياجاتها الغذائية والمائية.
تشهد المنطقة العربية مرحلة دقيقة في ظل التغيُّرات المناخية المتسارعة التي ألقت في ظلالها على مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية. فإرتفاع درجات الحرارة وتناقص معدّلات هطول الأمطار وتكرار موجات الجفاف والسيول لم تعد مجرّد ظواهر طبيعية عابرة، بل تحوّلت إلى عوامل هيكلية مؤثرة في إستقرار الإقتصادات العربية، لا سيما من حيث الأمن الغذائي والمائي. وتُعتبر هذه التحدّيات أشدّ خطورة على الدول العربية بسبب هشاشة مواردها الطبيعية وإعتمادها الكبير على الإستيراد لتلبية إحتياجاتها الغذائية والمائية.
ويُواجه الأمن الغذائي العربي تحدّيات متزايدة نتيجة تقلُّص المساحات الصالحة للزراعة وتدهور التربة وإنخفاض إنتاجية المحاصيل. ومع أن الدول العربية تستورد أكثر من نصف إحتياجاتها الغذائية من الأسواق العالمية، فإن تقلُّبات الأسعار وتعرُّض سلاسل التوريد للإختلال بسبب الكوارث المناخية العالمية يجعل الوضع أكثر هشاشة. كما أن الضغط المتزايد على الموارد المائية يُعمّق من خطورة الموقف، حيث إن معظم الدول العربية تقع ضمن المناطق الأكثر ندرة في المياه عالمياً، وتعتمد في كثير من الأحيان على موارد مشتركة أو عابرة للحدود، وهو ما يُضاعف من حساسية أمنها المائي أمام المتغيّرات المناخية والجيوسياسية،. إذ تشير تقديرات منظمات دولية مثل البنك الدولي والإسكوا إلى أن المنطقة العربية قد تخسر ما بين 6 % إلى 14 % من ناتجها المحلي الإجمالي في حلول منتصف القرن إذا لم تُتخذ إجراءات جادة للتكيّف مع التغيُّر المناخي.
كما تُقدَّر الفجوة التمويلية لمشروعات التكيُّف والتخفيف في المنطقة بما يزيد على 200 مليار دولار حتى العام 2030، وهي فجوة ضخمة تستدعي تعبئة الموارد المحلية وجذب الإستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل أدوات التمويل المبتكرة كالسندات الخضراء والتمويل المختلط.
التحوُّل الى الطاقة المتجدّدة في المنطقة العربية
تشير بيانات الجدول رقم 1 إلى أن مساهمة الطاقة المتجدّدة في إجمالي إستهلاك الطاقة داخل المنطقة العربية لا تزال محدودة، حيث بلغ متوسطها 5.2 % في العام 2020 مقارنة بمتوسط عالمي قدره 19.7 %. ويعود ذلك جزئياً إلى الهيمنة التاريخية للوقود الأحفوري منخفض الكلفة والمتوافر محلياً في دول مثل السعودية والكويت والجزائر وقطر، مما حدّ من الإستثمار في مصادر الطاقة النظيفة. في المقابل، تظهر بعض الدول مثل الصومال والسودان وجزر القمر نسباً مرتفعة للطاقة المتجدّدة، غير أن هذه النسب غالباً ما تعكس الإعتماد على الكتلة الحيوية والمصادر التقليدية أكثر من إستثمارات إستراتيجية في مشاريع مستدامة.
وتتأثر مساهمة الطاقة المتجدّدة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، فإقتصادات الدول الريعية تُواجه صعوبات في توجيه موارد كبيرة نحو الطاقة النظيفة في غياب آليات تمويلية محفّزة، بينما يحد ضعف البنية التحتية والتنظيمية من القدرة على تنفيذ مشاريع مستدامة واسعة النطاق. كما يلعب الوعي المؤسسي والفني لدى صانعي القرار والمستثمرين دوراً في سرعة التحوُّل نحو الطاقة المتجدّدة.
مع الاشارة الى الأثر المباشر وغير المباشر للطاقة المتجدّدة على الأمن الغذائي والمائي، فالإعتماد على الطاقة النظيفة يُمكن أن يدعم الزراعة الذكية مناخياً من خلال تشغيل أنظمة الري الموفّرة للمياه وتشغيل محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبالتالي الحدّ من الضغط على الموارد المائية النادرة.
كما تُتيح مشاريع الطاقة المتجدّدة تقليل الإنبعاثات الكربونية، ما يُخفّف من حدّة التغيُّر المناخي الذي يُهدّد الإنتاج الزراعي. وتجارب دول مثل الأردن والإمارات، التي تبنّت مشاريع للطاقة الشمسية والرياح ضمن خطط وطنية لتنوّع مصادر الطاقة، تشير إلى أن دمج الطاقة المتجدّدة ضمن السياسات الوطنية يُعزّز القدرة على مواجهة الضغوط المناخية وحماية الأمن الغذائي والمائي على حد سواء. وبالتالي، يُمثل تعزيز الإستثمار في الطاقة المتجدّدة أداة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليص الفجوة الكبيرة بين الواقع العربي والتحوُّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، مع التأكيد على ضرورة إصلاح الأطر المؤسسية وتفعيل الحوافز الإستثمارية والتقنية لدعم هذا المسار.
للمزيد متابعة الرابط المرفق:
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/11/الأمن-الغذائي-العربي-يُواجه-تحدّيات-متزايدة.pdf