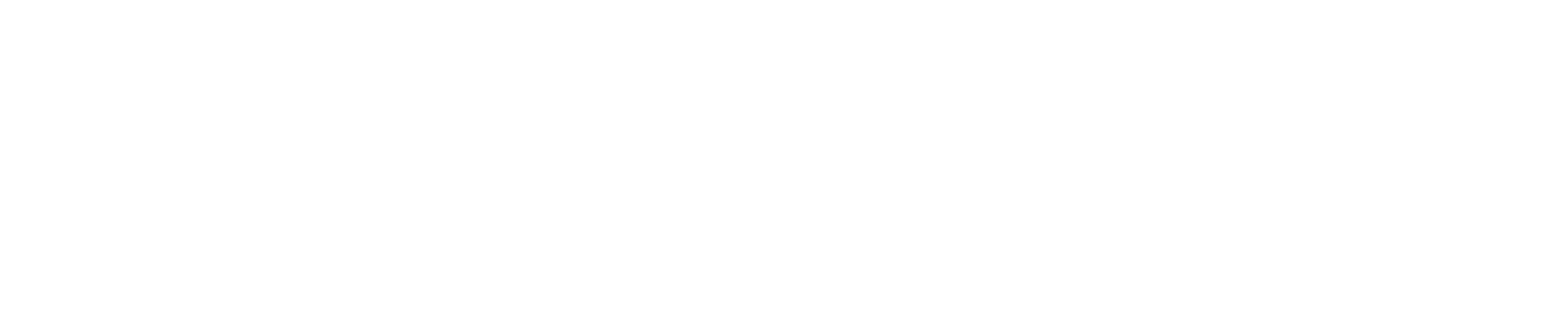تحولات الاقتصاد العالمي وأبعادها المستقبلية
(العربية)-25/11/2025
*م. عبدالله عودة الغبين
يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتشابكة التي تعكس طبيعة مرحلة انتقالية حرجة يعيد فيها العالم هيكلة مساره بعد سنوات من الصدمات الاقتصادية، ففي هذا الأسبوع برزت ثلاثة متغيرات محورية: انكماش قطاع التصنيع الأميركي، والتباين في وجهات النظر داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة، وتراجع الناتج الصناعي الألماني. وعلى الرغم من أن هذه التطورات تبدو منفصلة، إلا أن جذورها التاريخية ومحركاتها الراهنة تكشف عن صورة أكثر عمقًا واتساعًا تتجاوز حدود الاقتصادات الثلاثة، وتمتد لتلامس البنية الهيكلية للاقتصاد العالمي.
لقد مرّ قطاع التصنيع الأميركي بتحولات جوهرية عبر العقود الماضية، منذ أن بدأت الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي بنقل جزء كبير من طاقتها الإنتاجية الصناعية إلى الخارج بحثًا عن ميزة تنافسية في التكاليف، ما أدى إلى ما يشبه التآكل الصناعي داخليًا. وعلى الرغم من احتفاظها بمراكز قوة في الصناعات التحويلية عالية التقنية، فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 كشفت هشاشة النمو القائم على قطاع الخدمات، ما دفع صناع السياسات النقدية والمالية لاحقًا إلى محاولة إعادة توطين الصناعات. ومع صعود التوترات التجارية مع الصين خلال العقد الأخير، أصبح الاتجاه نحو تعزيز القاعدة الصناعية المحلية جزءًا من استراتيجية اقتصادية قومية. اليوم، يظهر انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي كامتداد لهذا التاريخ، لكنه يأتي مدفوعًا بعوامل آنية أبرزها ارتفاع التعريفات الجمركية على الواردات، ما أدى إلى زيادة تكاليف المدخلات الإنتاجية، إلى جانب تراجع الطلب الكلي المحلي والخارجي وتراكم المخزون السلعي لدى الشركات. هذه المؤشرات الاقتصادية لا تعكس فقط انكماشًا في الناتج الصناعي، بل تحمل إشارات مقلقة حول مستقبل معدل النمو الأميركي، واحتمالات تراجع الإنفاق الرأسمالي وتباطؤ خلق فرص العمل، خصوصًا في القطاعات الحساسة لتكلفة رأس المال.
في موازاة ذلك، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام مرحلة من التباين الداخلي الذي يعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية مهمة، أبرزها فترة السبعينيات التي شهدت موجات تضخمية عالية فقد خلالها البنك المركزي الأميركي جزءًا من مصداقيته، ما جعله لاحقًا ميالًا إلى التشديد النقدي كلما ظهرت بوادر ضغوط تضخمية. وبعد سنوات التيسير الكمي القوي الذي أعقب جائحة كورونا، واجه الفيدرالي موجة تضخم عنيفة دفعته إلى رفع أسعار الفائدة القياسية بوتيرة هي الأسرع منذ أربعة عقود. واليوم، يأتي الانقسام داخل المجلس نتيجة عوامل آنية متعددة، فمعدل التضخم تراجع لكنه ما يزال فوق المستويات المستهدفة، والسياسة النقدية أصبحت تتعرض لضغوط سياسية مباشرة وغير مباشرة في مرحلة ما بعد الانتخابات، إلى جانب مؤشرات الانكماش في القطاعات الإنتاجية، ما يدفع البعض داخل المجلس للمطالبة بخفض سعر الفائدة، بينما يتمسك آخرون بالحذر مخافة فقدان السيطرة على استقرار الأسعار. هذا التباين لا يعتبر مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يحمل رسالة واضحة للأسواق المالية بأن السياسة النقدية الأميركية لم تعد في مسار يمكن التنبؤ به بسهولة، وأن السنوات القادمة قد تشهد تقلبات كبيرة في أسعار الأصول، خاصة في سوقي السندات الحكومية والعقارات.
أما ألمانيا، المحرك الصناعي لأوروبا، فهي تواجه انكماشًا يختلف عن تراجع التصنيع الأميركي من حيث الخلفية والمحركات. تاريخيًا، بنت ألمانيا نموذجها الاقتصادي على قوة الصادرات وصناعة عالية الجودة وطاقة منخفضة التكلفة، خاصة الغاز الروسي الذي شكل عنصرًا محوريًا في ميزانها التجاري لسنوات طويلة. لكن سلسلة من الصدمات الخارجية، وعلى رأسها الحرب الروسية–الأوكرانية، قلبت المعادلة من جذورها مع ارتفاع أسعار الطاقة وفقدان مزايا تنافسية مهمة. وإلى جانب ذلك، يشهد العالم تراجعًا في الطلب العالمي على الصناعات التقليدية مثل السيارات ذات المحركات الاحتراقية، وهي إحدى ركائز القطاع الصناعي الألماني، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني — أكبر شريك تجاري لألمانيا — وهو ما انعكس على حجم طلبيات التصدير. اليوم، تؤكد البيانات الحديثة استمرار هذا التراجع في مؤشر النشاط الصناعي، ما يضع ضغوطًا إضافية على مستقبل اقتصاد منطقة اليورو بأكملها، ويزيد احتمالات اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير النقدي لدعم معدل النمو.
عند جمع هذه المؤشرات الثلاثة، يتضح أن الاقتصاد العالمي لا يعيش ظواهر دورية مؤقتة بل يواجه تحولات هيكلية عميقة. انكماش قطاع التصنيع الأميركي يشير إلى تحديات في سلاسل الإمداد وتكلفة الإنتاج. التباين داخل الفيدرالي يعكس مرحلة جديدة من عدم اليقين في السياسات النقدية العالمية. وتراجع القاعدة الصناعية الألمانية يكشف عن أزمة في النموذج الاقتصادي الأوروبي التقليدي. هذه التطورات، حين تُقرأ مجتمعة، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تحتاج إلى إدارة مخاطر عالية الدقة، وأن على المستثمرين والشركات وصناع القرار أن يعيدوا النظر في استراتيجياتهم في ظل بيئة تتسم بتقلبات في أسعار الفائدة، وتغيرات في هيكل الطلب الكلي العالمي، وتحولات في مراكز القوة الصناعية.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد تراجع في مؤشرات اقتصادية، بل هو انعكاس لتحولات عميقة في نموذج العولمة، والدور الجديد لأسواق الطاقة، وموازين التجارة الدولية، وتكاليف رأس المال. وفي عالم يتشكل فيه نظام اقتصادي جديد، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون فترة من إعادة التموضع الاستراتيجي، وليست فترة توسع اقتصادي سريع. ومن يفهم الإشارات الحالية بعمق، سيكون الأكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة في السنوات المقبلة.
أما بالنسبة للاقتصاد السعودي، فإن هذه التحولات العالمية تحمل تداعيات مباشرة وغير مباشرة على المستويين الكلي والقطاعي. فمن جهة، يؤدي تباطؤ النمو في الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، ما يضغط على أسعار الطاقة وبالتالي على الإيرادات النفطية التي لا تزال تشكل عصب الموازنة العامة للمملكة. ومن جهة أخرى، فإن التقلبات في السياسة النقدية الأميركية تنعكس مباشرة على السياسة النقدية السعودية نظرًا لربط الريال بالدولار، ما يحد من مرونة البنك المركزي السعودي في التعامل مع الظروف الاقتصادية المحلية. لكن في المقابل، توفر هذه البيئة العالمية المتغيرة فرصًا استراتيجية للمملكة لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بدائل للأسواق التقليدية، وتطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. وبذلك، فإن النجاح في استغلال هذه المرحلة الانتقالية يتطلب سياسات مالية ونقدية متوازنة، وإصلاحات هيكلية مستمرة، واستثمارات استراتيجية في رأس المال البشري والبنية التحتية، بما يضمن تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية مستدامة تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية المتسارعة.