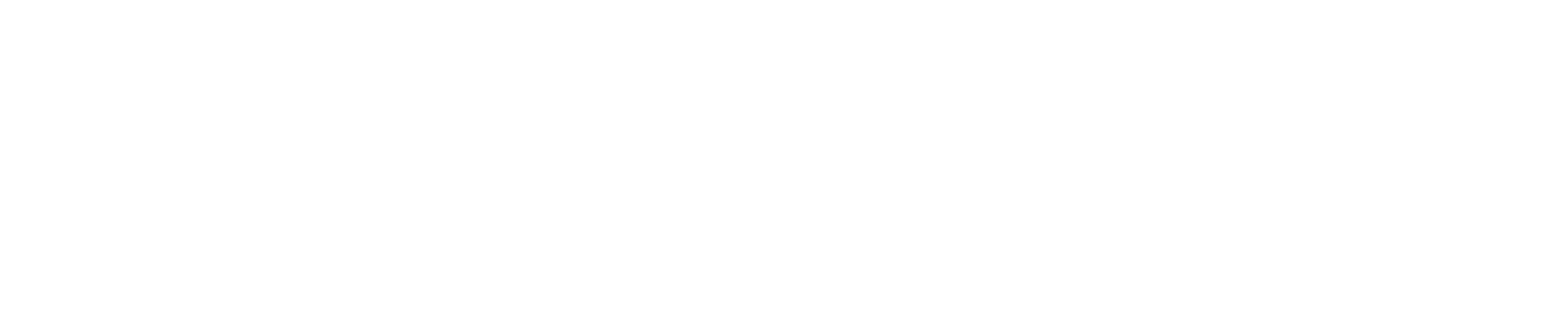تغير المناخ وإعادة إعمار سوريا حاجة ضرورية للإدماج في التخطيط
(سي ان بي سي)-23/04/2025
*بقلم مؤيد الشيخ حسن
يفتح التغيير السياسي الجذري الذي يعيشه السوريون الأبواب مشرعةً نحو خيارات أفضل للمستقبل، بعد أن عاشوا سنواتٍ عجافًا، وعثراتٍ سياسيةً متفاوتة منذ الاستقلال في أربعينيات القرن الماضي، أثرت سلبًا على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مرنة، مستقرة، وتدريجية، مقارنةً بدول العالم المشابهة.
وتشكّل إعادة الإعمار التي يُجرى الحديث عنها بشكل واسع، فرصةً تاريخية لا تُعوَّض لإعادة قراءة الماضي، والاستفادة من التجارب الدولية، والتخطيط لمواجهة التحديات المستقبلية التي تهدد العالم، باعتبار أن سوريا جزء لا يتجزأ منه. ورغم الصعوبات والأولويات المستعجلة، فإن إدماج تحديات المناخ يُعَدّ حاجةً أساسية في التخطيط، لتجنّب الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة.
تقع سوريا والمنطقة العربية عمومًا ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، ما يجعلها عرضة لمخاطر أكبر. إذ تشير بعض الأرقام إلى أن المنطقة ستتعرض لارتفاعات في درجات الحرارة تتراوح بين 3-4 درجات مئوية، وتذهب السيناريوهات المتشائمة لأبعد من 5 درجات، مع حلول عام 2050، ما يجعلها أكثر عرضة للأضرار.
وتواجه سوريا مخاطر مناخية متعددة، أبرزها موجات الجفاف الشديدة وغير المنتظمة، إضافةً إلى مخاطر اندلاع حرائق أكثر حدة، تهدد غطائها النباتي المتراجع أصلًا نتيجة السياسات الخاطئة المتعاقبة. كما يمكن أن تتعرض مستقبلًا لموجات أمطار غزيرة وغير منتظمة قد تُخلِّف فيضانات تهدد زراعتها، التي طالما شكّلت حجر الأساس في بناء اقتصادها. وإضافةً إلى ذلك، سيشهد البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا في درجات حرارة مياهه ومنسوبه، ما يهدد الكائنات الحية فيه.
مع حلول عام 2052، سيزداد متوسط درجات حرارة الأرض بما يزيد عن درجة ونصف مئوية. هذا السيناريو سيكون قابلًا للتحقق ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولعل أبرزها الالتزام باتفاقية باريس لعام 2015، التي توّجت ثمرة عمل علمي وتقني وسياسي وتعاون دولي امتد لأكثر من عشرين عامًا. وتطالب هذه الاتفاقية بوضع خطط لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية بما يضمن عدم الوصول إلى عتبة الدرجة والنصف المئوية.
وفي هذا الإطار، تُقسَّم الإجراءات اللازم اتباعها إلى ثلاث مجموعات:
ويعد التقييم العلمي والتقني، كالرصد، والنمذجة، والتوقعات المستقبلية، أول هذه الإجراءات.
أما الإجراء الثاني، فهو خيارات التكيف، وتُعنى بالآثار المستقبلية واحتمالات التداخل في الأنظمة الطبيعية والبشرية لتحقيق التكيف والتعايش مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة.
وفي المرتبة الثالثة تأتي إجراءات التخفيف، التي تشمل تطوير السياسات العامة، وخفض الانبعاثات، وتحديد الخيارات التكنولوجية المثلى.
ما هي خطط التكيف الوطنية؟
تمثّل خطط التكيف الوطنية إطارًا يحدّد الطرق المثلى لتكيّف الدولة مع تغيّر المناخ على المدى المتوسط والبعيد، وتتيح للحكومة على المستوى الوطني تنفيذ إجراءات لحماية السكان ووسائل العيش، والبنية التحتية، والنشاط الاقتصادي، والنُظم البيئية.
وتُصمَّم هذه الخطط لتتناسب مع التحديات التي تواجه كل بلد حسب موقعه الجغرافي، ونشاطاته الاقتصادية، وخصوصيته، مما يساعد على تقليل مواطن الضعف، والاستعداد بشكل أفضل للآثار المستقبلية. ويُفترض أن تدمج هذه الخطط تدابير التكيف ضمن الخطط العامة والبرامج الحالية والمستقبلية للدولة، مما يضمن استعداد القطاعات الرئيسية كـ الزراعة، الأراضي، المياه، الصحة، التنوع البيولوجي، الغذاء، الثروات الباطنية، البنية التحتية، قضايا الفقر، والتراث للتغيرات المناخية.
وتمكّن هذه الخطط الحكومات من الوصول إلى التمويل المناخي، وحشد الدعم الدولي، والمشاركة في الدبلوماسية البيئية والمناخية على مستوى العالم، وبناء علاقات جيدة مع المانحين، الذين بات الكثير منهم يطلب الالتزام بمعايير جديدة، كتضمين إجراءات مكافحة تغيّر المناخ ضمن السياسات العامة، إضافةً إلى تنسيق الجهود عبر مختلف مستويات المجتمع لضمان تنفيذ تدابير التكيّف في القطاعات ذات الأولوية.
لماذا تُعدّ خطط التكيّف الوطنية مهمة للعمل المناخي؟
لا يسير العالم على السكة الصحيحة للحد من الاحترار العالمي، رغم الجهود الكبيرة، وبالتالي فإن التأثيرات الحتمية لتغير المناخ تتزايد وتتسارع يومًا بعد يوم، إلى درجة أننا بدأنا نلمس آثارها يوميًا، مما يجعل التكيّف ضرورةً ملحة لجميع البلدان.
وتشكّل خطط التكيّف الوطنية الأداة الأساسية للبلدان للتخطيط للتكيّف مع تغيّر المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر في غاية الأهمية لما يقدَّر بنحو 1.2 مليار شخص يتعرضون بالفعل لمخاطر مناخية حرجة.
وقد تم إنشاء عملية إعداد خطط التكيّف الوطنية رسميًا من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بموجب “إطار كانكون للتكيّف” عام 2010، مع اعتماد التوجيهات في العام التالي، والتي تهدف إلى دمج التكيّف المناخي في التخطيط التنموي الأساسي، وتقليل مواطن الضعف في المجتمعات، وضمان مستقبل أكثر استدامة.
كيف يمكن للدولة البدء في تنفيذ عمليات إعداد خطط التكيّف الوطنية؟
تقود الدول عملية إعداد خطط التكيّف تحت إشراف كيان حكومي مُعيّن، وغالبًا ما يكون وزارة البيئة أو الجهة المسؤولة، والتي تتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة والوزارات الرئيسية كالتخطيط، المالية، الاقتصاد، الزراعة، التعليم، الصناعة، الصحة، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الشركاء الدوليون، لضمان أن الخطة تعكس الأولويات الوطنية.
ويتعين على الحكومة تقييم تأثيرات تغير المناخ والمخاطر، وتحديد القطاعات ذات الأولوية من خلال مشاورات مكثفة على المستويين الوطني والمحلي، لتشمل القطاعات الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على السكان، سبل العيش، الأمن الغذائي، والنظم البيئية.
كما يجب إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء الدوليون، خصوصًا وكالات الأمم المتحدة التي تلعب دور الناصح والمستشار لضمان أن خطة التكيّف تسير في الاتجاه الصحيح.
ويُطلب من القطاع المالي والمصرفي لعب دورٍ في تأمين الدعم المطلوب، والاستثمار في المجال البيئي، مثل سندات الكربون، ومشاريع الطاقات المتجددة النظيفة، وتحويلها إلى سلعة تجارية قابلة للتصدير.
كما يجب على الحكومة تضمين هذه المفاهيم في المناهج التعليمية المبكرة، لخلق جيل واعٍ بالمخاطر التي تهدد مستقبله، يدفعه للتفكير في حلول ابتكارية استباقية. ويُفترض تطوير البنية القانونية والتشريعية والحوكمة، ما يلزم الشركات، السلطات المحلية، والأفراد غير الملتزمين.
إلى جانب ذلك، يقع على عاتق الحكومة إنشاء قواعد بيانات شفافة وتشاركية، والعمل على إشراك المرأة بشكل واسع، وتفعيل المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والنقابات، وفسح المجال لهم لخلق دوائر اقتصادية تناسب بيئاتهم المحلية، لتصبّ جميعها في النهاية ضمن الإجراءات الرامية لمكافحة تغيّر المناخ.
*مدير مشاريع ومهندس مختص في الطاقة وحلول تغير المناخ ويعمل لدى وزارة الطاقة والتحول الإيكولوجي الفرنسية