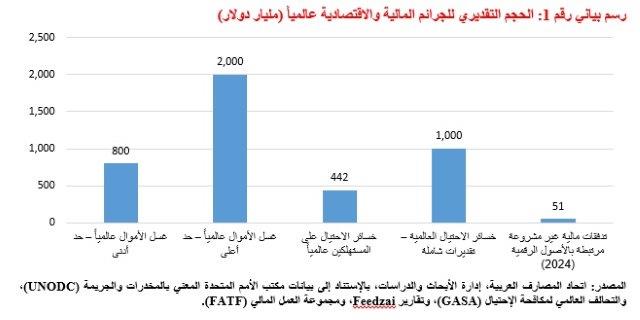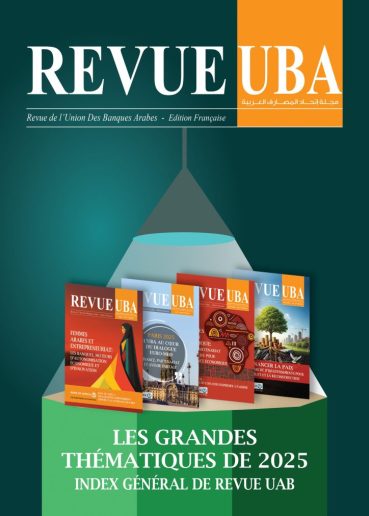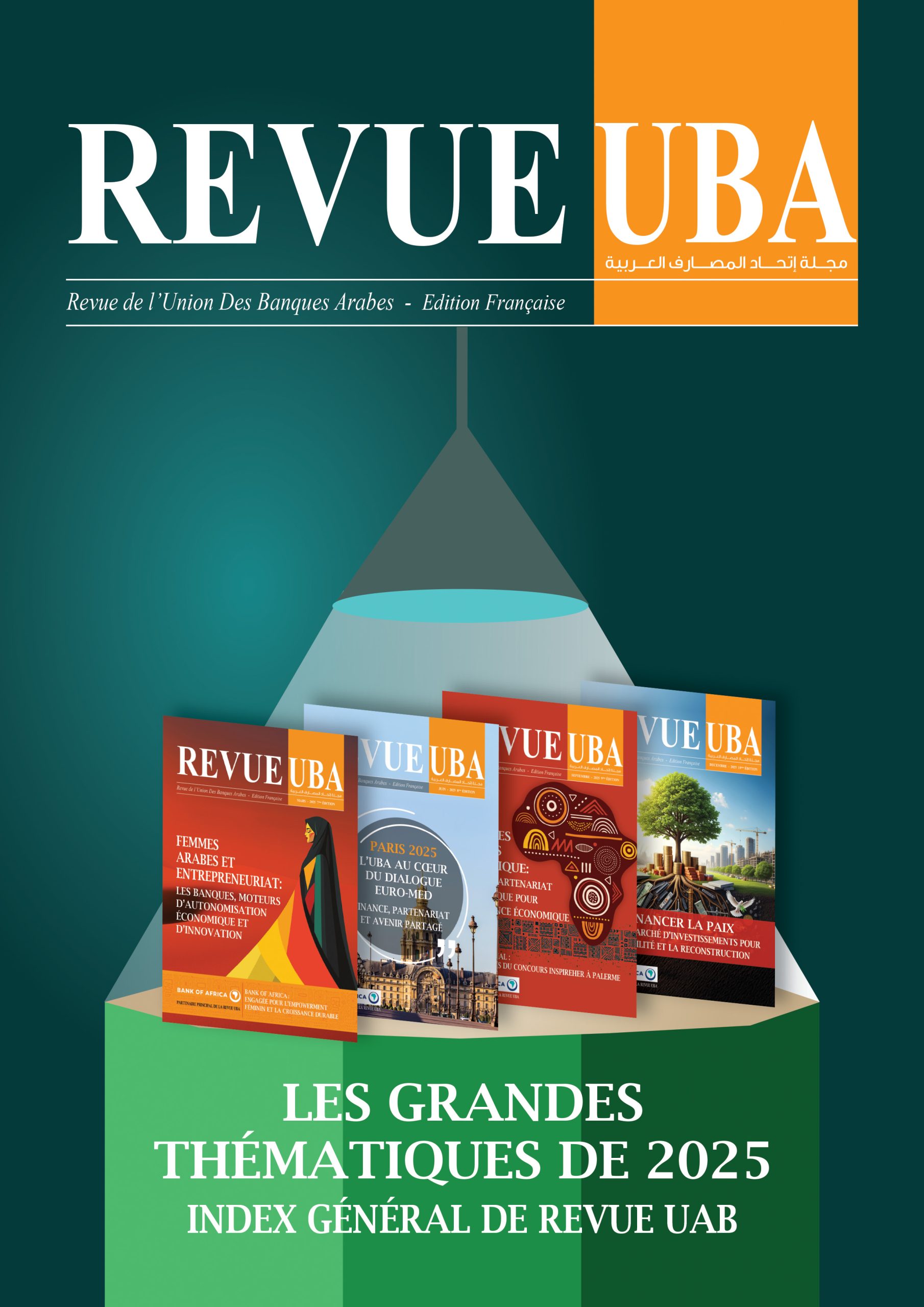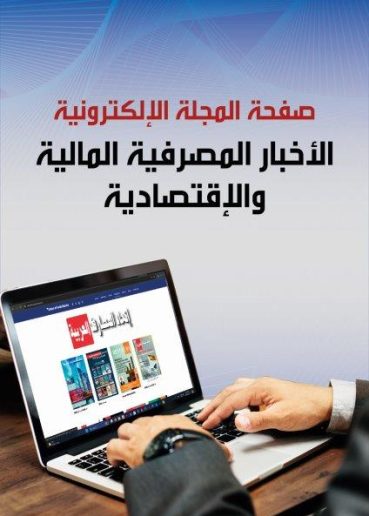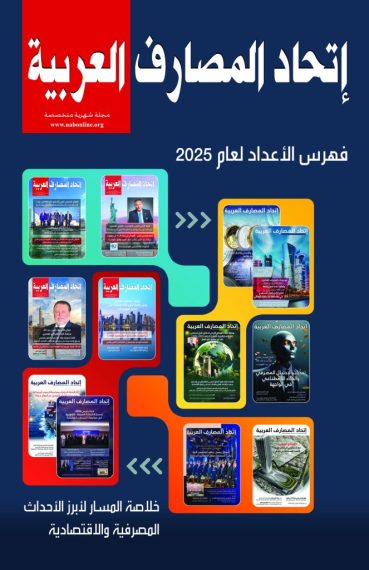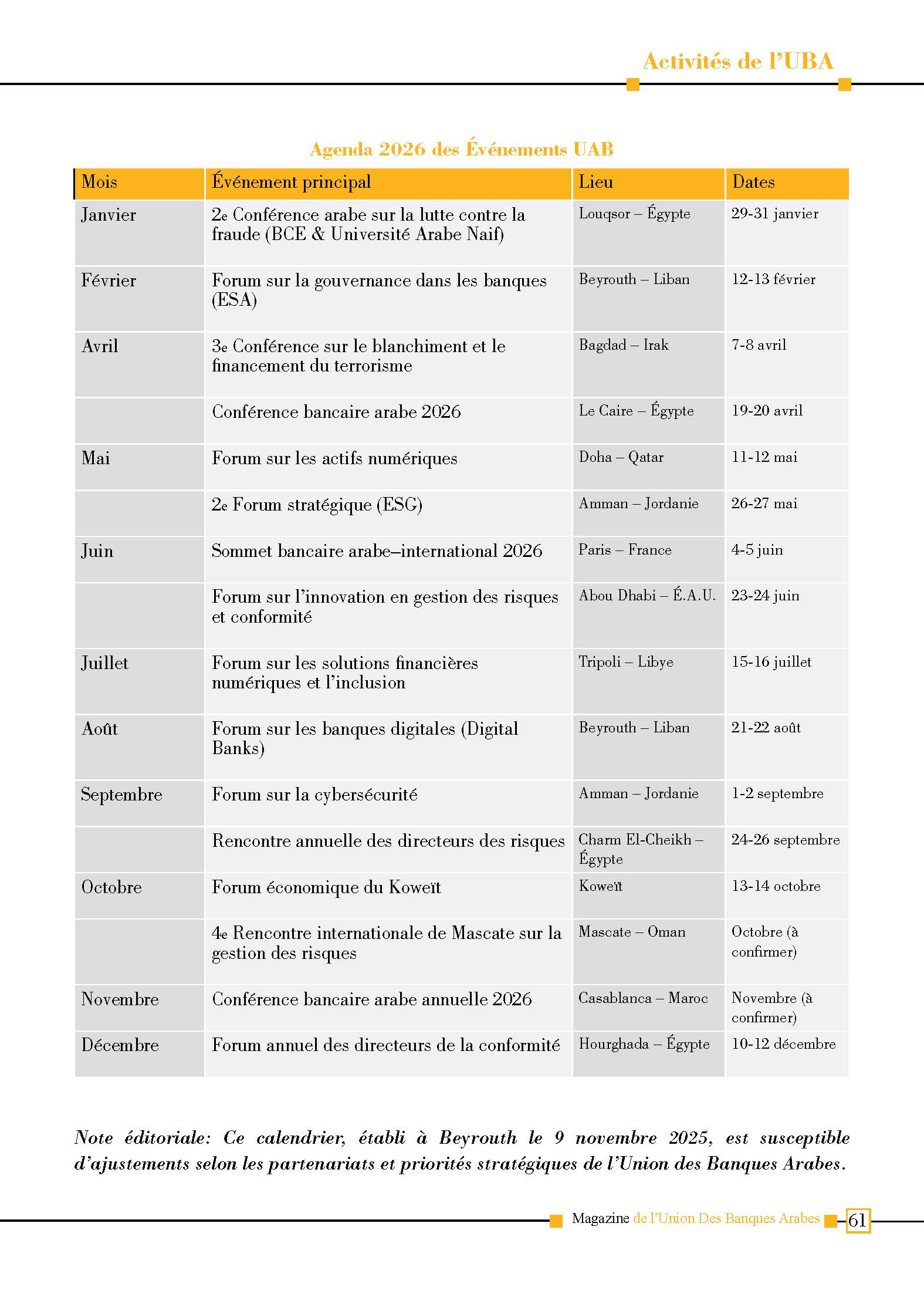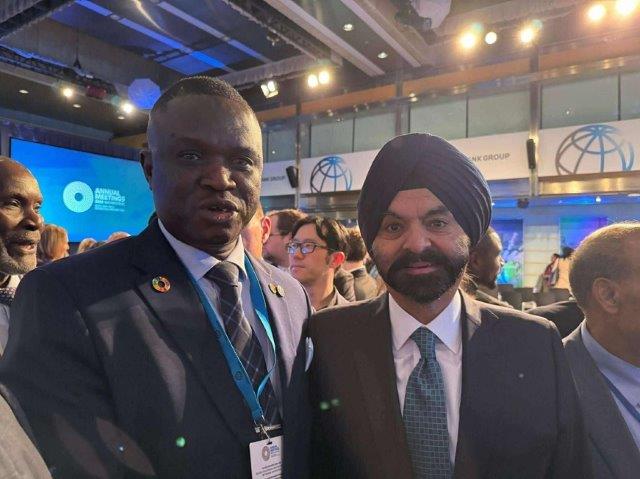Zeinab Taleb
Posts by Zeinab Taleb:


الحوكمة المصرفية الرشيدة ركيزة أساسية لإستعادة الإنتظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي
الحوكمة المصرفية الرشيدة ركيزة أساسية لإستعادة الإنتظام المالي
وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي
 لا شك في أن الحوكمة المصرفية الرشيدة تُشكّل ركيزة أساسية لإستعادة الإنتظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وخصوصاً في المنطقة العربية، إذ من الضروري التركيز على تفعيل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح لمواجهة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة.
لا شك في أن الحوكمة المصرفية الرشيدة تُشكّل ركيزة أساسية لإستعادة الإنتظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وخصوصاً في المنطقة العربية، إذ من الضروري التركيز على تفعيل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح لمواجهة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سبيل تطبيق الحوكمة المصرفية على نحو فعّال، وإثباتها على الصعيد المصرفي، ينبغي أن تشكل الحوكمة علاجاً للأزمات، إذ إن تطبيق سياسات حوكمة صارمة وشفّافة يُعد السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة في الأنظمة المصرفية العربية والعالمية وخصوصاً ما بعد الأزمات المالية التي تشهدها البلدان عادة، والتي تعاني أصلاً أزمات وتفتقر للثقة المصرفية الدولية وخصوصاً ثقة البنوك المراسلة.
كما من الضروري دعم الشمول المالي، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الحوكمة. وفي هذا السياق يعمل إتحاد المصارف العربية على دعم الشمول المالي وتطوير منتجات رقمية مبتكرة ولا سيما في عدد من البلدان العربية الأكثر حاجة للشفافية في المعاملات المصرفية والمالية.
وفي هذا السياق، نلاحظ أن تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية يؤدي إلى رفع مستوى الحوكمة فيها لتحقيق الإستقرار الإقتصادي. وعليه، يدفع الإتحاد نحو تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلتزاماً بأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما يسعى الإتحاد نحو رفع مستوى الحوكمة والتحكيم في القطاع المصرفي العربي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية. علماً أن نجاح الإصلاح المصرفي في أي بلد عربي على نحو خاص، لا ينفصل عن الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وأن حماية ودائع المودعين عبر أطر حوكمة واضحة، يُعتبر أولوية لعودة الثقة في أي قطاع مصرفي يتعرّض للإهتزاز، وقد بات يحتاج إلى إعادة هيكلة كما هي حال القطاع المصرفي اللبناني.
من هنا تأتي مطالبة إتحاد المصارف العربية وإصراره على تفعيل دور الحوكمة المصرفية في الدول العربية، والذي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يجب التشديد على أهمية الأطُر التنظيمية القوية، والتي تشمل إجراءات «إعرف عميلك» الصارمة، والضوابط التشغيلية، وتدابير نزاهة السوق، ومعايير حماية المستهلك.
كذلك، يُعد التعاون الدولي أمراً حيوياً لضمان التنسيق والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، إذ إن تعزيز التنظيم لن يحقق فوائد عديدة للإقتصادات العربية فحسب، بل سيُساهم أيضاً في خلق بيئة مالية عالمية أكثر أماناً، مستقرّة ومستدامة.
في المحصّلة، تأتي مطالبة إتحاد المصارف العربية بضرورة تطبيق الحوكمة المصرفية على نحو فعّال وإثباتها على الصعيد المصرفي ولا سيما في عصرنا الذي يتّسم بالعولمة والترابط، من الأهمية بمكان، في ظل التحدّيات التي يُواجهها القطاع المصرفي العربي ولا سيما في المنطقة العربية التي تشهد أزمات متعدّدة الأوجه، والتي تساهم في زعزعة الإقتصادات وتهريب الإستثمارات ورؤوس الأموال، كذلك الأدمغة والأيادي الماهرة والتي تشكل رأس المال البشري في دولنا العربية. لذلك فإن تطبيق الحوكمة المصرفية الرشيدة يُحافظ على أفضل العلاقات المتينة مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويُمكّن المصارف العربية على وجه الخصوص من قبولها عبر الحدود ضمن المعايير الدولية المرعيّة الإجراء، وفي سبيل تأكيد الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصرف اليمن البحرين الشامل يشارك في فعّاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني في عدن
 مصرف اليمن البحرين الشامل
مصرف اليمن البحرين الشامل
يشارك في فعّاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني في عدن
تحت شعار «القطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الإقتصادي وإعادة الإعمار»، جاء إفتتاح فعّاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني في عدن، اليمن على مدار ثلاثة أيام (ما بين 9 شباط/فبراير و11 منه 2026)، بمشاركة فاعلة ومتميّزة من مصرف اليمن البحرين الشامل، كشريك أساسي في هذه التظاهرة العلمية الهامة الى جانب عدد من البنوك والمؤسسات المختلفة.

وقد جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصّصين والممارسين في المجالين المصرفي والإقتصادي، لتبادل الرؤى والخبرات، وعرض أوراق عمل وبحوث علمية تُساهم في تطوير السياسات والإستراتيجيات الكفيلة بدعم إستقرار وإزدهار الإقتصاد اليمني .
وتأتي مشاركة مصرف اليمن البحرين الشامل في هذا المؤتمر الذي نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا عدن وبشراكة إستراتيجية من البنك المركزي اليمني، إنطلاقاً من مسؤولية المصرف الإجتماعية وحرصه على الإسهام الجاد في الفعّاليات التي تخدم الإقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الحلول العملية للتحدّيات الراهنة، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي كركيزة أساسية للتنمية.

17عاماً بعد الأزمة… كيف تقود واشنطن موجة التخفيف التنظيمي للبنوك عالمياً؟
17عاماً بعد الأزمة… كيف تقود واشنطن موجة التخفيف التنظيمي للبنوك عالمياً؟
المصارف الكبرى: بين التيسير التنظيمي الأميركي وتحدّيات المخاطر الدولية
بعد مرور سبعة عشر عاماً على الأزمة المالية العالمية التي إندلعت أواخر العام 2007، بدأت الهيئات التنظيمية حول العالم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على البنوك، سعياً منها للحفاظ على قدرة المقرضين على المنافسة وتحفيز إقتصاداتها، وفق صحيفة «الشرق الأوسط».
وتقود إدارة دونالد ترمب هذه الجهود، بما في ذلك إتخاذ تدابير لتقليل حجم رأس المال الذي يُلزَم المقرضون بتخصيصه. ويُثير خفض متطلبات رأس المال قلق بعض المراقبين من أن الولايات المتحدة قد أشعلت شرارة تراجع عالمي عن اللوائح المصممة لحماية الأنظمة المالية، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن فقاعات السوق ومخاطر الإستقرار المالي.
المشهد العالمي
على المستوى الدولي، يُفترض أن تتوافق الهيئات التنظيمية في كل دولة مع نظام «بازل» التنظيمي، الذي وُضع بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ويهدف إلى ضمان تطبيق معايير دنيا لرأس المال في جميع أنحاء العالم، بما يتيح للمقرضين تجاوز خسائر القروض خلال فترات الأزمات، ويُحقق تكافؤ الفرص بين البنوك.
لكن في الواقع، هناك مساحة واسعة للمناورة، كما يتضح من اختلاف طرق تطبيق أحدث القواعد المعروفة بإسم «نهاية بازل 3».
وأرجأ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تطبيق أجزاء رئيسية من هذه القواعد، مثل تلك المتعلقة بأنشطة التداول المصرفي، في إنتظار الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة مقابل أوروبا
تبدو متطلّبات نسبة رأس المال للبنوك في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة متشابهة نظرياً.
يُحدّد الاحتياطي الفيدرالي نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول، CFT1، وهو المقياس الأكثر شيوعاً لرأس المال، بين 10.9 % و11.8 %، بعد إضافة بنود خاصة ببنوك «وول ستريت» الكبرى، مثل «جي بي مورغان» و«سيتي» و«غولدمان ساكس».
أما في منطقة اليورو، فيبلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول لدى البنك المركزي الأوروبي 11.2 % للمقرضين، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«سانتاندير» و«بي إن بي باريبا»، بالإضافة إلى متطلّبات «الركيزة الثانية» الخاصة بكل بنك، والتي تبلغ نحو 1.2 %.
وخفّضت لجنة السياسة المالية في بنك إنكلترا الحدّ الأدنى لنسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول إلى 11 %، من دون إحتساب الإضافات الخاصة بكل بنك، والتي قد تصل حالياً إلى حوالي 2.5 % للبنوك الكبرى.
وتحتفظ جميع البنوك الكبرى برأس مال يفوق المطلوب، حيث تهدف هذه الاحتياطيات الذاتية لتهدئة المخاوف التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين.

 هل يُمكن المقارنة بين البنوك؟
هل يُمكن المقارنة بين البنوك؟
وفق الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، تواجه بنوكهم تحدّيات أكبر من مجرد أرقام رأس المال، فمقارنة النسب البسيطة قد تكون مضلّلة، إذ تتبنّى الهيئات الرقابية الاحترازية مناهج مختلفة تعكس اختلاف القطاعات المصرفية المحلية.
وتتألف قواعد رأس المال من جزأين: ترجيح المخاطر، الذي يقيس مخاطر أصول البنك، ونسبة رأس المال، التي تحدد حجم رأس المال الذي يجب على البنك الاحتفاظ به كنسبة من تلك الأصول.
على عكس المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، لا تستطيع البنوك الأميركية الإعتماد على نماذجها الداخلية لتحديد ترجيح المخاطر، ما يعني غالباً قيوداً أكثر صرامة للبنوك الكبيرة.
التخفيف التنظيمي في الولايات المتحدة
تعمل الهيئات التنظيمية الأميركية، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب، على تأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة صياغة لوائح رأس المال الحالية، بحجة جعلها أكثر ملاءمة للمخاطر الفعلية.
وتشمل المقترحات، بقيادة ميشيل بومان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديل قواعد الرافعة المالية، والرسوم الإضافية على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية العالمية، وإعادة النظر في متطلبات المرحلة النهائية من اتفاقية «بازل 3».
كما يُجري الإحتياطي الفيدرالي إصلاحاً شاملاً لاختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبيرة، وهو تحوُّل متوقع أن يقلّص رأس المال الذي يجب على البنوك الإحتفاظ به لمواجهة الخسائر المحتملة، ما يمنح المقرضين الأميركيين فائضاً أكبر بكثير في رأس المال. وقدّر محلّلو «مورغان ستانلي» أن هذه التغييرات المحتملة قد تُتيح للبنوك الأميركية تريليون دولار إضافية في قدرتها على الإقراض.
مع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن البنوك ستزيد من القروض، إذ قد تفضّل بعضها زيادة توزيعات الأرباح على المستثمرين أو تمويل عمليات الاستحواذ.

إتحاد المصارف العربية يفتتح أعمال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الإحتيال في الأقصر/مصر
إتحاد المصارف العربية يفتتح أعمال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الإحتيال في الأقصر/مصر
الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي يُسهمان في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها
وتفرضان تحدّيات جديدة باتت تسمّى «الإحتيال المنظّم»
جاء إفتتاح المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الإحتيال في الأقصر/مصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري معالي الأستاذ حسن عبد الله وفي حضوره، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «المركزي المصري»، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، على مدار ثلاثة أيام، تأكيداً على أهمية دور الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات في كشف عمليات الإحتيال، والتحدّيات القانونية والإجرائية لتبادل المعلومات في ظل مكافحة الإحتيال، وجهود المؤسسات الدولية في توظيف تقنيات مكافحة الإحتيال المدعومة بالذكاء الإصطناعي، ودور مجالس الإدارة والإدارة العليا في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال، وجودة العملات النقدية وإنعكاسها على عمليات الفحص، ودور الذكاء الإصطناعي في الإستثمار الآمن والتوعية بالممارسات الإحتيالية في الأسواق المالية، وكشف أسرار الإحتيال المالي الرقمي، وتمكين المحقّقين في جرائم الإحتيال المالي وبناء قدراتهم في عصر التطوُّر الرقمي، والمسؤولية المشتركة للقطاعات المختلفة في مكافحة الإحتيال. علماً أن المؤتمر صاحبه معرض متخصّص للمؤسسات المصرفية والمالية المشاركة.
وشارك في الإفتتاح إلى راعي المؤتمر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، كل من السادة: محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وعدد كبير من الخبراء والمصرفيين المصريين والعرب.
 محافظ الأقصر عبد المطلب عماره:
محافظ الأقصر عبد المطلب عماره:
جهود إتحاد المصارف العربية منصة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
في كلمته، رحب محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره بضيوف المؤتمر من الخبراء والمصرفيين العرب في مدينة الأقصر، مؤكداً «أهمية إحتضان محافظة الأقصر لمثل هذا المؤتمر الذي يُعد إضافة وإثراء للمحافظة بإعتباره إحتفالية في قطاع يصنع الثقة ويحمي الإستقرار ويصل الإقتصادات ببعضها، ويُعدّ ركيزة أساسية من ركائز الإستقرار المالي وداعماً مهماً للإقتصادات الوطنية في عالمنا العربي»، متمنياً في «أن يُساهم المؤتمر في تعزيز التعاون العربي المشترك، لا سيما وأنه يناقش أحد القضايا الحيوية التي تمسّ أمن الإقتصادات الوطنية العربية مثل مكافحة الاحتيال المالي»، ومشيداً بجهود إتحاد المصارف العربية «بإعتباره منصّة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواجهة التحدّيات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي سواء على مستوى التشريعات، أو التحوُّل الرقمي، أو متطلّبات الإمتثال والحوكمة، ومكافحة الإحتيال المالي، وتسهيل حركة الأموال، وتعزيز الشمول المالي، بما يخدم مصالح مجتمعاتنا، ويُواكب تطلُّعات شعوبنا نحو نمو مستدام وإقتصاد أكثر مرونة». علماً أن محافظ الأقصر كان قد شارك في حضور الجلسة الأولى والتي تخلّلها كلمة رئيسية بعنوان: «نظرة عامة على أعمال مكافحة الإحتيال في القطاع المصرفي المصري».
رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
التطوُّر الكبير في مجال التكنولوجيا وآليات الذكاء الإصطناعي يتطلّب صوغ إستراتيجية متكاملة وإستباقية لمواجهة الجيل الجديد من الجرائم المالية
وقال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري: «إن البنوك المصرية تُطوّر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع ودعم الجاهزية لمواجهة أية مخاطر محتملة»، موضحاً «أن إجمالى ودائع البنوك المصرية إرتفع إلى 15.3 تريليون جنيه، وأن حجم أصول القطاع المصرفي المصري إرتفع إلى 24 تريليون جنيه، مما يعكس قوة مؤشّرات الأداء المصرفي في مصر».
وأضاف الإتربي: «إن التطوُّر الكبير في مجال التكنولوجيا وآليات الذكاء الإصطناعي وما يرتبط به من الجرائم المالية والإقتصادية يتطلّب صوغ إستراتيجية متكاملة وإستباقية لدعم الأمن السيبراني وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الجيل الجديد من الجرائم المالية»، لافتاً إلى «أهمية ترسيخ الثقة مع العملاء، وزيادة برامج التوعية وخطط إستمرار الأعمال والتعافي السريع وهو ضرورة لقوة الأنظمة الدفاعية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة».
 الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش:
الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش:
هدفنا تعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية
وقال الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية: «تعمل جامعة نايف على دعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، وفي مقدّمها تشريعات مكافحة الجرائم الإقتصادية، التي تضعها الجامعة ضمن أولوياتها».
أضاف د. الحرفش: «إن مكافحة الإحتيال المالي لم تعد تحدّياً فنياً أو رقابياً فحسب، بل مسؤولية مشتركة تتطلّب تشريعات مرنة، وقدرات متخصّصة، وتكاملًا فعّالًا بين الجهات الأمنية والمالية والرقابية، وأتطلّع في أن يُسهم هذا المؤتمر في تعميق التنسيق وتبادل الخبرات، وتقديم حلول عملية تُعزّز حماية الإقتصادات وترفع كفاءة المواجهة في هذا المجال المتسارع».
 المستشار أحمد سعيد خليل:
المستشار أحمد سعيد خليل:
الطفرة التكنولوجية تحمل ثغرات يمكن إساءة استغلالها
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، خطورة جرائم الإحتيال، كونها ضمن الجرائم التى تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وإستشهد المستشار أحمد سعيد خليل بالجهود الدولية المبذولة لحثّ الدول على مكافحة هذه الجرائم بفعّالية، بما يشمل قرار مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشيراً إلى عدد من التوصيات للدول الأطراف حيال الإحتيال المنظم، بالإضافة إلى إشارة العديد من المنظمات الدولية إلى تطوُّر أساليب إرتكاب جرائم الإحتيال، «كونها إحدى الجرائم المنظمة، بما يشمل تقرير منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) حول تقييم الإحتيال المالي العالمي، الصادر خلال العام 2024، كذلك مجموعة العمل المالي في تقريرها الصادر في هذا الشأن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023».
وأشار المستشار خليل إلى «الطفرة التكنولوجية التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما حمل في ثناياه ثغرات قد يُمكن إساءة إستغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بما يشمل جرائم الإحتيال، التي هيمنت خلال الفترة الأخيرة على الجرائم السيبرانية المرتكبة، وفق ما أشارت إليه مجموعة العمل المالي»، موضحاً «أن الإحتيال المالي يُعد إحدى الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، نظراً إلى ما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية بقصد تحقيق عوائد غير مشروعة، يعمد مرتكبوها إلى إخفاء مصادرها عبر إدخالها إلى النظام المالى الرسمي».
وشدّد المستشار أحمد سعيد خليل على «حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على التصدّي الفعّال لهذه الجرائم ومكافحتها وفق الإختصاصات والصلاحيات المخوّلة لها قانوناً، بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمى أو الدولي، من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب مشاركتها الفاعلة فى اللجان الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن تعاونها الدولي عبر شبكات تبادل المعلومات، بما يُسهم في مواجهة جرائم الإحتيال وغسل الأموال والتصدّي لطبيعتها العابرة للحدود الوطنية».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
تلتزم الدولة المصرية دعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتّى صور الإحتيال والجريمة المالية
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله: «لقد مثّل المؤتمر في نسخته الأولى أول منصّة عربية متخصصة لمناقشة قضايا الاحتيال المصرفي، وطرح آليات التعامل معها، وها نحن اليوم في النسخة الثانية نبني على ما تحقق من نتائج وتوصيات، وننطلق نحو آفاق أوسع، تتواكب مع ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، وتحديات أكثر تعقيدًا في هذا المجال الحيوي».
وأضاف المحافظ عبد الله: «يأتي إنعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الإحتيال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل إستمرار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وما أفرزته من تحدّيات غير مسبوقة أمام الإقتصادات والمؤسسات المالية، لا سيما ما يتعلق بتطور أساليب الإحتيال، وتنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة.
ورغم الفرص التي تخلقها التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي، حيث تُسهم في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، إلاّ أنه من الناحية الأخرى تفرض تحدّيات جديدة ينتهجها المحتالون على نحو أفرز صناعة عالمية جديدة باتت تسمّى الإحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والذي تطلب معه العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة.
وتطويعاً لتلك التكنولوجيا جاءت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمواجهة تلك المخاطر وما يصاحبها من أهمية رفع درجات الوعي والمعرفة لدى عملاء القطاع المصرفي والمتعاملين معه».
وتبع المحافظ عبد الله: «إن تحقيق مستوى فعّال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حدٍ سواء.
ومن ناحية البنك المركزي المصري، تم تطبيق ذات النهج الذي ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا احتيال، وفي ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية تم إجهاض حالات احتيالية بمقدار 4 مليارات جنيه مصري العام السابق، بما يمثل زيادة في نسب إجهاض الحالات الاحتيالية بحوالي 268% عن العام 2024.
وعلى صعيد آخر كانت هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ خلال العام المنقضي بمقدار 116.8 مليون جنيه مقارنه بمبلغ 6.5 ملايين جنيه خلال العام 2024، مما يعد مؤشراً إيجابياً على سرعة إستجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الإحتيالية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتواءم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، كما تبرز الحاجة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال فضلًا عن خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.
وإنطلاقًا من إيماننا بأن مكافحة الإحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، فإننا نؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون وصولاً إلى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزّز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية».
وختم المحافظ عبد الله قائلاً: «إن مصر، بوصفها جزءاً لا يتجزّأ من المنظومة الإقليمية والدولية، تواصل جهودها الحثيثة لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للمتغيّرات الإقتصادية والمالية العالمية المتسارعة، وبما يعكس إلتزام الدولة المصرية بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتّى صور الإحتيال والجريمة المالية».

البنك الدولي: رغم الصمود… الإقتصاد العالمي يتّجه للإنخفاض في العام 2026
تباطؤ وتيرة النمو يُؤدي إلى إتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً
البنك الدولي: رغم الصمود… الإقتصاد العالمي يتّجه للإنخفاض في العام 2026
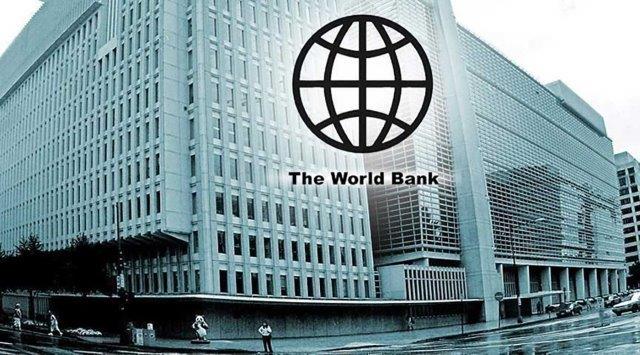
وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات العام 2026، وفق ما جاء في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية». وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.
ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى إتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية العام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الإقتصادات المتقدمة مستويات العام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.
وفي العام 2025، إستفاد النمو العالمي من طفرةٍ شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيُّف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدفعة في العام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي، غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيّز المالية العامة في عدد من الإقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ.
توقُّعات التضخّم
ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 % في العام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، مقدّراً أن يتحسن النمو في العام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين حيال السياسات.
ويقول إندرميت جيل، رئيس الخبراء الإقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصادات التنمية: «مع مرور كل عام، أصبح الإقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين حيال السياسات. لكن هذا التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يُمكنه أن يستمر لفترة طويلة من دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الإئتمان»، متوقعاً «أن ينمو الإقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة. ولتفادي حدوث الركود وإرتفاع معدّلات البطالة، يجب على الحكومات في الإقتصادات الصاعدة والمتقدّمة أن تعمل بقوة على تحرير إستثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الإستهلاك العام، إلى جانب الإستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم».
الإقتصادات النامية
وتوقَّع التقرير «أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في العام 2026 إلى 4 %، مقارنة بـ4.2 % خلال العام 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1 % في العام 2027 مع إنحسار التوترات التجارية، وإستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسُّن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الإستثمار»، مقدّراً «أن يرتفع معدّل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6 % خلال الفترة 2026-2027، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخُّم».
غير أن هذا لن يكون كافياً لتضييق فجوة الدخل بين الإقتصادات النامية والمتقدمة، وفق البنك الدولي، إذ «يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الإقتصادات النامية 3 % في العام 2026؛ أيْ أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019»، مقدراً «أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الإقتصادات النامية 12 % فقط من نظيره في الإقتصادات المتقدّمة».
الوظائف
وقد تؤدي هذه الإتجاهات إلى تفاقم التحدّي المرتبط بتوفير الوظائف في الإقتصادات النامية، حيث سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل، خلال العقد المقبل، وسيتطلّب التغلُّب على هذا التحدّي، وفق البنك الدولي، بذل جهد شامل على صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان إستقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار. علماً أن هذه التدابير مجتمعةً ستُوجه جهود خلق الوظائف نحو فرص عمل أكثر إنتاجية في القطاع الرسمي، بما يُسهم في دعم نمو الدخل والحدّ من الفقر.
المالية العامة
كذلك تحتاج الإقتصادات النامية إلى تعزيز إستدامة ماليتها العامة التي تآكلت في السنوات الأخيرة بفعل توالي الصدمات وتداخلها، وإزدياد إحتياجاتها الإنمائية، وإرتفاع تكاليف خدمة الدين. كما يُخصّص التقرير فصلاً خاصاً لتحليل شامل لإستخدام قواعد المالية العامة في الإقتصادات النامية، التي تضع حدوداً واضحة لإقتراض الحكومات وإنفاقها، بما يُسهم في تحسين إدارة المالية العامة.
وترتبط هذه القواعد، عادةً، بنمو اقتصادي أقوى، وزيادة الاستثمارات الخاصة، واستقرار أكبر في القطاعات المالية، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
بدوره، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: «مع وصول الدين العام في الإقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، أصبحت إستعادة مصداقية المالية العامة أولويةً قصوى. ويُمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على إستقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والإلتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أم تخفق في تحقيق الإستقرار والنمو».
وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف الإقتصادات النامية لديها، الآن، قاعدة مالية واحدة، على الأقل، قيد التطبيق، ويُمكن أن تشمل هذه القواعد وضع حدود لعجز المالية العامة، أو الدين العام، أو النفقات الحكومية، أو تحصيل الإيرادات، موضحاً أن الإقتصادات النامية التي تعتمد قواعد مالية تشهد عادةً تحسُّناً في رصيد الموازنة بنحو 1.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد خمس سنوات، وذلك بعد إحتساب مدفوعات الفائدة وتقلبات الدورة الإقتصادية. كما أن تطبيق هذه القواعد يزيد بنحو 9 نقاط مئوية من إحتمالية تحقيق تحسن بأرصدة الموازنة على مدى سنوات عدة.
ويخلص التقرير إلى أن المنافع متوسطة وطويلة الأجل لقواعد المالية العامة تعتمد بصورة كبيرة على قوة المؤسسات، والسياق الاقتصادي الذي تُطبق فيه هذه القواعد، إضافةً إلى جودة تصميمها.
الآفاق الخاصة بمناطق في العالم
- شرق آسيا والمحيط الهادئ: يُتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4 % في العام 2026، وإلى 4.3 % في العام 2027.
- أوروبا وآسيا الوسطى: يُتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 2.4 % في العام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في العام 2027.
- أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي: يُتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً إلى 2.3 % في العام 2026، قبل أن يتعزّز ليبلغ 2.6 % في العام 2027.
- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: يُتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6 % في العام 2026، وأن يُواصل التحسُّن ليصل إلى 3.9 % في العام 2027.
- جنوب آسيا: يُتوقع أن يتراجع معدّل النمو إلى 6.2 % في العام 2026، قبل أن يتعافى ليصل إلى 6.5 % في العام 2027.
- أفريقيا جنوب الصحراء: يُتوقع أن يرتفع معدّل النمو إلى 4.3 % في العام 2026، وأن يُواصل التحسن ليصل إلى 4.5 % في العام 2027.

هشام عز العرب: تحصين القطاع المصرفي ضرورة إستراتيجية لصمود الإقتصادات
رئيس البنك التجارى الدولي CIB هشام عز العرب:
تحصين القطاع المصرفي ضرورة إستراتيجية لصمود الإقتصادات

وأضاف عز العرب: «أن البنوك اليوم لم تعد مجرّد وسيط مالي، بل تمثل الجهاز الدوري للإقتصاد؛ إذ تدعم النمو، وتيسّر الإستثمار، وتموّل القطاع الخاص».
ولفت عز العرب إلى «أن تعثُّر المؤسسات المصرفية ينعكس مباشرة على إستقرار الإقتصادات، بينما يؤدي نجاحها في التكيُّف والإبتكار إلى ترسيخ الإستقرار وتعزيز الثقة»، مشدّداً على «أن بناء قدرة إمتصاص الصدمات يتطلّب معماراً جديداً للصمود، قوامه تطوير القطاع المالي ليكون قادراً على التعامل مع الإضطرابات بسرعة وكفاءة»، مؤكداً «أن التحوُّل الرقمي، رغم ما حقّقه من مكاسب في السرعة والشفافية وخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات، لا يكفي بمفرده لحماية الإقتصادات من المخاطر المتغيّرة»، موضحاً «أن المعادلة الأكثر فاعلية اليوم هي دمج الرقمنة مع التمويل المستدام، عبر تضمين مؤشّرات الإستدامة داخل المنتجات الرقمية والشراكات والمعاملات وقرارات الإبتكار، بما يضمن أن تتحرّك البنوك بسرعة ولكن في الإتجاه الصحيح أيضاً».
ولفت عز العرب إلى «أن التمويل المستدام يُوجّه رأس المال نحو نمو أكثر شمولًا ومسؤولية بيئية وإجتماعية، بما يعزّز جودة الأصول وتحسين ملفات المخاطر وتقوية الميزانيات العمومية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي وخلق قيمة إقتصادية طويلة الأجل»، معتبراً «أن تصميم نموذج تشغيلي «مُحصَّن ضد الصدمات» داخل البنوك، خصوصاً في الأسواق الناشئة، يتطلّب أربعة محاور رئيسية، تشمل:
أولًا: المرونة الإستراتيجية، عبر القدرة على التحرُّك الفوري وقت الإضطرابات، وإعادة تخصيص الموارد، وتعديل إستراتيجيات الإئتمان والسيولة ورأس المال.
ثانيًا: التوسُّع التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل، وخفض تكلفة خدمة العملاء، وبناء أدوات متقدّمة لإدارة المخاطر.
ثالثًا: الحوكمة المدفوعة بالإستدامة لضمان مراعاة الأثر طويل الأجل، والإلتزام بالمتطلّبات الرقابية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
رابعاً: تنمية رأس المال البشري من خلال تطوير المهارات القيادية والرقمية، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الإبتكار والجاهزية للتغيير».
وختم عز العرب مؤكداً «أن مستقبل القطاع المصرفي لن يُقاس فقط بالقدرة على تحقيق الأرباح، بل بمدى قدرته على دعم إستقرار الإقتصادات، وتمكين المجتمعات، وبناء أنظمة مالية أكثر صلابة وإستدامة في مواجهة الصدمات».

البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج المعرفة المالية والإبتكار التكنولوجي
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج «المعرفة المالية والإبتكار التكنولوجي»
إختتم البنك العربي ومركز هيا الثقافي مؤخراً برنامج «المعرفة المالية والإبتكار التكنولوجي»الذي جرى تنفيذه على مدار ثلاثة أشهر، وإستهدف الأطفال واليافعين من المدارس الحكومية والجمعيات الخيرية في العاصمة عمّان ومحافظات البلقاء، والزرقاء، ومأدبا. ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج إنطلاقاً من إلتزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على الإستثمار في طاقات الأجيال الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعزّز دورهم المستقبلي، وتؤهّلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الإبتكار.
وقد تم من خلال البرنامج تمكين 285 مشاركاً من إكتساب مهارات مالية وتكنولوجية وإبداعية، ضمن تجربة تعليمية تطبيقية عزّزت معارفهم وقدراتهم بطريقة مبتكرة وتفاعلية، حيث إعتمد على منهجية تجمع بين التعليم العملي والتكنولوجيا والفنون، مقدّماً نموذجاً متكاملاً يقرّب المفاهيم المالية من الواقع اليومي للأطفال واليافعين، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الإدخار وتنمية مهارات التفكير الإبداعي. وقد شمل الجانب التطبيقي ورش «الحصّالة الذكية» التي أتاحت للأطفال من عمر 9–14 عاماً تصميم حصّالات قادرة على عدّ العملات بإستخدام تقنيات (Arduino)، إلى جانب نشاط الروبوت جونير الذي أتاح لليافعين تجربة بناء روبوت تفاعلي يُصدر إشارات ضوئية وصوتية إستجابة لإدخال العملات المعدنية، مما منح المشاركين فرصة التعرّف على أساسيات البرمجة والإلكترونيات والميكانيك.
كما شارك متطوّعو البنك العربي في تنفيذ الأنشطة، من خلال تقديم الدعم العملي والإشراف على التجارب التعليمية، تعزيزاً لدور البنك في الإستثمار في طاقات الأجيال الناشئة ضمن إطار مسؤوليته المجتمعية.
وفي هذا السياق، قالت ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي: «نفخر بتعاوننا الهادف والمستمر مع البنك العربي، والذي أتاح لنا تصميم وتنفيذ برامج تعليمية مبتكرة تعرّف الأطفال واليافعين بأهمية الإدخار من خلال الفنون والتعلّم التجريبي، وتزويدهم بمهارات تكنولوجية ومعرفية تُعزّز ثقتهم بأنفسهم وتفتح أمامهم آفاق المستقبل»، مشيرة إلى «أن هذا التعاون يشكّل خطوة محورية في رؤيتنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أطفال ويافعي الأردن على إختلاف مواقعهم وقدراتهم».
حملة «سنتك على حسابنا» الخاصة بالبطاقات الائتمانية

ويأتي إطلاق الحملة مع بداية العام الجديد، لتتماشى مع تطلُّعات وإحتياجات المعتمدين المتنوّعة مثل التسوّق، والسفر، ودفع أقساط التعليم، وتسديد الفواتير المختلفة، حيث تتيح لهم إمكانية الدفع الإلكتروني بإستخدام البطاقات الإئتمانية محلياً ودولياً أو عبر مواقع التسوُّق الالكتروني بطريقة آمنة وسلسة. كما تمنح الحملة المعتمدين فرصة الإستفادة من باقة مميّزة من العروض والمزايا بما يشكّل قيمة مضافة لتجربتهم المصرفية.
وتتضمّن الحملة السحب على 60 جائزة طوال فترة الحملة الممتدة حتى نهاية العام 2026 بواقع 5 فائزين شهرياً، يحصل كل منهم على استرداد نقدي بنسبة 100 % وبحد أقصى 500 دولار، وذلك عند إستخدام بطاقة البنك الإئتمانية في الشراء بمجموع 200 دولار فأكثر. كما تشمل الحملة أيضاً السحب على 3 جوائز كبرى في نهاية الحملة بقيمة 20,000 دولار لكل جائزة، للمعتمدين الذين يصل مجموع إستخدامهم للبطاقة الى 1,000 دولار فأكثر خلال فترة الحملة.
ويقول وائل الخطيب مدير دائرة خدمات الأفراد في البنك العربي – فلسطين: «إن هذه الحملة تأتي إنسجاماً مع إستراتيجية البنك بدعم التحوُّل الرقمي، وتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة لمعتمدينا، لتُسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية اليومية».
وأضاف الخطيب: «تعكس الحملة إلتزام البنك بتوسيع نطاق إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وترسيخها كخيار عملي ومريح وآمن بإستخدام البطاقات الإئتمانية»، مشيراً إلى «أن إطلاق الحملة مع بداية العام الجديد (2026) يأتي تقديراً لثقة المعتمدين بالبنك، وحرصاً على مكافأتهم بعروض متميّزة وجوائز ذات قيمة عالية».

الكويت الدولي يُصدر صكوكاً بما لا يتجاوز 300 مليون دولار
«الكويت الدولي» يُصدر صكوكاً بما لا يتجاوز 300 مليون دولار

ويهدف البنك من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خططه التوسُّعية في السوق المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع متطلّبات بازل 3 واللوائح الرقابية ذات الصلة. وتُعد هذه الصكوك أداة تمويلية تساعد على تعزيز كفاية رأس المال وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية.
ويأتي هذا التوجُّه في ظل استمرار البنوك الكويتية في تنويع مصادر تمويلها عبر أدوات الدين الإسلامية، بما يلبّي الطلب المتزايد من المستثمرين المحترفين على الصكوك ويُعزّز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي في هذا القطاع.

مزايا حساب ميغا توفير من بنك القاهرة لعام 2026
مزايا حساب ميغا توفير من بنك القاهرة لعام 2026

ومن هذه البنوك يقدم بنك القاهرة حساب ميغا توفير بسعر عائد يصل إلى 17.75 % وفي حد أدنى لفتح الحساب يبدأ من 5000 جنيه .
تفاصيل حساب ميغا توفير من بنك القاهرة
- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.
- الحد الأدنى لإحتساب العائد: 100.000 جنيه.
- يتم إحتساب العائد على الحد الأدنى لرصيد الحساب خلال الشهر.
- دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، سنوي.
- إمكانية السحب أو الإيداع من كافة فروع بنك القاهرة على مستوى الجمهورية.
- إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
سعر العائد الشهري
– من 0 إلى 99.999 جنيه: 0 %.
– من 100.000 جنيه إلى 999.999 جنيه : 11.00 %.
– من 1.000.000 جنيه إلى 9.999.999 جنيه: 13.50 %.
– من 10.000.000 جنيه إلى 29.999.999 جنيه: 16.50 %.
– من 30.000.000 جنيه فأكثر: 17.25 %.
سعر العائد ربع سنوي
– من 0 إلى 99.999 جنيه: 0 %.
– من 100.000 جنيه إلى 999.999 جنيه:11.50 %.
– من 1.000.000 جنيه إلى 9.999.999 جنيه: 13.75 %.
– من 10.000.000 جنيه إلى 29.999.999 جنيه: 16.75 %.
– من 30.000.000 جنيه فأكثر: 17.50 %.
سعر العائد السنوي
– من 0 إلى 99.999 جنيه: 0 %.
– من 100.000 جنيه إلى 999.999 جنيه: 12.00 %.
– من 1.000.000 جنيه إلى 9.999.999 جنيه : 14.00 %.
– من 10.000.000 جنيه إلى 29.999.999 جنيه: 17.00 %.
– من 30.000.000 جنيه فأكثر: 17.75 %.

الأهلي المصري.. يفتتح قاعات التقاضي الإلكترونية
تعزيزاً لمسيرة التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي والسلك القضائي المصري
«الأهلي المصري» يفتتح قاعات التقاضي الإلكترونية
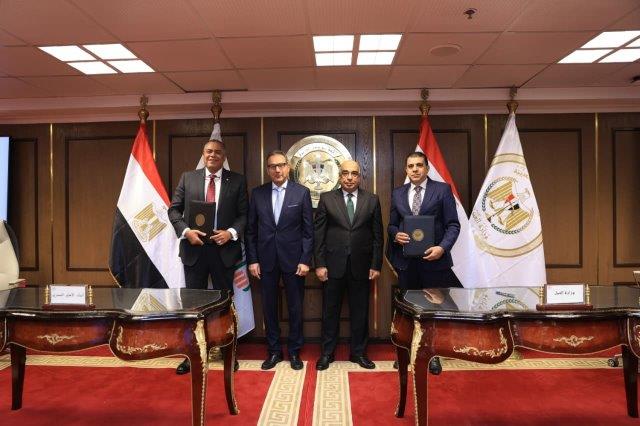
وقد شارك في الإفتتاح المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وأشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي في البنك، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون القانونية، إضافة إلى نخبة من كبار مسؤولي الجانبين.
وأكد فنجري «أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الإستراتيجية، بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا».
من جانبه، أكد الإتربي «أن مصر تشهد خطوات ثابتة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحوُّل الرقمي لهذه المنظومة»، موضحاً «أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام تمثل أحد الأركان الأساسية لإستراتيجية التنمية المستدامة، والتي يوليها البنك الأهلي المصري إهتماما بالغاً»، مؤكداً «أن قاعات التقاضي الإلكترونية ورقمنة منظومة التقاضي في البنك تُعد وسيلة لتحسين الأوضاع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية»، مضيفاً «أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة البنك لكافة المستحدثات التقنية التي تتم داخل مختلف الجهات الحكومية، والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الشاملة، مما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتوفير الوقت والجهد المبذول لكافة المتقاضين في البنك».
«الأهلي المصري» يُسلّم عدداً من البيوت والمشروعات الصغيرة للمستفيدين في محافظة أسوان
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي المصري عن تسليم عدد من الوحدات السكنية والمشروعات لعدد من الأسر المستفيدة في محافظة أسوان في مركز دراو، قرية بنبان، في حضوراللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية، ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية في «الأهلي المصري» وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وفريق عمل التنمية.
وأعرب اللواء إسماعيل كمال عن تقديره لهذه المبادرة «التي تساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين»، مؤكداً «أهمية الشراكة بين «الأهلي المصري» وجمعية الأورمان في تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق في محافظة أسوان».
من جانبه، أكد محمد الإتربي «إلتزام «الأهلي المصري» بدوره المجتمعي تجاه أهل مصر، حيث شملت هذه المبادرة إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدّمة بالكامل، وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تقديم دعم مستدام للمستفيدين، بهدف تمكين أهل القرية إقتصادياً وإجتماعياً وتعزيز قدراتهم على الإعتماد الذاتي»، مؤكداً «أن البنك يحرص على إستمرار دعمه للمبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر إحتياجاً، مع التركيز على تمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج التنمية المستدامة».

من جانبه أعرب أحمد الجندي عن إعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع الحيوي، «والتي تعزّز أثر العمل المجتمعي المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية، بما يُحقّق نتائج ملموسة على الأرض ويترك أثراً إيجابياً طويل الأمد في المجتمعات المحلية»، مشيراً إلى «أن هذه المبادرة ليس مجرّد إعادة بناء للبيوت المتهدمة، بل يمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة، من خلال دمج البُعد الإجتماعي مع البُعد الإقتصادي، عبر توفير مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر المحتاجة، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار الإجتماعي ورفع جودة الحياة في المنطقة».
«الأهلي المصري» مستشار مالي لتحالف مصرفي يضم QNB مصر و CIB وبنك القاهرة
على صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن مشاركته كمستشار مالي رئيسي في تحالف مصرفي يضم QNB مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوّق التمويل، ووكيل التمويل، وبمشاركة كل من البنك التجاري الدولي (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك المستندات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوّق التمويل ووكيل الضمان في ترتيب وتوفير تمويل مشترك بقيمة تقارب من 140 مليون دولار لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون.
ويهدف هذا التمويل المشترك الى تطوير وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمّع صناعي متكامل لإنتاج معدن السيليكون ومشتقاته في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن من السيليكون المعدني، وبإجمالي إستثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار.
ويأتي قيام التحالف المصرفي بدور المرتبين الرئيسيين لهذا القرض المشترك دعماً لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الإقتصادي الإيجابي، كما تؤكد إستراتيجية البنوك المشاركة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد شارك في حضور حفل التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ايكم، المهندس إبراهيم مكي، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، ورشا رمضان، والدكتور أمجد كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر وعمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية، ومحمد شاكر، المشرف على مجموعة الإئتمان المصرفي للشركات وقطاع إئتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي في بنك القاهرة، وعدد كبير من قيادات القطاع المصرفي.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: «إن البنك نجح في تعزيز دوره الريادي كشريك إستراتيجي في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة للتنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن البنك قام بدور المستشار المالي الرئيسي لمشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون لإنشاء المرحلة الأولى من مجمع السيليكون، حيث قاد عملية توفير تمويل بقيمة 140 مليــــــون دولار يمثـل 70 % من إجمالي التكلفة الإستثمارية للمشروع البالغة 200 مليون دولار»، مضيفاً «أن دور البنك الأهلي المصري شمل تصميم الهيكل التمويلي الأمثل بما يتوافق مع طبيعة المشروع ومتطلّباته التمويلية والتشغيلية، بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك المموّلة لضمان أفضل الشروط والأحكام التمويلية، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية التمويل».

ماستركارد ومجموعة QNB يعزّزان حلول المدفوعات في سوريا
ماستركارد ومجموعة QNB يعزّزان حلول المدفوعات في سوريا

أعلنت شركة ماستركارد عن منح ترخيص لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتيح لها توسيع أنشطة إصدار وقبول المدفوعات داخل سوريا، عبر تقديم حلول ماستركارد للمدفوعات، المقبولة محلياً ودولياً، للأفراد والشركات.
وستساهم هذه الخطوة، التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين ماستركارد ومصرف سورية المركزي في سبتمبر/ أيلول 2026 بهدف دعم عملية تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، في توسيع نطاق الوصول إلى معاملات رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة.
ويُعد هذا التعاون محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين ماستركارد و QNB في سوريا، ضمن جهودهما المشتركة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، ومنح فرص جديدة من خلال توظيف التكنولوجيا لإثراء حياة العملاء.
ويعكس إلتزام البنك بريادة الابتكار الرقمي عبر شبكته الدولية وحرصه على تعزيز النمو المستدام في سوق يتمتع بإمكانات واعدة. ومن خلال هذا التعاون الجديد، يهدف الجانبان إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا ودعم إنتقاله نحو منظومة رقمية أكثر تطوراً.
ويقول آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نواصل تعزيز وجودنا في سوريا بإعتبارنا من أوائل الشركات العاملة في هذه السوق المتنامية. ويمثل دعم شركائنا من البنوك خطوة أساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية أمام ملايين المواطنين، ووضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل. ويأتي هذا العمل دعماً لرؤية سوريا في تحقيق تقدم إقتصادي مستدام، مع الإلتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الإمتثال».

بنك مصر يحصد الدرع الذهبي من يوتيوب ويتصدّر منصّات التواصل الإجتماعي
بنك مصر يحصد الدرع الذهبي من يوتيوب
ويتصدّر منصّات التواصل الإجتماعي

وقد بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطّى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.
ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكداً مكانته بإعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصّات التواصل الإجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعّالة ومستدامة مع المجتمع.
ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح إستراتيجية بنك مصر في توظيف المنصّات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يُسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصّات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.
ويُعد هذا الإنجاز إمتداداً للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصّة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سبّاقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعّال مع المجتمع.
ويؤكد بنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس إلتزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيراً وتفاعلاً على المنصّات الرقمية، ويجسّد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

أبوظبي الأول: الأكثر تعزيزاً لمحفظة أصوله بقيمة 35.44 مليار دولار
أداء البنوك العربية الكبرى على مؤشر تعزيز الأصول
«أبوظبي الأول» الأكثر تعزيزاً لمحفظة أصوله بقيمة 35.44 مليار دولار
خلال النصف الأول من العام 2025 و«الأهلي السعودي» وصيفاً

وإستحوذت البنوك المصرية على مقعدين ضمن قائمة أكثر 10 بنوك تعزيزاً للأصول، ما يعكس قدرتها على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعربي، في حين إقتصر تمثيل الكويت وقطر على مقعد واحد لكل دولة ضمن العشرة الأوائل.
وشمل التصنيف البنوك العربية الكبرى، والتي يعرفها مركز تصنيفات «First Bank» على أنها البنوك التي يزيد حجم أصولها عن 15 مليار دولار.
وعلى مستوى ترتيب البنوك ضمن القائمة، إحتل بنك أبوظبي الأول صدارة القائمة، بعدما تمكن من تعزيز محفظته من الأصول بنحو 35.44 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 365.79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 330.35 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وحصد البنك الأهلي السعودي المركز الثاني، حيث إرتفعت محفظته من الأصول بنحو 26.34 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتسجل 320.23 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 293.89 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث، حيث صعدت محفظة الأصول لديه بحوالي 24.25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتسجل 295.61 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ271.36 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإستحوذ بنك أبوظبي التجاري على المركز الرابع، بعدما إرتفعت محفظته من الأصول بنحو 17.89 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتبلغ 195.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 177.75 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وحلّ خامساً مصرف الراجحي، حيث قفزت محفظته من الأصول بنحو 17.68 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتسجّل 277.03 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 259.35 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإحتلّ البنك الأهلي المصري المركز السادس، بعدما صعدت محفظة الأصول لديه بحوالي 15.38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 175.29 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ159.91 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإنتزع بنك قطر الوطني المركز السابع، حيث إرتفعت محفظة الأصول لديه بنحو 15.29 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتبلغ 371.42 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 356.13 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإقتنص بنك الكويت الوطني المركز الثامن، بعدما إرتفعت محفظته من الأصول بحوالي 11.86 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتسجل 142.83 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 130.97 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وحصد بنك الرياض المركز التاسع، حيث صعدت محفظة الأصول لديه بنحو 10.99 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتصل إلى 130.87 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 119.88 مليار دولار في نهاية العام 2024.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك مصر، بعدما إرتفعت محفظته من الأصول بحوالي 10.74 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتسجل 81.68 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 70.95 مليار دولار في نهاية العام 2024.

هل تحوَّلت بنوك المراسلة الأميركية إلى بوابة للهيمنة المالية؟
هل تحوَّلت بنوك المراسلة الأميركية إلى بوابة للهيمنة المالية؟
نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال
هل أصبحت بنوك المراسلة الأميركية مجرّد وسيط تقني، أم أداة نفوذ تتجاوز حدود الإقتصاد إلى الجغرافيا السياسية؟
في إستطلاع لـ «البيان» تنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية» عن آراء مجموعة من المصرفيين والخبراء الماليين العرب والأجانب يعملون أو عملوا سابقاً في مواقع بارزة في مؤسسات مالية حكومية أو شبه حكومية أو في القطاع الخاص، حيث إنقسمت آراؤهم حول دور بنوك المراسلة وهيمنتها: الفريق الأول يرى أن بنوك المراسلة الأميركية تشكّل، بحكم الواقع، مفصلاً أساسياً في النظام المالي العالمي، في ظل الهيمنة الواسعة للدولار على التجارة الدولية وتسوياتها. ويؤكد هؤلاء أن هذه الهيمنة لا تنبع بالضرورة من نيات سياسية مباشرة، بل من بنية تاريخية وإقتصادية عميقة جعلت الدولار العملة الأكثر إستخداماً في التجارة والإحتياطات، ما فرض مرور المدفوعات عبر بنوك مراسلة وأنظمة مقاصة أميركية.
ووفق هذا المنظور، يؤكد الفريق الأول أن البنوك المراسلة تُعُّد جزءاً من آلية تنظيمية تضمن الإنضباط المالي والإمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُسهم في الحفاظ على الإستقرار المالي العالمي، وإن كانت هذه الآلية مكلفة من حيث الرسوم ومتطلّبات الإمتثال، وخصوصاً في المعاملات العابرة للحدود.
في المقابل، يذهب الفريق الثاني إلى أن هذا الدور التنظيمي تحوّل مع الوقت إلى نفوذ بنيوي قابل للتفعيل سياسياً، معتمدين على حقيقة أن الوصول إلى أنظمة المقاصة الحيوية بالدولار بات شرطاً لا غنى عنه لأي بنك يسعى للمشاركة في التجارة والتمويل العالميين.
 د. ناصر السعيدي:
د. ناصر السعيدي:
هيمنة الدولار ترتكز أكثر على بنية المدفوعات
يرى الدكتور ناصر السعيدي، الإقتصادي اللبناني المخضرم، مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، والذي عمل سابقاً كوزير للصناعة في الحكومة اللبنانية ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي وكبير الإقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، «أن الدولار يهيمن على التجارة والمعاملات المالية الدولية، بما في ذلك النفط، من خلال شبكة بنوك المراسلة الأميركية، ما يمنح السلطات الأميركية قدرة قانونية على أي معاملة بالدولار في العالم. ويبلغ نصيب الدولار من حجم تمويل التجارة الدولية نحو 80.15 %، في مقابل 8.36 % لليوان الصيني و6.17 % لليورو، ما يعكس قدرة الدولار على التحكم في تدفقات الأموال العالمية، بما في ذلك الأموال العربية».
ويشير د. السعيدي إلى «أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كأداة سياسية، عبر العقوبات الإقتصادية والإستبعاد من نظام سويفت ومصادرة الأصول، بما يعكس أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي، ويمتد هذا التأثير ليشمل حالات «سلاح ناعم» عبر قطع العلاقات المصرفية مع دول مثل لبنان وليبيا والسودان وسوريا، بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لأسباب جيوسياسية، ما يؤدي عملياً إلى عزل هذه الدول عن النظام المالي العالمي»، مؤكداً «أن هيمنة الدولار اليوم ترتكز أكثر على بنية المدفوعات وأنظمة التسوية، وليس فقط على دور العملة، حيث يعالج نظام FedWire نحو 4 تريليونات دولار يومياً، وCHIPS حوالي 1.8 تريليون دولار، فيما تمر نحو 95 % من المدفوعات بالدولار عبر هذه الأنظمة. ورغم أن نظام سويفت ليس أميركياً، إلاّ أنه إلتزم غالباً بتوجيهات الولايات المتحدة في حالات إيران وروسيا، ما يعكس قدرة أميركية على التأثير على النظام المالي الدولي».
جمال صالح:
الدرهم الإماراتي من أكثر العملات إمتلاكاً لمقوّمات القدرة التحوُّل على إلىعملة صعبة مستقبلاً
من جهته، يرى جمال صالح، المدير العام لإتحاد مصارف الإمارات، «أن إعتماد البنوك على المراسلة الأميركية في معظم المدفوعات الدولية يشكّل حالة طبيعية في النظام المالي العالمي، ويعود ذلك إلى أن نحو 60 – 70 % من معاملات التجارة الدولية تتم بالدولار الأميركي، ما يجعل المرور عبر البنوك الأميركية جزءاً من آليات العرض والطلب وشعبية العملة على مستوى العالم».
ويشير صالح إلى «أن أي عملية تجارية بين دولتين عادةً ما تمرُّ عبر البنوك التابعة للدولة المصدرة للعملة المستخدمة في الدفع. فعلى سبيل المثال، إذا أراد عميل في المغرب دفع مقابل بضائع لعميل في البحرين بالدولار، فمن الطبيعي أن تمرّ الحوالة عبر بنوك المراسلة في الولايات المتحدة، غالباً في نيويورك. وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية نتيجة تعدد الرسوم أو وجود أكثر من بنك مراسل في العملية، وهو أمر شائع وطبيعي في النظام المالي الدولي»، موضحاً «أن هذا الأمر ينطبق على جميع العملات الصعبة، سواء الدولار الأميركي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو، أو أي عملة وطنية مستخدمة في التسويات الدولية»، مؤكداً «أن مرور العمليات عبر بنوك المراسلة ليس هيمنة أو عقوبة، بل متطلّب فني وبنيوي لا غنى عنه، حتى حيال تسويات بمليارات الدولارات». ويؤكد صالح «أن الدرهم أصبح من العملات القادرة على التحوُّل إلى عملة صعبة مستقبلاً، نظراً إلى إرتفاع مستوى الثقة به وإعتماده في المعاملات الدولية».
د. وسام فتوح:
البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، «أن بنوك المراسلة الأميركية لا تمثل هيمنة فعلية على حركة الأموال العربية، بل إن السيطرة الفعلية تأتي من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، حيث لا يزال يشكل أكثر من 65 % من المعاملات الدولية»، مشيراً إلى «أن أي عملية مقاصة أو تسوية مالية دولية غالباً ما تمر عبر بنوك المراسلة الأميركية، إذ تلتزم هذه البنوك إجراءات صارمة لضمان صحة المعاملات والإمتثال للقوانين، ما يعزّز الإستقرار المالي عالمياً وعلى مستوى المنطقة العربية»، مؤكداً «أن بنوك المراسلة الأميركية تقوم بعمليات «العناية الواجبة» لأي تحويل مالي، للتحقُّق من خلوّها من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو فساد، ما يُسهم في خلق نظم مالية مستقرّة ومنتظمة»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية يجب أن تلتزم القوانين الدولية الصارمة في هذا المجال، وأن البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي».
حمزة دويك:
البدائل الناشئة تسجّل زخماً متزايداً لكنها لا تزال محدودة النطاق والتأثير
يرى حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك، «أن بنوك المراسلة الأميركية تمثل أداة مؤسسية فعّالة للسيطرة على تدفقات رأس المال العربي، حتى في الدول غير الخاضعة لعقوبات مباشرة»، موضحاً «أن هذه السيطرة ليست نتاج قرارات سياسية ظرفية، بل متجذّرة في البنية التحتية لنظام المقاصة بالدولار، الذي يُلزم البنوك العربية بالحفاظ على علاقات مراسلة مع مؤسسات مالية أميركية للوصول إلى أنظمة التسوية الحيوية، وعلى رأسها نظاما فيدواير وتشيبس».
وأكد دويك «أن هيمنة الدولار لا تقتصر على دوره النقدي، بل تمتد إلى السيطرة على البنية التحتية للنظام المالي العالمي»، مشيراً إلى «أن أكثر من 95 % من المدفوعات العابرة للحدود بالدولار تمر عبر بنوك أميركية في مرحلة ما من مراحل التسوية، ما يمنح واشنطن قدرة إستثنائية على الرصد والتنفيذ والضغط التنظيمي على التدفقات المالية العالمية، ما يُعزّز تأثير الدولار بما يتجاوز أدوات السياسة النقدية التقليدية مثل أسعار الفائدة»، مشدّداً على «أن الإعتماد على بنوك المراسلة الأميركية يُمثل كلفة هيكلية دائمة للبنوك العربية، وليست مجرد ظرفية أو مرتبطة بالأزمات».
ديفيد جيبسون – مور: بنوك المراسلة الأميركية تمارس نفوذها على النظام المصرفي العربي بشكل غير مباشر
ويرى المصرفي البريطاني المخضرم ديفيد جيبسون – مور، الرئيس التنفيذي لشركة غلف أناليتيكا، «أن بنوك المراسلة الأميركية تمارس نفوذها على النظام المصرفي العربي بشكل غير مباشر، من خلال أطر الإمتثال وليس عبر السيطرة المباشرة»، موضحاً «أن هذه البنوك تعتمد معايير صارمة للعناية الواجبة، ومراقبة المخاطر، والتحقُّق من الإمتثال، متأثرة بالتوقعات التنظيمية الأميركية، والتي أصبحت أفضل الممارسات العالمية»، مؤكداً «أن تأثير بنوك المراسلة الأميركية هيكلي وليس سياسياً، إذ يعتمد على بنية النظام المالي الدولي، وليس على نوايا سياسية محدّدة تجاه المنطقة العربية»، مشيراً إلى «أن الإعتماد على سلاسل التسوية الدولارية يترتب عليه تكاليف هيكلية، تتجلّى في إرتفاع تكاليف الإمتثال، والتشدّد في متطلبات التوثيق، وإعتماد نهج أكثر تحفظاً في معالجة المعاملات».

د. وسام فتوح شارك في حلقة نقاشية في الجامعة اللبنانية الدولية
 شارك فيها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح
شارك فيها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح
حلقة نقاشية في الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)
عن «مستقبل جدير بالثقة: إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي
اللبناني والعربي»
نظّم طلاب إدارة الفعاليات (PREL405)، الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)، بإشراف الأستاذ محمد عبد الله،
حلقة نقاشية قيّمة بعنوان «مستقبل جدير بالثقة: إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي اللبناني والعربي».
وقد شارك في الحلقة الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية،
حيث تناولت هذه الحلقة التحدّيات الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي، وسبل التعافي الإقتصادي،
ودور الشباب في صياغة مستقبل الخدمات المالية.





مستقبل التمويل عبر سلسلة الكتل يشهد نمواً متزايداً عالمياً
مستقبل التمويل عبر سلسلة الكتل يشهد نمواً متزايداً عالمياً
مدفوعاً بالابتكار التكنولوجي تتفاقم التحدّيات في البلدان العربية بسبب الإفتقار
للبنية التحتية المتينة لسلسلة الكتل وضعف الوعي المالي
يُتوقع أن يصل حجم سوق التمويل عبر سلسلة الكتل إلى حوالي 32.36 مليار دولار في العام 2025، مدفوعاً بالنمو السريع في التمويل اللامركزي (decentralized finance DeFi) والأصول الحقيقية المميّزة tokenized real-world assets. ويعكس هذا النمو توسع نطاق الخدمات المالية القائمة على تقنية سلسلة الكتل، بما في ذلك الإقراض والتداول وإدارة الأصول التي تتم عبر العقود الذكية. ويُعتبر قطاع ترميز الأصول الحقيقية (RWAs tokenization of real-world assets) الأسرع نمواً في سوق التمويل عبر سلسلة الكتل، وقد إرتفع حجمه من 5 مليارات دولار في العام 2022 إلى أكثر من 24 مليار دولار في حلول منتصف العام 2025، بزيادة قدرها 380 %. وقد نمت الإيرادات من الرسوم المفروضة على التطبيقات على سلسلة الكتل بنسبة 126 % في النصف الأول من العام 2025، مما يشير إلى تزايد الطلب من المستخدمين والنظام البيئي الملائم.
كما يُتوقع أن يتجاوز سوق التمويل عبر سلسلة الكتل 1.5 تريليون دولار في حلول العام 2034 مع معدّل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 53 %، مما يؤكد التحوُّل الجذري في مجال التمويل العالمي.
ونعرض في هذا التحقيق، تطوُّر نمو التمويل عبر سلسلة الكتل (onchain finance) عالمياً وفي الدول العربية. كما نسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجه التمويل عبر سلسلة الكتل مع تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. كذلك نعرض التقنيات والبنية التحتية الرئيسية للتمويل عبر سلسلة الكتل، واللوائح التنظيمية، والمنصّات الرئيسية التي تُقدّم التمويل عبر سلسلة الكتل. ونختتم بالتوقعات المستقبلية للتمويل عبر سلسلة الكتل، والتوصيات للمصارف العربية لتعزيز قدراتها على التمويل عبر سلسلة الكتل.
حجم ونمو سوق التمويل عبر سلسلة الكتل
 تطورات التمويل عبر سلسلة الكتل
تطورات التمويل عبر سلسلة الكتل
التمويل عبر السلسلة (Onchain Finance) يشمل الأنشطة والخدمات المالية التي تُنفَّذ وتُسجَّل مباشرةً على سلسلة الكتل (blockchain)، من دون الإعتماد على الوسطاء التقليديين كالبنوك أو السماسرة. ويشمل تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، مثل الإقراض والإقتراض والتداول وإدارة الأصول، والتي تُدار جميعها بعقود ذكية. يُوفِّر التمويل عبر السلسلة شفافيةً وإمكانية وصول أكبر، مما يُمكِّن المستخدمين من التفاعل مع المنتجات المالية في بيئة آمنة.
التقنيات والبنية التحتية للتمويل عبر سلسلة الكتل

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات
التحدّيات التي تواجه التمويل عبر سلسلة الكتل
يُواجه التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain Finance) مجموعة تحدّيات ناجمة عن معوّقات تكنولوجية وتنظيمية. على الصعيد العالمي، تُعوّق الثغرات في العقود الذكية وقلّة القابلية للتوسع والمعايير المُجزأة، التبني السلس. ولا يزال عدم اليقين التنظيمي يُشكل عقبةً رئيسيةً، حيث تُشكل السياسات غير المُتسقة مخاطر إمتثال للمطوّرين والمستخدمين على حدٍ سواء. في الدول العربية، تتفاقم هذه التحدّيات بسبب الإفتقار للبنية التحتية المتينة لسلسلة الكتل، وضعف الوعي المالي، والحاجة إلى مواءمة المنتجات المالية عبر سلسلة الكتل مع مبادئ التمويل الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الأطر التنظيمبة المُوحدة وأنظمة الهوية الرقمية يُقيد قابلية التشغيل البيني والثقة في المعاملات عبر الحدود. إن التغلب على هذه العقبات يتطلب جهوداً مُنسقة بين الحكومات والمؤسسات المالية ومُبتكري التكنولوجيا لبناء أنظمة سلسلة كتل آمنة وشاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
التشريعات
تتطوّر التشريعات لتنظيم التمويل عبر سلسلة الكتل بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التوازن بين الإبتكار وحماية المستهلك والإستقرار المالي. في الإقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، تُقدم الجهات التنظيمية أطراً للعملات المستقرة والتمويل اللامركزي والأصول الرمزية، مع تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.
في الدول العربية، هناك تفاوت كبير في التشريعات المتعلقة بالتمويل عبر سلسلة الكتل. تقود دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية برامج تجريبية وأنظمة ترخيص لبورصات العملات المشفرة ومنصات البلوك تشين، بهدف أن تصبح مراكز إقليمية للتكنولوجيا المالية. إلا أنه لا تزال دول عربية أخرى حذرة، وغالباً ما تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للأصول الرقمية. إن توحيد اللوائح التنظيمية في جميع الدول العربية ومواءمتها مع المعايير العالمية أمراً أساسياً لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل عبر سلسلة الكتل في العالم العربي.
المنصّات الإلكترونية التي تقدم التمويل عبر سلسلة الكتل
هناك العديد من المنصّات الإلكترونية الرائدة في تقديم خدمات التمويل عبر سلسلة الكتل، بدءاً من الإقراض اللامركزي ووصولاً إلى إدارة الأصول الرمزية. وتقدم هذه المنصّات حلولاً مالية شفافة وآلية وشاملة.
المنصّات الإلكترونية الرائدة التي تقدم التمويل عبر سلسلة الكتل
التمويل عبر سلسلة الكتل في الدول العربية
يشهد التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain finance) في الدول العربية تطوراً سريعاً، مدفوعاً بالتحوُّل الرقمي، والتبنّي، والأطر التنظيمية المتقدمة في بعض الدول العربية. تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مبادرات في مجال التمويل المفتوح، على نطاق واسع يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة والإستثمارات والتأمين وخدمات الإئتمان. ومن المتوقع أن تنمو السوق الإقليمية للتمويل عبر سلسلة الكتل لتصل إلى 11.74 مليار دولار في حلول العام 2027، مما يعكس معدّل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 45 %. ويدعم هذا النمو إرتفاع معدّل إنتشار الهواتف الذكية، وتحسّن البنية التحتية للإنترنت، وإستراتيجيات التكنولوجيا المالية المدعومة من الحكومات والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والمشاركة الإقتصادية. كما تتعاون الهيئات التنظيمية العربية الى توحيد المعايير وتعزيز الإبتكار.
الجوانب الرئيسية للتمويل عبر سلسلة الكتل في الدول العربية
التوصيات للمصارف العربية لمواكبة تطورات التمويل عبر سلسلة الكتل
على المصارف العربية تبني التمويل عبر سلسلة الكتل (onchain finance) بشكل استباقي من خلال دمج البنية التحتية لسلسلة الكتل (blockchain) في عملياتها الأساسية، بدءاً من المدفوعات الرمزية، والتحقق الرقمي من الهوية، والإقراض القائم على العقود الذكية. ومن خلال التعاون مع مراكز التكنولوجيا المالية الإقليمية والبيئات التنظيمية التجريبية، يُمكن للمصارف العربية تطوير منتجات التمويل اللامركزي (DeFi) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتبسيط المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول. وسيكون الإستثمار في سلسلة الكتل (blockchain finance) والتدريب من العوامل الاساسية في بناء الثقة وسهولة الاستخدام. ومع توجُّه دول الخليج نحو الإقتصادات الرقمية، فإن التبنّي المبكر للتمويل عبر سلسلة الكتل (onchain finance) سيضع المصارف العربية في مركز الصدارة في الإبتكار والمرونة والشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الدكتورة سهى معاد

العرب كـويـن .. هل نحلم بإصدار عملـة رقميـة عربيـة؟
« العرب كـويـن » .. هل نحلم بإصدار عملـة رقميـة عربيـة؟
محمــد علـي ثامـر
كاتب وباحث إقتصادي يمني
في عالمٍ مليء بالتناقضات والصـراعات في الإقتصاد العالمي، ونظراً إلى التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات التي لها تأثير كبير على النظام النقدي والمصـرفي، وعلى وجه الخصوص على قطاع المدفوعات وتحويل الأموال، من خلال تنظيم عمليات الدفع والتسوية المتطوّرة، والعملات الرقمية والإفتراضية؛ وهذه الأخيرة ظهرت أول عملةٍ افتراضيةٍ مُشفَّرة لها وهي البيتكوين ضمن موجة تلك التطورات والإبتكارات في عالم اليوم، تلاها ظهور العديد من العملات الإفتراضية الأخرى، حتى أصبحت معظم البنوك المركزية في العالم تُفكّر أو تعمل على إصدار عملات رقمية خاصة بها، تتمتع بالشـرعية القانونية، وتدعم ثقة المستهلك المالي، وتعتمد في تقديمها وتداولها على وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية خلافاً عن العملات الرقمية الإفتراضية التي لها جوانب مخاطر كثيرة وجمَّة… وطبعاً في منطقتنا العربية حيث لا يزال إستخدام العملات الرقمية محدوداً جداً، أو تكاد تظهر هنا أو هناك كمبادراتٍ فرديةٍ أو قُطرية في هذا المجال؛ ولكن كتوجُّهٍ عربي ربما الوقت لا يزال بعيداً جداً، نحو إصدار عملةٍ رقميةٍ عربية؛ فالواقع العربي كعادته لا هناك إتحاد عربي يجمع دوله وأقطاره، ولا هناك تكتل اقتصاديّ عربيّ واحد يعمل على إيجاد عملةٍ نقديةٍ واحدة، فما بالكم بعملةٍ رقميةٍ عربية؟!
العملات الرقمية.. وتاريخ من الظهور
يا تُرى ما هي العملات الرقمية؟! بل وما هي العملة الافتراضية المُشفَّرة؟! والإجابة على ذلك؛ تعتبر العملة الرقمية هي المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواءً العملات الإلكترونية (E-money)، أو العملات الإفتراضية (Virtual Currencies)، أو العملات الافتراضية المشفَّرة (Cryptocurrencies)، أو العملات الرقمية القانونية (Central Bank Digital Currencies) والتي تصدرها البنوك المركزية أو مؤسسات النقد، أو العملات الرقمية الثابتة أو المستقرة (Stablecoin)، وبعض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن إطلاقها على هذه العملات يبقى الطابع الرئيسـي لها أنها متاحةٌ بشكلٍ رقمي، وليس لها وجود ماديّ (فيزيائيّ) ملموس، رغم أن لها بعض الخصائص المماثلة للعملات القانونية المادية، وتعتمد هذه العملات على علم التشفير المُعقَّد والخوارزميات للتثبت من معاملاتها، وإصدار الوحدات الخاصة بها، كوسيلةٍ لإلغاء دور الجهات التنظيمية من حيث إصدار النقد ومراقبته وضبطه، وإلغاء دور المؤسسات المالية في الوساطة المالية لتحويل الأموال.
وتُعتبر عملة البيتكوين هي أولى العملات الإفتراضية المُشفَّرة، والأكثر شهرةً وإنتشاراً، والتي يعود تاريخها إلى العام 2008 نتيجة الورقة البيضاء التي نشـرها مبرمج أو فريق مجهول الهوية، ينتحل إسمٍ مستعار يُدعى «ساتوشـي ناكاموتو»، وقد بدأت عملية إصدار هذه العملة في كانون الثاني/يناير 2009، وفي العام 2010 بدأت أول تجارب التداول بها من خلال مستخدمي منتدى Bitcointalk، بغرض شـراء وجبة بيتزا مقابل عشـرة آلاف وحدة من عملة البيتكوين، وبقيمة 0,003 دولار مقابل كل وحدة، لتتوالى بعدها أسعار هذه العملة بالصعود التدريجي أو الإنهيار السـريع في تناقضٍ عجيبٍ وغريبٍ ومُريب في الوقت عينه.
ومنذ بداية العام 2011 بدأت عملات إفتراضية مُشفَّرة جديدة في الظهور منها: عملة التكوين – Altcoins، وهي عملة تفرع لعملة البيتكوين السابقة، تلاها إطلاق أول بورصة للبيتكوين بلغت قيمة الوحدة الواحدة منها (30) دولاراً تقريباً، وخلال الفترة (2014 – 2016) شهدت البنية التحتية للبيتكوين تحسناً مستمراً، لا سيما مع إفتتاح أول جهاز صـراف آلي (ATM) لها في مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر في إقليم بريتيش كولومبيا الكندي في 30 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، وتُعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي إعترفت رسمياً بالبيتكوين بأنها نوعٌ من النقود الإلكترونية المقبولة للتداول لديها.
وفي تشـرين الثاني/ من العام عينه، تمَّ إطلاق ثاني عملة إفتراضيةٍ مُشفَّرة في العالم هي لايت كوين – Litecoin، وتختصـر (LTC)، تلتها عملة الريبل (Ripple-XRP)، والتي أطلقت في العام 2012، وهدف منها أن تحل محل شبكة سويفت العالمية كمزود خدمات تراسلٍ ماليةٍ آمنة، أكثر منها عملةً افتراضية، أما رابع هذه العملات فهي عملة الإيثيريوم – Ethereum، ويرمز لها بـ «إيثر»، والتي تمَّ إطلاقها في العام 2015، وتدعم مجموعة من التطبيقات والأصول الرقمية المختلفة، وأصبحت تنافس البيتكوين أو تكاد تكون العملة الإفتراضية الثانية.. ليتجاوز عدد العملات الإفتراضية المُشفَّرة في العالم نحو (4,000) عملة مُشفَّرة متداولة بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار، ومن أبرز هذه العملات: الـ (مونيرو، دوج كوين، نوفا كوين، نيم كوين، بير كوين، فزر كوين، كاردانو، ستيلير، شين لينك، بينانس كوين، بلو كادوت) وغيرها، صادرة عنها وملتزمة بها قانونياً، وتعد نسخاً رقميةً عن النقود الأساسية الورقة والمعدنية التي تصدرها تلك البنوك، وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجةً أعلى من الأمان وليست متقلبةً بطبيعتها، على عكس العملات المُشفَّرة، وهذا النوع يعد وسيلةً لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق السياسة النقدية لهذه البنوك، وتهدف أيضاً إلى حوكمة حركة الأموال والسيطرة على أنظمة المدفوعات الرقمية المتزايدة ورفع كفاءتها وسـرعتها وتنافسيتها، وتتبع السجلات الإلكترونية، وتدفقات العملات… إلخ، كما أنها تجعل عملية الدفع المحلية أكثر صلابةً وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض، وزيادة كفاءة المدفوعات، وتخفيض تكاليف المعاملات، ومن شأن هذه العملات أيضاً أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات إستبدال العملة.
ويمكن تصنيفها إلى عملاتٍ رقمية مخصّصة لمعاملات التجزئة اليومية للأفراد والأعمال التجارية، وإلى عملاتٍ رقمية مخصصة لمعاملات الجملة ذات التردُّد المنخفض والمبالغ الكبيرة أو العابرة للحدود التي تجريها المؤسسات المالية، وهناك خطوات جريئة وملموسة نفّذتها بعض البنوك المركزية العالمية، وأبرزها: عملة «ليب كوين» أي عملة ليتوانيا الرقمية، وهي أول عملة مدعومة من الحكومة في منطقة اليورو في قارة أوروبا، والتي أعلن عنها في العام 2018، وفي ذاك العام عينه أطلقت فنزويلا عملةً رقمية باسم (البترو)، كما أطلقت سنغافورة عملتها الرقمية التي تستخدمها البنوك المحلية لتداول وتحويل الأموال مع بعضها البعض بدلاً من تصفية المدفوعات من خلال البنك المركزي السنغافوري.
كما صدر (الدولار الرملي أو ساند دولار SAND DOLLAR) كعملة رقمية في جزر البهاما، والذي ظهر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبعد عامٍ واحد؛ أي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية (E-NAIRA)، ومن ثم تمَّ تطوير اليوان الرقمي الصادر عن بنك الشعب الصيني – المصـرف المركزي للصين –، وعرضه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العام 2022، بينما لا زال مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي يناقش إطلاق الدولار الرقمي.
وللعلم هناك ما يُقارب من (100) عملة رقمية صادرة عن بنوكٍ مركزية تـمرُّ بمرحلة البحث أو التطوير، أبرزها (الين الياباني الرقمي، الفرنك السويسـري الرقمي، اليورو الرقمي (DIGITAL EURO))؛ لينشئ المنتدى الإقتصادي العالمي مجلساً عالمياً لحوكمة العملات الرقمية.
العملات الرقمية.. الهروب من المركزية
هل العملات الإفتراضية المشفَّرة هي البديل اللامركزي للنظام المصـرفي المركزي؟ وهل اللامركزية تجلب الحرية المالية؟! هذان السؤالان المثيران هما المغزى في الأول والأخير من إصدار عملةٍ رقميةٍ لا يتم التحكم بها من قبل المؤسسات المالية المركزية، وكواقع مثال؛ لاقت عملة البيتكوين إستحسان المتعاملين بها، لما توفره من مزايا عديدة مرتبطة بالدفع الفوري، وإلغاء المركزية والوساطة بين الأطراف ضمن منظومة عمليات الدفع والتحويل المالي وغيرها من المزايا؛ أي أنها عملة رقمية لا مركزية، من دون وجود بنكٍ مركزي يتحكم بها، ويُمكن إرسالها من شخصٍ إلى آخر عبر شبكة البيتكوين بطريقة الند للند، دون الحاجة إلى طرفٍ ثالثٍ وسيط كالبنوك، وإنما يتم التحقق من حوالاتها باستخدام التشفير، حيث تذهب النقود من حساب مستخدمٍ إلى آخر بشكلٍ فوري، ودون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف أو أي جهات وسيطة من أي نوعٍ كان؛ الأمر الذي أثار العديد من المخاوف من هذه العملة المُشفَّرة، ومن استشـراء التعامل بها؛ نظراً لكونها لا تصدر عن بنوكٍ مركزية، ولا يوجد لها أي غطاء قانوني، بل تعتبر مصادرها مجهولة أحياناً، وبالتالي لا تخضع للقانون.
أما ثاني تلك المخاوف هو تعرُّض أسواق الأصول الرقمية للعديد من الكوارث المزلزلة أبرزها، فقد القيمة السوقية لهذه العملات؛ فمثلاً تراجعت عملة البيتكوين وهي أكبر العملات المُشفَّرة من حيث حجم التعاملات وأوسعها انتشاراً على مستوى العالم في العام 2022 وفقدت أكثر من (70 %) من قيمتها، كما تعرَّضت عملات مُشفَّرة أخرى مثل: تيرا ولونا للانهيار الكامل في الفترة ذاتها، كما أن من ضمن هذه المخاوف أيضا تطور عمليات الاحتيال والاختراق لهذه العملات المُشفَّرة، أي ما تشبه الثقب الأسود، والذي تختفي بداخله الأموال.. وغيرها من المخاوف.
 تجارب دولية في إصدار عملة رقمية
تجارب دولية في إصدار عملة رقمية
وكحلٍّ وسيط بين مواصلة ركب التطور الحضاري في عالم النقد الإلكتروني وإستخدام العملات الرقمية المُشفَّرة، ولتلافي المخاوف منها، بدأت معظم البنوك المركزية في العالم بإصدار عملاتٍ رقمية (CBDCs)؛ وهي عملات صادرة عنها وملتزمة بها قانونياً، وتُعد نسخاً رقمية عن النقود الأساسية الورقية والمعدنية التي تصدرها تلك البنوك، وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المُشفَّرة، وهذا النوع يعد وسيلة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق السياسة النقدية لهذه البنوك، وتهدف أيضاً إلى حوكمة حركة الأموال والسيطرة على أنظمة المدفوعات الرقمية المتزايدة ورفع كفاءتها وسـرعتها وتنافسيتها، وتتبع السجلات الإلكترونية، وتدفقات العملات… إلخ، كما أنها تجعل عمليات الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض، وزيادة كفاءة المدفوعات، وتخفيض تكاليف المعاملات، ومن شأن هذه العملات أيضاً أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
ويُمكن تصنيفها إلى عملاتٍ رقمية مخصصة لمعاملات التجزئة اليومية للأفراد والأعمال التجارية، وإلى عملاتٍ رقمية مخصصة لمعاملات الجملة ذات التردد المنخفض والمبالغ الكبيرة أو العابرة للحدود التي تجريها المؤسسات المالية، وهناك خطوات جريئة وملموسة نفذتها بعض البنوك المركزية العالمية، وأبرزها: عملة (ليب كوين) أي عملة ليتوانيا الرقمية، وهي أول عملة مدعومة من الحكومة في منطقة اليورو في قارة أوروبا، والتي أعلن عنها في العام 2018، وفي ذاك العام عينه أطلقت فنزويلا عملةً رقمية باسم (البترو)، كما أطلقت سنغافورة عملتها الرقمية والتي تستخدمها البنوك المحلية لتداول وتحويل الأموال مع بعضها البعض بدلاً من تصفية المدفوعات من خلال البنك المركزي السنغافوري.
كما صدر (الدولار الرملي أو ساند دولار SAND DOLLAR) كعملة رقمية في جزر البهاما، والذي ظهر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبعد عامٍ واحد؛ أي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية (E-NAIRA)، ومن ثم تمَّ تطوير اليوان الرقمي الصادر عن بنك الشعب الصيني – المصـرف المركزي للصين –، وعرضه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجينغ في العام 2022، بينما لا يزال مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي يناقش إطلاق الدولار الرقمي.
وللعلم هناك ما يُقارب من (100) عملةً رقمية صادرة عن بنوكٍ مركزية تـمرّ بمرحلة البحث أو التطوير، أبرزها (الين الياباني الرقمي، الفرنك السويسـري الرقمي، اليورو الرقمي (DIGITAL EURO))؛ لينشئ المنتدى الاقتصادي العالمي مجلساً عالمياً لحوكمة العملات الرقمية، يضم أكثر من (40) بنكاً مركزياً ومنظماتٍ دولية، وباحثين أكاديميين ومؤسسات مالية، ويهدف هذا المجلس إلى تطوير إطارٍ عمليّ لاعتماد العملات الرقمية.
المبادرات العربية «الرقمية»
هناك العديد من المبادرات في مجال إصدار عملاتٍ رقمية، قُطرية أو غيرها؛ ولكن لا تزال في طور الإصدار التجريبي فقط، ولم تتحوّل إلى عملة قانونية (100 %)، كما أن إستخدامها في هذه المنطقة لا يزال محدوداً جداً، فمثلاً في يناير/ كانون الثاني 2019 نفَّذ البنك المركزي السعودي ومصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشـروع (عابر)، وهو أول عملة رقمية عربية، لا تنتمي للعملات الافتراضية المُشفَّرة، وذلك إختباراً لقابلية التشغيل البيني، ومنذ ذلك الوقت ولا تزال هذه العملة قيد التجريب، أو بالأحرى في مراحل التجربة الأولى؛ أي أنها لم تصدر بعد.. أما بقية الدول العربية فلا يزال العديد منها في طور البحث والدراسة لإصدار بنوكها المركزية لعملةٍ رقميةٍ خاصةٍ بها.
وقد يعود ذلك، نتيجة عدم توافر الدعم لتلك العملات من قبل البنوك المركزية والسلطات النقدية في هذه المنطقة؛ ولكن لا يزال هناك إمكانية لنموها في المستقبل القريب؛ مما يتطلّب من تلك البنوك السعي نحو مراقبة التطورات الحاصلة في هذه العملات من خلال عدسات متعددة التخصصات، والجمع بين تكنولوجيا المعلومات، وتحليل السياسات لدراسة آثارها المحتملة على سياسة المدفوعات والإشـراف والتنظيم، والسياسة النقدية، وتوفير الخدمات المالية، والاستقرار المالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه العملات وآثارها.
العرب كوين.. عملة رقمية عربية
يراهن العديد من الخبراء والإقتصاديين العالميين على أن العملات الرقمية هي عملة المستقبل، والعالم العربي أمام تحدياتٍ كبيرة في هذا المجال، والخيار أمامه هو أن يذهب العالم العربي إلى إصدار عملةٍ رقميةٍ عربية، مما قد يكون ممكناً لتحقيق التكامل الإقتصادي، الذي طالما كان يطمح إليه، ولعلّ إصدار عملةٍ رقمية تُسمَّى (العرب كوين) على غرار تلك العملات الرقمية العالمية، لما فيه تسهيل المدفوعات بين دول الوطن العربي وتوحيدها، ويتضمن ذلك أيضاً إطلاق تكتلٍ اقتصاديٍّ عربي يقوم على إنشاء هيئة نقدٍ عربيةٍ موحدة، تصدر عملةً نقديةً عربية؛ سواءً أكانت نقديةً ملموسة (ورقية ومعدنية)، أو رقميةً (مستقرة أو افتراضية مُشفَّرة)، فإذا لم نتحد في اتحادٍ عربي واحد على أرض الواقع فيجب علينا على أقل تقدير أن نتحد رقمياً، وهذا هو أدنى مراتب الإتحاد رغم إلتقائنا كثيراً في العديد من العناصـر الرئيسية كالموقع والتاريخ والدين واللُّغة، بل والمصير المشترك.

المصارف الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي: تحديات وفرص
المصارف الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي:
تحديات وفرص

من المبادئ الأساسية للمصارف الإسلامية، التالي:
1 – عدم الفائدة (الربا): جميع التعاملات خالية من الفائدة.
2 – المشاركة في الربح والخسارة: العقود تعتمد على شراكات، مثل المضاربة والمشاركة.
3 – الأنشطة الحلال: تجنُّب الإستثمار في الأنشطة المحرّمة، مثل الكحول والمقامرة واليانصيب.
4 – أهمية العقود الشرعية: كالمُرابحة، الإجارة والسَلَم.
ومن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية:
1 – إدارة وتحليل المخاطر: إستخدام الذكاء الإصطناعي لتقييم المخاطر المالية، بما يتماشى مع المعايير الشرعية.
2 – تحسين خدمة الزبائن: توفر الروبوتات الذكية خدمات إستشارية وفق الفتاوى الشرعية.
3 -الإمتثال الشرعي الآلي: تطبّق أدوات الذكاء الإصطناعي للتحقُّق من توافق المنتجات والخدمات مع الشريعة.
4 – التمويل الرقمي الإسلامي: تسهيل العمليات، مثل التمويل الجماعي الشرعي عبر المنصّات الرقمية.
ومن أبرز التحدّيات في تبنّي الذكاء الإصطناعي في مجال العمل المصرفي الاسلامي:
1 – التوافق الشرعي: ضمان توافق خوارزميات الذكاء الإصطناعي، مع المبادئ الشرعية.
2 – البنية التحتية التكنولوجية: الحاجة إلى إستثمارات كبيرة لتطوير أنظمة ذكاء إصطناعي متوافقة مع الشريعة.
3 – نقص الكفاءات: قلّة الخبراء الذين يجمعون بين المعرفة الشرعية والخبرة التقنية.
4 – الأمن السيبراني: حماية البيانات المالية والحفاظ على خصوصية الزبائن وعدم إنتهاك بياناتهم.
أما الفرص المستقبلية للمصارف الإسلامية، فهي:
1 -الابتكار في المنتجات المالية: تطوير منتجات جديدة، تواكب احتياجات العصر الرقمي مع الإلتزام بالشريعة.
2 – التوسُّع في الأسواق العالمية: إستخدام الذكاء الإصطناعي للوصول إلى جمهور أوسع في الأسواق غير الإسلامية.
3 – تعزيز الكفاءة التشغيلية: تقليل الكلف، وتحسين سرعة وكفاءة العمليات المصرفية.
4 – التعلُّم العميق والبيانات الضخمة: تحليل البيانات لفهم سلوكيات الزبائن، وتصميم حلول مبتكرة.
وأخيراً، المصارف الإسلامية أمام فرصة فريدة لتبنّي الذكاء الإصطناعي، مما يعزّز من قدرتها على المنافسة في السوق العالمية. ولتحقيق ذلك، يجب العمل على تجاوز التحدّيات المرتبطة بالتوافق الشرعي والبنية التحتية، والإستثمار في البحث والتطوير، مع التمسك بالمبادئ الإسلامية، مما يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في هذا القطاع.
أ.د. سعد العنزي
أستاذ إدارة الاعمال في جامعة بغداد- كلية الادارة والإقتصاد

هل سيستمر الشرق الأوسط صامداً في العام 2026؟
هل سيستمر الشرق الأوسط صامداً في العام 2026؟
بقلم الدكتور جهاد أزعور
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
يُذكر العام 2025 كعام حافل بالصدمات والصمود، عام إتسم بعدم اليقين، ولكنه أيضاً عام إزدهار التكنولوجيا والأداء القياسي. فعلى رغم إرتفاع الرسوم الجمركية، والتشرذم الجيوسياسي، وتزايد حالة عدم اليقين في السياسات، حافظت التجارة العالمية والنشاط الإقتصادي على إستقرارهما في الإقتصادات المتقدمة والناشئة. ولم تتحقق الضغوط التضخُّمية التي كان يخشى منها كثيرون، وظلّت الأسواق المالية مستقرّة إلى حدٍ كبير، بينما ساهم إزدهار التكنولوجيا في تحقيق أداء قياسي للأسواق.
لقد كانت قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود لافتة للنظر بشكل خاص. فبالإضافة إلى الرياح المعاكسة العالمية، واجه العديد من إقتصادات المنطقة صدمات داخلية حادة، تمثّلت في تصاعد الصراعات في الصيف الماضي، وعام آخر من الأحداث المناخية المتطرّفة، مثل الجفاف في شمال أفريقيا، وإستمرار التراجع عن حزم التحفيز المالي التي تم إعتمادها خلال فترة جائحة «كورونا». ومع ذلك، حافظ النمو على مستواه.
وتساعد عوامل عدة في تفسير هذه النتيجة، فقد قلّلت محدودية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة من التأثير المباشر للرسوم الجمركية المرتفعة. كما ساهم ارتفاع إنتاج النفط، عقب قرارات منظمة «أوبك+»، بإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بلغت 2.2 مليون برميل يومياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في دعم المصدّرين، في حين إستفاد المستوردون من إنخفاض أسعار الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، خفّفت التحويلات المالية المرتفعة، وتدفقات السياحة القوية، ومرونة الطلب المحلي من الأثر السلبي لهذه التحدّيات.
لكن هل سيستمر هذا الوضع؟ مع بداية العام 2026، يبقى السؤال الرئيس: هل كان من الممكن الحفاظ على هذه المرونة؟
ويبقى صندوق النقد الدولي متفائلاً بحذر، إذ يُتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى نحو 3.7 % في العام 2026 مقارنة بـ3.2 % في العام 2025، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، والطلب المحلي القوي، والإصلاحات المستمرة. لكن يجب التريّث في هذا التفاؤل، إذ إن هناك 5 مخاطر على الأقل تستدعي الإنتباه.
أولاً: آثار عدم اليقين نادراً ما تظهر في السياسات بشكل فوري، إذ يشير العديد من الأدلة التجريبية، بما في ذلك أبحاث صندوق النقد الدولي، إلى أن آثار عدم اليقين على الإستثمار، والتوظيف، والإستهلاك، غالباً ما تظهر بعد فترة طويلة. وإذا إستمر عدم اليقين العالمي، فإنه قد يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 5 % في حلول العام 2027.
وقد تكون بعض العوامل المؤقتة، مثل زيادة الواردات وتراكم المخزونات، قد أخفت التأثير الحقيقي في العام 2025، لكن مع تلاشي هذه التأثيرات قد يصبح تأثيرها السلبي على النشاط الإقتصادي العالمي وعلى إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر وضوحاً.
ثانياً: لقد شكّل ازدهار الذكاء الإصطناعي عاملاً موازناً قوياً لصدمات هذا العام، فقد أدّت التقييمات المرتفعة للأسهم وتدفقات الإستثمارات الكبيرة إلى القطاعات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي إلى دعم الثقة العالمية.
وقد إستثمر العديد من اقتصادات المنطقة، ولا سيما دول الخليج، بكثافة في تبنّي الذكاء الإصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مستفيدة من وفرة الأراضي، ورأس المال، والطاقة المتجدّدة الرخيصة نسبياً. ولكن تزايد المخاوف حيال الإفراط في التفاؤل يثير تساؤلات حول كيفية تأثير تصحيح السوق على المنطقة.
وثالثاً: في حين يُتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فإن الأوضاع المالية العالمية قد تشهد تشديداً غير متوقّع.
فمن المتوقع أن تظل إحتياجات التمويل الإجمالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستويات مرتفعة للغاية في العام 2026. ومع وصول الديون العامة في الإقتصادات المتقدّمة إلى مستويات قياسية جديدة، فإن العلاوات المرتفعة على الأجل الطويل قد تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة العالمية، وسيمثل تراجع تدفقات رأس المال اختباراً صعباً للدول التي لديها إحتياجات كبيرة لإعادة التمويل واحتياطيات محدودة.
رابعاً: تظل أسواق النفط سلاحاً ذا حدين، ففي العام 2025، دعمت ديناميكيات النفط كلاً من المصدّرين والمستوردين. وبالتطلُّع إلى المستقبل، فإن الأسعار قد ترتفع إذا كانت الطلبات على الوقود الأحفوري أقوى من المتوقع، أو إذا تسبّبت التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات.
وفي المقابل، سيؤدي أي إنخفاض حاد في الأسعار إلى الضغط على المصدرين، حتى مع توقعات بإنخفاض فوائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط. لذا، فإن إدارة التقلبات ستظل أمراً بالغ الأهمية.
وخامساً: تظل الجغرافيا السياسية تلقي بظلالها. ففي نهاية العام 2025، ظهرت علامات أولية على التقدُّم نحو السلام وإعادة الإعمار في بعض أجزاء المنطقة، بما في ذلك سوريا. لكن التعافي من النزاع يظل هشّاً ومعقّداً، وسيكون تعزيز السلام، وإعادة بناء المؤسسات، وضمان الدعم الخارجي المستمر، عوامل حاسمة لتحقيق تعافٍ مستدام.
وفي هذا السياق، ليس لدى صانعي السياسات خيار سوى إتباع نهج اقتصادي كلي حذر في العام 2026، إذ يُوفر الزخم الحالي نافذة لإعادة بناء الإحتياطات المالية والخارجية، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة. ويُعدّ تعزيز الأطر المالية ودعم مصداقية السياسات النقدية من أهم وسائل الحماية من الصدمات المستقبلية.
وعلى المدى المتوسط، تظل الإصلاحات الهيكلية أمراً لا غِنى عنه، وسيكون تسريع تنمية القطاع الخاص، والحدّ من هيمنة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع أنماط التجارة، عوامل أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل.
وسيتطلّب الإستعداد لعصر الذكاء الإصطناعي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واللوائح التنظيمية، ورأس المال البشري. كما أن الإصلاحات في سوق العمل، ولا سيما تلك التي تعالج البطالة بين الشباب، هي أمر عاجل بالقدر عينه.
لقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة إستثنائية، والتحدي الآن يكمن في تحويل الإستقرار قصير المدى إلى قوة دائمة. وإذا نجح صانعو السياسات في بناء الإحتياطات وتحديث الأطر السياسية، فقد يُذكر العام 2026 ليس بإعتباره عاماً آخر من المرونة فحسب، ولكن كنقطة تحوُّل.
(المصدر: جريدة الشرق الأوسط)

الذهب ومساراته المستقبلية في ظل إقتصاد عالمي متعدّد المخاطر
إحتياطات المصارف المركزية من الذهب تشهد تحوُّلاً بنيوياً يُعيد المعدن الأصفر إلى موقع متقدّم
الذهب ومساراته المستقبلية في ظل إقتصاد عالمي متعدّد المخاطر
سيبقى مرتبطاً بعمق التحوُّلات في النظام النقدي الدولي

وتعكس الأرقام المتوافرة هذا التحوّل بوضوح، فقد بلغ إجمالي الذهب المستخرج عالمياً أكثر من 212 ألف طن، فيما تحتفظ البنوك المركزية بما يقارب 18 % من هذا المخزون ضمن إحتياطاتها الرسمية، في دلالة على عودة الذهب إلى قلب إستراتيجيات إدارة الإحتياطات. كما سجّلت مشتريات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة مستويات تاريخية، تجاوزت في بعض الأعوام 1,000 طن سنوياً، بالتوازي مع تدفقات استثمارية قوية نحو الأدوات المالية المدعومة بالذهب، ما أضفى على موجة الصعود طابعاً بنيوياً لا ظرفياً.
التطور التاريخي لأسعار الذهب
لم يكن الصعود القياسي الذي شهده الذهب مع نهاية العام 2025 حدثاً منفصلاً عن مساره التاريخي، بل يُمثل تتويجاً لمسار طويل من التحوّلات النقدية والإقتصادية التي أعادت تشكيل دور الذهب في النظام المالي العالمي. فمنذ إنهيار نظام بريتون وودز مطلع سبعينيات القرن الماضي وفكّ الإرتباط الرسمي بين الذهب والدولار في العام 1971، إنتقل الذهب من كونه غطاءً نقدياً مباشراً للعملات إلى أصلٍ حرّ التسعير، يخضع لقوى السوق ويتفاعل مع دورات التضخُّم وأسعار الفائدة ومستويات المخاطر العالمية. وخلال سبعينيات القرن العشرين، شكّل الذهب ملاذاً رئيسياً في مواجهة موجات التضخُّم الحاد وصدمات أسعار الطاقة، مسجّلاً أولى موجات الصعود الكبرى في تاريخه الحديث. إلاّ أن مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي شهدت تراجعاً نسبياً في جاذبيته، مع صعود الدولار وتراجع معدلات التضخُّم وتزايد الثقة بالسياسات النقدية التقليدية، ما دفع العديد من البنوك المركزية آنذاك إلى تقليص حيازاتها من الذهب.
غير أن هذا الإتجاه بدأ بالإنعكاس تدريجياً مع مطلع الألفية الجديدة، وبلغ نقطة تحوّل حاسمة عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009، حين أعادت البنوك المركزية والمستثمرون تقييم مخاطر النظام المالي القائم على الديون، فقد أدت السياسات النقدية غير التقليدية، ولا سيما التيسير الكمي وأسعار الفائدة شبه الصفرية، إلى إحياء دور الذهب كأداة تحوّط من تآكل القيمة الحقيقية للعملات، ما دفع أسعاره إلى مستويات تاريخية جديدة آنذاك. وتعمّق هذا التحوُّل البنيوي بصورة أوضح منذ العام 2020 مع جائحة «كوفيد-19»، حيث ترافقت الصدمة الصحية مع توسّع نقدي ومالي غير مسبوق عالمياً، أعقبه تسارع في معدّلات التضخُّم وتشديد نقدي حاد في عاميّ 2022 و2023. وفي هذا السياق، لم يعد الذهب مجرّد أداة تحوّط ظرفية، بل تحوّل إلى مؤشّر على هشاشة التوازنات النقدية والمالية العالمية، مدعوماً بعودة قوية للبنوك المركزية كمشتر صاف للذهب، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة.
وعليه، فإن صعود الذهب إلى مستويات تفوق 4,000 دولار للأونصة في نهاية العام 2025 يُمكن قراءته بوصفه نتيجة تراكمية لمسار تاريخي طويل، تداخلت فيه الأزمات المالية، والتحوُّلات النقدية، وتغيّر سلوك البنوك المركزية، وصولاً إلى مرحلة بات فيها الذهب عنصراً محورياً في إعادة تشكيل الاحتياطات والسياسات التحوطية العالمية، وهو ما يمهّد للإنتقال إلى تحليل دور البنوك المركزية كأحد المحركات الأساسية لصعود الذهب في المرحلة الراهنة.
 العوامل المحرّكة لأسعار الذهب في المرحلة الراهنة
العوامل المحرّكة لأسعار الذهب في المرحلة الراهنة
تتحدّد حركة أسعار الذهب في المرحلة الراهنة عبر مزيجٍ متداخل من العوامل النقدية والإستثمارية والجيوسياسية، مع بروز مؤشرات كمية تؤكد تحوُّل جزء مهم من الطلب إلى طابع هيكلي لا دوري. فعلى مستوى التسعير، سجّل الذهب قمماً تاريخية متتالية، إذ أشار تتبع الأسواق إلى بلوغه 4,630 دولاراً للأونصة في منتصف يناير/كانون الثاني 2026، بعد مكاسب قوية خلال 2025 قدرت بنحو أكثر من 64 %، وبداية العام 2026 على إرتفاع يتجاوز 6 % خلال أيامه الأولى، في إنعكاس مباشر لطلب الملاذات الآمنة وتوقعات تيسير نقدي لاحقاً.
وفي قلب هذا المسار، يبرز الطلب الرسمي من البنوك المركزية كمحرّك رئيسي، فقد أضافت البنوك المركزية 1,045 طناً إلى إحتياطاتها في العام 2024، بعد 1,037 طناً في العام 2023، و1,082 طناً في العام 2022 وهو يُعتبر مستوى قياسياً، وهو نمط شراء يتجاوز 1,000 طن سنوياً لثلاث سنوات متتالية ويعزّز أرضية سعرية أعلى للذهب مقارنة بدورات سابقة. وعلى صعيد الطلب الكلي، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب في العام 2024 متضمّناً الإستثمار خارج البورصة 4,974 طناً بقيمة تقارب 382 مليار دولار، مع تسارع مشتريات البنوك المركزية في الربع الرابع إلى 333 طناً، ما يوضح أن الزخم كان واسع النطاق.
وضمن الإطار نفسه، عاد الطلب الإستثماري عبر الصناديق المدعومة بالذهب ليشكّل داعماً مهماً، حيث سُجلت في العام 2025 تدفقات قياسية إلى صناديق الذهب بلغت نحو 89 مليار دولار بحسب التقديرات، ما يعكس إنتقال جزء من المحافظ نحو التحوّط في بيئة تقلبات مرتفعة. أما من زاوية السياسة النقدية، فما زالت الفائدة الحقيقية ولا سيما عوائد السندات الأميركية «المحمية من التضخم» متغيّراً مفصلياً في تفسير جاذبية الذهب، إذ تُظهر البيانات التاريخية للعوائد الحقيقية أن تغيّر هذا المتغيّر يؤثر مباشرة في كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، حتى وإن بات تأثيره اليوم أقل حتمية بسبب صعود وزن العامل الجيوسياسي والطلب الرسمي. وأخيراً، تؤكد أرقام سوق لندن أن مسار القيَم القياسية ليس مقتصراً على عاميّ 2025 و2026، إذ سُجل في العام 2024 مستوى قياسي لسعر الذهب في مزاد جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) بلغ 2,788.54 دولاراً للأونصة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024، في حين بلغ متوسط سعر الذهب خلال العام نفسه نحو 2,386 دولاراً للأونصة. ويُظهر هذا الفارق بين الذروة السعرية والمتوسط السنوي أن مسار الإرتفاع لم يكن لحظياً أو مرتبطاً بحدث منفرد، بل نتج عن تراكم عوامل هيكلية متداخلة تجاوزت تأثير دورة أسعار الفائدة وحدها.
ورغم الأهمية التقليدية لأسعار الفائدة في تفسير تحركات الذهب، فإن المسار الصعودي الراهن يعكس تفاعل مجموعة أوسع من العوامل غير النقدية المباشرة، فقد تحوّل الطلب الرسمي من البنوك المركزية إلى محرك هيكلي للأسعار، مع تجاوز مشترياتها حاجز 1,000 طن سنوياً خلال الفترة 2022-2024، مقارنة بمتوسطات تاريخية أدنى بكثير، ما وفّر دعماً مستداماً للأسعار حتى في فترات تشديد الأوضاع النقدية. كما أسهم تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتنامي تسييس النظام المالي الدولي في تعزيز جاذبية الذهب كأصل محايد وغير مرتبط بمخاطر الطرف المقابل، لا سيما في ظل إتساع نطاق العقوبات المالية وإستخدام أدوات الدفع والإحتياطات لأغراض غير إقتصادية. وفي موازاة ذلك، أدّت الإختلالات المالية المتراكمة في الإقتصادات المتقدّمة وإرتفاع مستويات الدين العام إلى تآكل نسبي في الثقة طويلة الأجل بالعملات الإحتياطية التقليدية، ما دفع عدداً متزايداً من البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كأداة حفظ للقيمة. وإلى جانب الطلب الرسمي، ساهم الطلب الاستثماري عبر الأدوات المالية المدعومة بالذهب في رفع سيولة السوق وربط حركة الذهب بتقلبات المحافظ الإستثمارية العالمية، بينما عزّزت تقلُّبات أسعار الصرف في الإقتصادات الناشئة الطلب الفيزيائي على الذهب كوسيلة تحوّط من تراجع العملات المحلية.
ويؤكد هذا التداخل بين العوامل النقدية وغير النقدية أن موجة الصعود الحالية لا تمثّل إستجابة ظرفية لدورة فائدة بعينها، بل تعكس تحوُّلاً بنيوياً في موقع الذهب ضمن النظام المالي العالمي.
 إحتياطات المصارف المركزية من الذهب
إحتياطات المصارف المركزية من الذهب
شهدت إحتياطات المصارف المركزية من الذهب خلال السنوات الأخيرة تحوُّلاً بنيوياً أعاد الذهب إلى موقع متقدّم ضمن أدوات إدارة الإحتياطات الرسمية، بعد مرحلة طويلة من الإستقرار النسبي، فقد بلغت الحيازات الرسمية عالمياً نحو 35 ألف طن، أي ما يقارب 18 % من إجمالي الذهب المستخرج عالمياً، في دلالة واضحة على تنامي إدراك البنوك المركزية لأهمية الذهب كأصل سيادي يتمتع بخصائص فريدة، أبرزها انعدام مخاطر الطرف المقابل، والإستقلال عن السياسات النقدية للدول المُصدِرة للعملات الإحتياطية. ويعكس هذا التوجه العالمي تحوُّلاً في فلسفة إدارة الإحتياطات، حيث لم يعد الهدف محصوراً في تحقيق عائد مالي قصير الأجل، بل في تعزيز متانة الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ورفع قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. ويتم تنفيذ مشتريات الذهب عادة عبر السوق الفوري أو إتفاقيات مباشرة مع المنتجين، وبوتيرة مدروسة لتفادي التأثير الحاد على الأسعار، ما يعكس طابعاً إستراتيجياً طويل الأجل لهذه القرارات.
وعلى الصعيد العربي، تتسم إحتياطات المصارف المركزية من الذهب بتباين ملحوظ يعكس إختلاف الهياكل الإقتصادية والأنظمة النقدية بين الدول العربية. ففي الإقتصادات النفطية ذات الفوائض الخارجية المرتفعة، تميل البنوك المركزية إلى الإحتفاظ بجزء معتبر من إحتياطاتها على شكل أصول مالية سائلة، مع المحافظة على مستوى مستقر من الذهب كعنصر داعم للثقة والإستقرار طويل الأجل. وفي المقابل، تعتمد بعض الدول العربية ذات الموارد المحدودة أو المعرضة لتقلُّبات مالية ونقدية أكبر على الذهب كأداة تحوُّط سيادي لتعزيز مصداقية العملة الوطنية وتقليص الإنكشاف على العملات الأجنبية. وتبرز أهمية الذهب في السياق العربي بوصفه أداة توازن نقدي أكثر من كونه أداة إستثمارية، إذ يُسهم في دعم الثقة بالسياسات النقدية، وتحسين صورة الملاءة الخارجية، وتوفير هامش أمان إضافي في فترات الضغوط على أسعار الصرف أو الإحتياطات الأجنبية.
كما أن الإحتفاظ بالذهب يمنح المصارف المركزية العربية مرونة أكبر في إدارة الأزمات، ويحدّ من المخاطر المرتبطة بتقلُّبات الأسواق المالية العالمية أو بتسييس النظام المالي الدولي. ويشير هذا الواقع إلى أن مستقبل إحتياطات الذهب في المصارف المركزية العربية مرشح لأن يتأثر بدرجة كبيرة بالتطورات العالمية في إدارة الإحتياطيات، وبمدى تعمُّق إدراك صانعي السياسات النقدية لأهمية التنويع الحقيقي للأصول. وفي ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، يُتوقع أن يحتفظ الذهب بدور داعم وإن بدرجات متفاوتة في إستراتيجيات الإحتياطات العربية خلال المرحلة المقبلة.
وتُظهر بيانات إحتياطات الذهب الرسمية في الرسم البياني رقم 3، أن التركز العالمي لا يزال مرتفعاً لدى الإقتصادات المتقدمة، حيث تتصدر الولايات المتحدة القائمة بحوالي 8,133 طناً، أي أكثر من ضعفي مجموع حيازة أي دولة منفردة تليها، ثم ألمانيا (نحو 3,350 طناً)، تليها إيطاليا (نحو 2,452 طناً) ففرنسا (نحو 2,437 طناً)، ثم روسيا (نحو 2,333 طناً) والصين (نحو 2,290 طناً). ويستكمل نادي الكبار كلاً من سويسرا (نحو 1,040 طناً) والهند (نحو 878 طناً) واليابان (نحو 846 طناً)، وتركيا (نحو 641 طناً). وهكذا، فإن القسم الأكبر من الذهب الرسمي لا يزال متركّزاً في الولايات المتحدة وأوروبا، بما يعكس دور الذهب كأصل ثقة تاريخي في ميزانيات البنوك المركزية، وليس كأداة إستثمارية قصيرة الأجل.
وعلى المستوى العربي، تُظهر بيانات المجلس العالمي للذهب تركزاً نسبياً في عدد محدود من الدول، حيث تتصدّر السعودية بنحو 323 طناً، يليها لبنان بنحو 287 طناً، ثم الجزائر بحوالي 174 طناً، ثم العراق (حوالي 163 طناً) فليبيا (حوالي 147 طناً). ويعكس هذا التوزيع إختلاف نماذج إدارة الإحتياطات، فبعض الدول تعتمد الذهب كـدعامة للثقة والسيادة النقدية خصوصاً في الإقتصادات الأكثر تعرُّضاً للصدمات، بينما تميل دول أخرى لا سيما ذات الإحتياطات الأجنبية الكبيرة الى تفضيل الأصول السائلة بالعملات الأجنبية مع الإبقاء على الذهب كركيزة إستقرار طويلة الأجل. كما تُظهر مؤشّرات حديثة أن الدول العربية الخمس الأولى مجتمعةً (السعودية، لبنان، الجزائر، العراق، ليبيا) تمتلك قرابة 1,101 طن، ما يوضح أن الثقل العربي في الذهب الرسمي موجود لكنه أقل بكثير مقارنةً بالكتل الكبرى عالمياً، مما يجعل أي زيادة عربية في الذهب ذات أثر تحوّطي استراتيجي أكثر من كونها قادرة وحدها على إعادة تشكيل السوق العالمية.
 آفاق أسعار الذهب ومساراتها المحتملة
آفاق أسعار الذهب ومساراتها المحتملة
تدلّ المؤشرات الراهنة على أن أسعار الذهب مقبلة على مرحلة تتسم بتعدّد المسارات أكثر من وضوح الإتجاه الأحادي، حيث بات تسعير الذهب إنعكاساً لتوازن دقيق بين عوامل دورية قصيرة الأجل وأخرى هيكلية طويلة الأمد. ففي المدى القريب، سيظل مسار أسعار الفائدة الحقيقية وتوجُّهات السياسة النقدية العالمية عاملاً مؤثّراً في تحديد وتيرة التقلبات السعرية، إلاّ أن تأثيره مرجّح أن يبقى محكوماً بسقف محدود مقارنة بدورات سابقة، في ظل تغيُّر بنية الطلب العالمي على الذهب. وفي هذا الإطار، قد تشهد الأسعار فترات من التذبذب أو التصحيح المرحلي كلّما تحسّنت شهية المخاطرة أو ارتفعت العوائد الحقيقية، غير أن هذه الحركات يُحتمل أن تكون مؤقتة ولا تُغيُّر من الإتجاه العام طويل الأجل.
وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يستمر الطلب الرسمي من المصارف المركزية في لعب دور داعم للأسعار، مدفوعاً بإعتبارات تتجاوز الحسابات الإستثمارية البحتة نحو إعتبارات السيادة النقدية وإدارة المخاطر النظامية. كما أن إستمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد إستخدام الأدوات المالية في سياقات غير إقتصادية، يُعزّزان موقع الذهب كأصل «محايد» وغير مرتبط بمخاطر الطرف المقابل، ما يُوفر قاعدة دعم إضافية للأسعار حتى في بيئات نقدية أقل تيسيراً.
أما على المدى الأبعد، فإن مستقبل أسعار الذهب سيبقى مرتبطاً بعمق التحوُّلات في النظام النقدي الدولي ذاته، ولا سيما مدى قدرة العملات الإحتياطية التقليدية على الحفاظ على دورها الحالي في ظل تفاقم إختلالات الدين والعجوزات المالية. وفي حال إستمر هذا المسار، يُرجّح أن يتكرّس الذهب كمكوّن شبه دائم في إستراتيجيات إدارة الإحتياطات والمحافظ الإستثمارية، مع إنتقاله من أصل ملاذي ظرفي إلى عنصر هيكلي في منظومة الإستقرار المالي العالمي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

الذهب إلى إرتفاع في العام 2026
الأسباب تعود إلى التوترات الجيوسياسية والتضخُّم وإنخفاض الفوائد على الدولار
الذهب إلى إرتفاع في العام 2026
لم يعد السعي لإقتناء الذهب حكراً على السيدات، بإعتباره مصدراً للزينة والتباهي، ووسيلة «لتخبئة القرش الأبيض لليوم الأسود»، بل أيضاً أداة للإستثمار والربح لدى شريحة من المستثمرين حول العالم، خصوصاً مع عدم الإستقرار السياسي الحاصل في أكثر من منطقة، وبين العديد من البلدان، مما ينعكس تضخماً في الأسعار وتراجعاً في قيمة عملات أساسية وأولها الدولار.
في تفصيل سوق الذهب العالمي يبرز معطيان، الأول، إقبال كثيف على شراء الذهب من قبل مَن يملك الدولار من الأفراد والمستثمرين، والثاني تحوُّله إلى أداة أمان للمصارف المركزية، إذ شهد الذهب في العام 2025 أداءً إستثنائياً، وصفه تقرير توقعات الذهب لعام 2026، الصادر عن مجلس الذهب العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2025 بـ «الطفرة المدهشة». وقد حقَّق المعدن الأصفر عوائد تجاوزت 60 %، مسجّلاً ما يزيد على 50 رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق.
هذا الأداء القوي جاء مدعوماً بمزيج من العوامل التي رسّخت مكانة الذهب ملاذاً آمناً، أبرزها: تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإقتصادي، وضعف مستويات الدولار، بالإضافة إلى الزخم الإيجابي في الأسعار، وفق ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي. وشهد العام 2025 زيادةً ملحوظةً في مخصّصات الذهب، حيث كثّف كل من المستثمرين والبنوك المركزية عمليات الشراء؛ بحثاً عن التنويع والإستقرار.
طفرة العام 2025
بحسب الخبراء لم يكن الأداء القياسي للذهب في العام 2025 مجرّد صدفة، بل كان إنعكاساً لتوجُّهات إستثمارية عالمية، إذ دعمت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإقتصادي المتزايدة أداء الذهب بشكل قوي، كما أسهم تراجع الدولار في جعل الذهب أكثر جاذبيةً للمشترين من العملات الأخرى. وأظهر كل من المستثمرين والبنوك المركزية زيادةً واضحةً في مخصّصاتهم للذهب، حيث سعوا للحصول على التنويع والإستقرار في محافظهم الإستثمارية ضد تقلُّبات السوق.
ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن طلب القطاع الرسمي (البنوك المركزية) كان ولا يزال مساهماً كبيراً في أداء الذهب العالمي. ورغم أن البنوك المركزية تراجعت قليلاً عن مستويات الشراء القياسية التي سجَّلتها في السنوات الـ3 السابقة، فقد إستمرّت في العام 2025 بـ «موجة الشراء»، حيث بقي الطلب أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.
ويُظهر التحليل الذي أجراء مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تشتري بمستويات مرتفعة بشكل هيكلي :متوسط ما قبل «كوفيد» (2010 – 2019): كان الشراء الصافي في حدود 500 طن سنوياً. أما متوسط ما بعد «كوفيد» (2020 – 2024): فقد إرتفع بشكل حاد إلى نحو 800 طن سنوياً. وفي العام 2025 تُراوح التقديرات بين 750 و 900 طن، مما يمثل إستمراراً للزخم القوي.
سيناريوهات ثلاثة في العام 2026
يشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن النظرة المستقبلية للذهب في العام 2026، تتشكَّل بفعل إستمرار حالة عدم اليقين الجيوإقتصادي، ويُحدّد 3 سيناريوهات رئيسية محتملة يُمكن أن يتبعها سعر الذهب:
1 – الإنزلاق الضحل: مكاسب معتدلة
هذا السيناريو يُمثل توقعات أكثر إعتدالاً، حيث يُتوقع أن يشهد الذهب مكاسب متوسطة. علماً أنه يحدث ذلك إذا تباطأ النمو الإقتصادي العالمي وإستمرت معدّلات الفائدة في الانخفاض. في هذه البيئة، سيعمل إنخفاض الفوائد على تقليل جاذبية الأصول المدرة للعائد (مثل السندات)، مما يقلّل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويزيد من الطلب عليه بوصفه تحوطاً، دافعاً الأسعار للأعلى بشكل معتدل.
2 – الحلقة الكارثية: إندفاع قوي للأسعار
هذا هو السيناريو الأكثر تفاؤلاً لمشتري الذهب، ويتمثل في حدوث تراجع إقتصادي أكثر حدّة في العام 2026، يترافق مع تصاعد في المخاطر العالمية (سواء جيوسياسية أو مالية). في هذه الحالة، سيشهد الذهب أداءً قوياً جداً، حيث يتّجه المستثمرون والبنوك المركزية بتركيز أكبر نحو المعدن الأصفر ملاذاً أخيراً.
3 – العودة إلى التضخُّم: خطر التراجع
يُمثل هذا السيناريو الخطر الأكبر على أداء الذهب، ويتحقَّق إذا أدت السياسات الإقتصادية التي تنفذها إدارة ترمب إلى نتائج ناجحة بشكل غير متوقع. هذا النجاح سيعمل على تسريع النمو الإقتصادي وتقليل المخاطر الجيوسياسية. ستؤدي هذه البيئة إلى رفع معدّلات الفائدة وزيادة قوة الدولار، وهما عاملان تاريخيان يؤديان إلى تراجع أسعار الذهب. ويُظهر إستطلاع لـ «غولدمان ساكس» أن العديد من المستثمرين يعتقدون بأن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار في حلول نهاية العام 2026.
صورة إيجابية
في سياق متصل، رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في العام 2026 إلى 4450 دولاراً للأونصة في المتوسط من 4000 دولار، وفق وكالة «رويترز». ويشير البنك إلى إستقرار تدفقات المستثمرين والطلب المستمر من البنوك المركزية. وقد أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في العام 2027 عند 5150 دولاراً، قائلاً: إنه «يتأرجح بين عدم اليقين» بين سيناريوهات العمل المعتادة وإرتفاع الطلب الرسمي.
بينما حذر دويتشه بنك من أن المخاطر الرئيسية تشمل الإرتباط الإيجابي للذهب بالأصول الخطرة، وإحتمال تخفيف سياسة مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أقل مما تتوقّعه الأسواق في العام 2026، وإحتمال أن يبطئ مديرو الإحتياطي مشترياتهم.
في ميزان الخبراء، فإن الذهب شهد خلال العام 2025 موجة صعود لافتة، أعادت تسليط الضوء على إحتمالات بلوغه مستويات تاريخية في العام 2026، بدعم من مجموعة واسعة من المحرّكات الأساسية.
ويأتي في مقدّم هذه العوامل، تزايد إقبال البنوك المركزية حول العالم على شراء الذهب بهدف تنويع الإحتياطات بعيداً عن الدولار، ما يُعزّز الطلب الهيكلي على المعدن النفيس. كما تُسهم صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في رفع الطلب وتقليص المعروض القابل للتداول، مما ضاعف الضغوط الصعودية، كما أن تراجع الدولار وتنامي توقّعات خفض أسعار الفائدة الأميركية يزيدان من جاذبية الذهب كأداة تحوّط ضد التضخُّم وتقلُّبات العملات، في حين تدفع حالة عدم اليقين الإقتصادي والجيوسياسي، من الحروب وإرتفاع الديون السيادية إلى مخاطر الركود، المستثمرين نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي بات يُنظر إليه كأصل إستراتيجي طويل الأجل لا مجرّد ملاذ تقليدي.
الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان
إستمرار خفض الفوائد على الدولار سيرفع أسعار الذهب
يتوقع الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان على أن «يبقى المسار في العام 2026 تصاعدياً للذهب، لأسباب عدة، أولها أن المصارف المركزية في العالم لا تزال تشتري الذهب، بالوتيرة عينها التي إتبعتها في العام 2025 وتزيد في محافظها المعدن الأصفر، مما يؤدي إلى زيادة أسعاره»، لافتاً إلى أن «البنك الفدرالي في الولايات المتحدة يخفّض فوائده تباعاً، وهذا مؤشر على زيادة الطلب على شراء الذهب، لأن كلفة شرائه وتخزينه تصبح أقل، بالإضافة إلى أنه لم تحصل سيطرة كاملة على التضخُّم عالمياً، ونحن نعلم أن أهم وسيلة إحتياطية للتضخُّم هو اللجوء إلى شراء الذهب، وهذا يعني أن المعدن الأصفر سيكون الطلب عليه أكثر بكثير من العرض».
ويختم أبو سليمان قائلاً: «التوترات الجيوسياسية لا تزال موجودة، والحرب التجارية والرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب لم تنته، وهي موجودة، بدليل أن الصين تقوم بإرسال مؤشّرات الى الولايات المتحدة، بأنها تتخلى عن الدولار من خلال تحويلها العملات الصعبة التي تمتلكها الى شراء الذهب، ما يعني أن أسعار الذهب ستبقى في مسار تصاعدي».
 الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة
الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة
التوترات الجيوسياسية سترفع أسعار الذهب
من جهته، يشدّد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن «التوقعات صعبة، لكن في حال بقيت سياسات الولايات المتحدة على حالها تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط، والتصعيد الحاصل سياسياً وعسكرياً، فهذا يعني أن المعدن الاصفر سيبقى الملاذ الآمن»، معتبراً «أن الذهب سعره عالمي ويتأثر بالأحداث السياسية التي تجري، والجميع يعلم أن هناك مشكلة أساسية بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاه نظرتها إلى أوكرانيا، وهذا الإختلاف سيؤدي إلى تطوُّرات وتحدّيات، وتغيُّر في موازنات الدول، وتخبُّط وإرتفاع مستمر في أسعار الذهب».
ويختم د. حبيقة قائلاً: «إن إنخفاض سعر المعدن الأصفر غير متوقع، وبقاءه على حاله ممكن، لكن صعود أسعاره ممكن أكثر».
 الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين
الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين
7 أسباب لإرتفاع أسعار الذهب 2026
يجيب الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين، على سؤال: لماذا يُتوقع إرتفاع أسعار الذهب في العام 2026 قائلاً:
«ثمّة سيناريوهات دولية عدة ترسم هذا المسار، أولُها خفض الفائدة بشكل كبير، ما يُضعف الدولار ويزيد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ثانيها عودة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة رغم التجميد المؤقت، فيما التوقعات تشير إلى جولة جديدة من الحرب التجارية في العام 2026، وثالثها تجدُّد الأزمات الإقتصادية في أوروبا، إذ تعاني بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا ركوداً حاداً يُضعف الثقة بالإقتصاد الأوروبي، ورابعها تباطؤ النمو العالمي، فالنمو المتوقع لا يتجاوز 3 % في العام 2026، ما يضغط على الأسواق ويُعزّز اللجوء إلى الذهب، وخامسها أزمة الديون والفوائد في الولايات المتحدة، فالدين العام المتصاعد وكلفة الفوائد المرتفعة يخلّفان مخاطر مالية واسعة، وسادسها الأزمة العقارية في الصين، إذ إن إستمرار الإنكماش العقاري وتباطؤ النمو إلى 5.8 % يضغط على الأسواق الآسيوية، وسابعها زيادة الطلب على الذهب من دول البريكس، المصارف المركزية، وصناديق الإستثمار الكبرى في ظل التحوُّط من المخاطر».
الخبير الإقتصادي ميشال قزح
التضخُّم من أسباب رفع أسعار الذهب في العام 2026
يشرح الخبير الإقتصادي ميشال قزح أن «إستمرار معدّلات التضخُّم في الولايات المتحدة بالإرتفاع، وتغطية العجز بطباعة الدولارات، وفي ظل إزدياد الكتل النقدية من 4 تريليونات دولار في العام 2020، إلى 22 تريليوناً في العام 2025، فإن هذا التضخُّم سيُترجم بإرتفاع أسعار الذهب عالمياً، لأنه إنعكاس لزيادة طباعة الدولارات»، موضحاً أن «إنخفاض أسعار النفط ليست مؤشّراً على إنخفاض أسعار الذهب في العام 2026، لأن المستثمرين والمصارف المركزية مستمرون في شراء الذهب، لأنهم يعرفون حجم عمليات طباعة الدولار، وهذا الإتجاه سيبقى مستمراً في العام 2026. ويُرجّح أن يُلامس سعر الأونصة 5000 آلاف دولار، في حين أن أسعار الفضة ستتجه صعوداً أيضا، إلى ما يزيد عن 75 دولاراً، لأن العرض أقل من الطلب، والذي تحتاجه الصناعات في العالم».
باسمة عطوي

الدور المتنامي للإعلام الاجتماعي في تشكيل القناعات والسلوكيات
بين السلوك الإجرامي والتثقيف
الدور المتنامي للإعلام الاجتماعي في تشكيل القناعات والسلوكيات
يُؤثر في الإنتقال من المقاربات العلاجية اللاحقة إلى إستراتيجيات وقائية إستباقية

وفي هذا الإطار، يبرز التثقيف كعنصر حاسم في فهم السلوك الإجرامي والحدّ من مخاطره، ليس بوصفه نشاطاً توعوياً عاماً، بل كأداة وقائية تُسهم في تعزيز المناعة النفسية والسلوكية لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فضعفُ الوعي، وسوءُ تقدير المخاطر، وتأثيرُ الخطاب الإعلامي غير المنضبط، عوامل تفتح المجال أمام أنماط جديدة من الإستغلال والتلاعب، وتُعيد إنتاج السلوك الإجرامي بصيغ أكثر تعقيداً وأقل قابلية للإكتشاف المبكر.
العوامل النفسية المؤثرة في تشكّل السلوك الإجرامي
يتأثر السلوك الإجرامي بجملة من العوامل النفسية التي تُسهم في الإنتقال التدريجي من الإلتزام بالقواعد إلى خرقها، حيث تلعب آليات التبرير الذاتي دوراً محورياً في خفض الحواجز الأخلاقية لدى الأفراد، ولا سيما في البيئات التي تتسم بضعف الرقابة أو غموض المسؤوليات. فالإحساس بضعف إحتمالات الإكتشاف، إلى جانب النزعة إلى تعظيم المنفعة قصيرة الأجل، يدفع بعض الأفراد إلى إعادة تعريف السلوك المخالف بوصفه تصرفاً مقبولاً أو أقل ضرراً، خصوصاً عندما يكون الضرر غير مباشر أو مؤجّل الظهور. كما يُسهم الضغط المهني والإجتماعي، والرغبة في تحقيق مكانة أو مكاسب سريعة، في تعزيز قابلية الإنخراط في سلوكيات إجرامية، لا سيما عندما تغيب الثقافة المؤسسية الرادعة أو تُرسخ نماذج سلوكية تضفي طابعاً اعتيادياً على المخالفات الصغيرة. ويزداد هذا التأثير في السياقات الرقمية، حيث يُؤدي البُعد النفسي الناتج عن التفاعل غير المباشر إلى إضعاف الشعور بالمسؤولية، ويُسهل ممارسة الخداع أو التلاعب دون إدراك فوري لعواقبه القانونية أو الاجتماعية، ما يجعل العوامل النفسية عنصراً أساسياً في فهم أنماط الجريمة الحديثة وسبل الوقاية منها.
دور الإعلام الإجتماعي في نشر المعلومات وتشكيل السلوك الإجرامي
أدّى التوسُّع المتسارع في إستخدام منصّات الإعلام الإجتماعي إلى إعادة تشكيل بيئة تداول المعلومات، بحيث لم تعد هذه المنصّات مجرّد وسيلة تواصل، بل تحوّلت إلى فضاء مؤثر في تشكيل القناعات والسلوكيات، بما في ذلك السلوك الإجرامي. فسهولة إنتاج المحتوى وسرعة إنتشاره، مقرونتان بضعف آليات التحقُّق، أوجدتا بيئة خصبة لإنتشار المعلومات المضلّلة والخطابات التي تُطبع المخالفات أو تبرّرها، سواء بصورة مباشرة عبر الترويج لأساليب الإحتيال والإستغلال، أو بصورة غير مباشرة من خلال سرديات تمجّد التحايل وتُقلّل من خطورة العواقب القانونية. كما تُسهم خوارزميات تعزيز التفاعل في إبراز المحتوى الصادم أو الجاذب على حساب الدقة والموثوقية، ما يُؤدي إلى تضخيم أنماط سلوكية منحرفة وتوسيع دائرة تقبّلها إجتماعياً. وفي السياق ذاته، أصبحت هذه المنصّات أداة فعّالة في إستهداف الأفراد ذوي الوعي المحدود أو القابلية النفسية العالية للتأثر، عبر أساليب الهندسة الإجتماعية التي تستثمر في الثقة، وفي العاطفة، وفي ضغط الجماعة، مما يُعزّز إحتمالات الوقوع في الجريمة أو التحوُّل إلى ضحية لها. وبذلك، يغدو الإعلام الإجتماعي عاملاً مضاعفاً للمخاطر، يُسرّع إنتشار السلوك الإجرامي ويعقّد جهود المكافحة، ما لم يُقابل بإدارة معلوماتية رشيدة وتثقيف منهجي قادر على تحصين الأفراد والمؤسسات من تأثيراته السلبية.
دور التثقيف والوعي في الوقاية من السلوك الإجرامي
يُشكّل التثقيف والوعي أحد المرتكزات الأساسية للوقاية من السلوك الإجرامي، بوصفهما أدوات إستباقية تعالج جذور المشكلة قبل تحوّلها إلى ممارسات مخالفة أو جرائم مكتملة الأركان. فرفع مستوى الوعي بالمخاطر القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز الفهم النقدي للمعلومات المتداولة، يُسهمان في إعادة ضبط السلوك الفردي والجماعي ويُحدّان من قابلية الإنخراط في أنماط منحرفة أو الوقوع ضحية لها. كما يؤدي التثقيف المنهجي إلى تقوية ما يُمكن تسميته بالمناعة السلوكية، من خلال تمكين الأفراد من التعرف المبكّر على أساليب الخداع والتلاعب، وفهم آليات التأثير النفسي التي تستغلها الجرائم الحديثة، ولا سيما في البيئات الرقمية. وعلى المستوى المؤسسي، يُعد دمج برامج التوعية ضمن السياسات التنظيمية والحوكمة أداة فاعلة لتقليص مناطق الرمادية السلوكية وتعزيز ثقافة الإمتثال والمسؤولية، بما يحد من إحتمالات التواطؤ أو التساهل مع المخالفات. وفي ظل الدور المتنامي للإعلام الإجتماعي، تكتسب مبادرات التثقيف أهمية مضاعفة بإعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة المعلومات المضللة وتطبيع السلوك الإجرامي، حيث يُساهم الوعي في تحويل الأفراد من متلقين سلبيين إلى فاعلين قادرين على التمييز والتحقق، بما يُعزّز الوقاية المستدامة ويخفف الأعباء اللاحقة على منظومات العدالة والرقابة.
في الخلاصة، تُظهر هذه الدراسة أن السلوك الإجرامي لم يعد نتاج عامل منفرد أو إنحراف فردي معزول، بل هو حصيلة تفاعل معقّد بين دوافع نفسية، وبيئة معلوماتية متسارعة، ومستويات متفاوتة من الوعي والتثقيف. وفي ظل الدور المتنامي للإعلام الإجتماعي في تشكيل القناعات والسلوكيات، تتزايد أهمية الإنتقال من المقاربات العلاجية اللاحقة إلى إستراتيجيات وقائية إستباقية تُعلي من شأن التثقيف المنهجي وتعزيز الوعي النقدي. فكلّما إرتفعت قدرة الأفراد والمؤسسات على فهم آليات التأثير والتلاعب، تقلّصت المساحات التي ينفذ منها السلوك الإجرامي، وتراجعت فرص إنتشاره وتطبيعه إجتماعياً. وعليه، يصبح الإستثمار في التثقيف والوعي خياراً إستراتيجياً لا يقل أهمية عن الأطر القانونية أو الأدوات التقنية، بإعتباره مساراً مستداماً للحد من الجريمة وتعزيز السلوك المسؤول وترسيخ بيئة أكثر أمناً وإستقراراً على المستويين المجتمعي والمؤسسي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

أنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال لم تعد وظيفة رقابية مساندة
تشكل أحد المرتكزات الإستراتيجية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات الكبيرة
أنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال لم تعد وظيفة رقابية مساندة
بل منظومة إستباقية متكاملة تجمع بين إدارة المخاطر وتحليل البيانات
تُواجه الشركات الكبيرة في المرحلة الراهنة تصاعداً ملحوظاً في مخاطر الإحتيال نتيجة تعقّد الهياكل التشغيلية، وتوسُّع الأعمال العابرة للحدود، وتسارع التحوُّل الرقمي وتكامل الأنظمة. ولم يعد الإحتيال يقتصر على ممارسات فردية معزولة، بل أصبح يستند إلى أساليب منظمة تستغل حجم العمليات، وتعدد الأطراف المتعاملة، والثغرات التقنية والإجرائية في بيئات الأعمال المعقدة. وقد برزت أنظمة الامتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال كأحد المحاور الأساسية لحوكمة الشركات الكبيرة، إذ إنتقلت من دور رقابي تقليدي إلى منظومة إستباقية متكاملة، تجمع بين إدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والتقنيات الذكية، بهدف الحدّ من الخسائر وتعزيز النزاهة التشغيلية وحماية السمعة المؤسسية.
 أنظمة الإمتثال الحديثة ودوافع تبنّيها
أنظمة الإمتثال الحديثة ودوافع تبنّيها
تُعدُّ أنظمة الامتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال جزءاً أساسياً من البنية المؤسسية التي تهدف إلى الوقاية والإستباق بدلاً من الإكتفاء بالكشف بعد وقوع الخسائر، وهي ترتكز على فهم شامل لمخاطر الإحتيال في الشركات الكبيرة، وإعادة تصميم الضوابط التشغيلية والتقنية لتقليل التعرُّض للمخاطر المالية والتشغيلية والسمعة المؤسساتية. وتشير الإحصاءات العالمية إلى إتساع حجم مشكلة الإحتيال على مستوى الشركات والصناعات المختلفة، ما يُعزّز الحاجة إلى أنظمة إمتثال أكثر فاعلية. فبحسب أحدث التقديرات، تقدّر خسائر الشركات حول العالم من الإحتيال بنحو 7.7 % من إيراداتها السنوية في المتوسط، وهو ما يُترجم إلى مئات مليارات الدولارات من الخسائر سنوياً على مستوى الإقتصاد العالمي. كما أظهرت دراسات عالمية أن 41 % من الشركات العالمية تعرّضت للإحتيال خلال العامين الماضيين، مما يعكس إنتشار هذا التهديد في بيئات الأعمال المختلفة.
من ناحية أخرى، أشارت مؤسسات بحثية إلى أن شركات كبرى متعدّدة الجنسيات، خصوصاً تلك التي يزيد دخلها على 10 مليار دولار، تواجه مخاطر إحتيال عالية، حيث أبلغ 52 % منها عن تجربة إحتيال في آخر 24 شهراً. وفي سياق الإنفاق على أدوات وتقنيات مكافحة الاحتيال، يُتوقع أن يشهد سوق حلول كشف ومنع الإحتيال نمواً قوياً على مدى السنوات المقبلة، مع إرتفاع إستثمارات الشركات في أدوات تحليل البيانات والذكاء الإصطناعي لمواجهة التهديدات المتغيّرة.
كل هذه المؤشرات تسلّط الضوء على العبء المتزايد للإحتيال وتزايد تعقيده، وهي دوافع مركزية تجعل أنظمة الإمتثال الحديثة عنصراً لا غنى عنه في حماية الشركات الكبيرة. فالنهجُ التقليدي الذي يعتمد على المراجعة اللاحقة وحده لم يعد كافياً للتعامل مع سيناريوهات الإحتيال المعقّدة والمتشابكة، مما يستدعي تبنّي آليات متكاملة للوقاية والكشف والإستجابة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية والحوكمة المؤسسية المتقدّمة.
المكوّنات الأساسية لأنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال
في الشركات الكبيرة، يقوم الإمتثال الحديث لمكافحة الإحتيال على منظومة متكاملة من العناصر التقنية والتنظيمية التي تعمل بتناسق لتعظيم الكشف المبكر عن المخاطر وتقليل الخسائر، وتحسين جودة الإستجابة والتحقيق. يُمكن تلخيص المكوّنات الأساسية لهذه الأنظمة كالتالي:
- حوكمة المخاطر والضوابط المؤسسية: إذ يبدأ الإمتثال من مستوى الحوكمة، حيث تحدّد سياسات واضحة للمخاطر، وصلاحيات محدّدة، وأدوار ومسؤوليات لكل مستوى إداري، ويتضمّن ذلك فصل المهام وتحديث سياسات مكافحة الإحتيال بإنتظام لضمان إلتزام الوحدات التشغيلية بالقواعد المؤسسية والإجراءات الرقابية.
- تحليل البيانات الضخمة والتحليلات المتقدّمة: تشكل البيانات جزءاً جوهرياً في أنظمة الإمتثال الحديثة، إذ تسمح بتحليل كميات ضخمة من المعاملات والسلوكيات لتحديد الأنماط غير الطبيعية والمؤشرات المبكرة للإحتيال بإستخدام تقنيات مثل التحليلات الإحصائية، وإكتشاف الشذوذ، والتعلّم الآلي. هذه القدرات تُحسّن دقة الكشف وتقلّص معدّلات الإنذارات الكاذبة مقارنة بأساليب التدقيق التقليدية.
- نماذج الكشف الذكية: تعمل الأنظمة الحديثة بمزيج من القواعد المعرفة مسبقاً ونماذج الذكاء الإصطناعي والتعلُّم الآلي، ما يُمكنها من التعرّف على سلوكيات إحتيالية معقّدة تتجاوز قدرات القواعد الثابتة وحدها. التعلُّم الآلي يُمكن أن يتكيّف مع تغيُّرات الأنماط الإحتيالية ويكون قاعدة معرفية تتوسّع بإستمرار مع زيادة البيانات المتاحة.
- مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي: تقوم أنظمة إمتثال متقدّمة بمراقبة المعاملات عند تنفيذها لتحليلها فوراً مقابل نماذج السلوكيات المتوقعة. هذا يتيح إكتشاف العمليات المشبوهة قبل إتمامها وإيقافها في الوقت الفعلي، بدلاً من الإعتماد على مراجعات لاحقة فقط.
- إدارة القضايا والتحقيق: عند إكتشاف نشاط مشبوه، تنتقل الحالة إلى طبقة إدارة القضايا التي تتيح توثيق التحقيقات، تسجيل الأدلة، تتبع الإجراءات، والتنسيق بين الفارق (الإمتثال، التدقيق الداخلي، القانوني). تُعد هذه المكونات ضرورية لإتمام التحقيقات بفاعلية وتقديم تقارير إمتثال دقيقة للجهات الرقابية.
- التحليل الشبكي وتحديد العلاقات المخفية: تعتمد بعض الحلول المتقدّمة على تحليل الشبكات لتحديد العلاقات بين كيانات متعددة (حسابات، موردين، معاملات) لكشف عمليات تواطؤ إحتيالية أو أنماط معقّدة لا تظهر في التحليل التقليدي.
- إمتثال تنظيمي وتكامل مع معايير: تتكامل أنظمة الامتثال الحديثة مع متطلّبات «إعرف عميلك» (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لضمان الإمتثال التشريعي الشامل وتقليل مخاطر الإحتيال عبر الحدود، وهو أمر مهم بشكل خاص في الشركات متعدّدة الجنسيات.
في الخلاصة، تُظهر المعطيات والتحليلات أن أنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال لم تعد وظيفة رقابية مساندة، بل أصبحت أحد المرتكزات الإستراتيجية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات الكبيرة. فمع تصاعد تعقيد أنماط الإحتيال وتسارع الإبتكار الرقمي، باتت فعّالية الإمتثال تُقاس بقدرته على الإستباق والكشف المبكر، وجودة القرارات، وليس فقط بعدد المخالفات المكتشفة بعد وقوعها. وعلى المدى الإستشرافي، يُتوقع أن تتّجه الشركات الكبيرة نحو نماذج إمتثال أكثر تكاملاً وذكاءً، تعتمد على توحيد البيانات، والتحليلات المتقدمة، والذكاء الإصطناعي القابل للتفسير، إلى جانب تعزيز دور إدارة القضايا وتحليل الأسباب الجذرية في منع تكرار المخاطر. كما سيزداد التركيز على الإمتثال الوقائي المدمج في العمليات التشغيلية اليومية، بدل عزله ضمن وحدات رقابية منفصلة. وفي هذا السياق، تمثل قدرة الشركات على الإستثمار في أنظمة إمتثال مرنة وقابلة للتطور عاملاً حاسماً في حماية الإستدامة المالية، وتعزيز الثقة المؤسسية، والحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة أعمال تتسم بإرتفاع المخاطر وتسارع التغيُّرات.

الذكاء الإصطناعي يُعزز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي
المصارف العربية تحتاج إلى تبنّي مقاربة إستراتيجية متدرّجة لتوظيف التقنيات المستجدة
الذكاء الإصطناعي يُعزز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي
أدّى التوسُّع المتسارع في التحوُّل الرقمي داخل القطاع المالي والمصرفي إلى تعقيد بيئة المخاطر المالية، حيث ترافقت زيادة الإعتماد على القنوات الرقمية والمعاملات «غير الحضورية» مع تصاعد ملحوظ في حجم وتنوُّع عمليات الإحتيال المالي. ويشير تقرير Global State of Scams Report 2025 إلى أن الخسائر المالية التي تكبّدها المستهلكون عالمياً نتيجة عمليات الإحتيال بلغت نحو 442 مليار دولار سنوياً، ما يعكس محدودية فعّالية الأساليب التقليدية في مواجهة أنماط إحتيال ديناميكية وسريعة التكيُّف. وفي هذا السياق، برز الذكاء الإصطناعي كأداة محورية لتعزيز فعّالية أنظمة مكافحة الاحتيال المالي، من خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة وفهم السلوك المالي ورصد المعاملات غير الإعتيادية في الزمن الحقيقي. وقد أسهم توظيف تقنيات التعلم الآلي والتحليل السلوكي في الإنتقال من نماذج رقابية قائمة على الإكتشاف اللاحق إلى مقاربات وقائية وإستباقية، بما يدعم كفاءة الرقابة المالية، ويحد من الخسائر، ويُعزّز متطلّبات الإمتثال في المؤسسات المالية والمصرفية.
 محدودية أنظمة مكافحة الإحتيال التقليدية والحاجة إلى التحوّل نحو النماذج الذكية
محدودية أنظمة مكافحة الإحتيال التقليدية والحاجة إلى التحوّل نحو النماذج الذكية
تعتمد أنظمة مكافحة الإحتيال التقليدية في المؤسسات المالية على نماذج رقابية قائمة على القواعد الثابتة والمؤشرات التاريخية، ما يحدّ من فعّاليتها في بيئة مالية رقمية تتسم بالتعقيد وتسارع الإبتكار في الأساليب الاحتيالية. وقد أظهرت التطوُّرات الأخيرة أن هذا النمط من الأنظمة يعاني من قصور واضح في التعامل مع أنماط إحتيال ديناميكية وسريعة التكيُّف، مما ينعكس في إرتفاع معدّلات الكشف اللاحق وكثرة الإنذارات الخاطئة وزيادة الخسائر المالية.
وتؤكد المؤشرات الدولية حجم هذا التحدي، إذ تشير بيانات Global Anti-Scam Alliance إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الإحتيال بلغت نحو 442 مليار دولار سنوياً على مستوى المستهلكين عالمياً، في ظل توسّع القنوات الرقمية والمعاملات عبر الانترنت. كما أظهرت تلك البيانات أن 57 % من البالغين حول العالم قد تعرّضوا لعملية إحتيال واحدة على الأقل خلال عام واحد، رغم إعتقاد 73 % منهم بقدرتهم على التعرُّف على الإحتيال، ما يعكس فجوة جوهرية بين الوعي والقدرة الفعلية على الوقاية بإستخدام الأدوات التقليدية.
في المقابل، تدعم البيانات التحوُّل المتزايد نحو النماذج الذكية، حيث تشير تقارير متخصّصة في الجرائم المالية إلى أن نحو 90 % من المؤسسات المالية باتت تعتمد تقنيات الذكاء الإصطناعي في أنظمة مكافحة الإحتيال. وقد أسهم هذا التحوُّل في خفض الخسائر الناتجة عن الإحتيال بنسبة تراوحت ما بين 40 % و60 % لدى عدد كبير من المؤسسات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بالوتيرة نفسها تقريباً من خلال تقليل الإنذارات الخاطئة وتسريع عملية إتخاذ القرار.
وبناءً عليه، لم يعد تعزيز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي ممكناً عبر تطوير القواعد الرقابية التقليدية فحسب، بل بات مرتبطاً بقدرة المؤسسات المالية على تبنّي نماذج ذكية قائمة على الذكاء الإصطناعي، وقادرة على تحليل السلوك المالي وفهم نيّة المعاملات، والعمل في الزمن الحقيقي، بما يتيح الإنتقال من الرقابة التفاعلية إلى المقاربة الإستباقية القائمة على المخاطر.
تطبيقات الذكاء الإصطناعي عملياً في تعزيز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي
أتاح توظيف الذكاء الإصطناعي في المؤسسات المالية نقلة عملية في آليات مكافحة الإحتيال المالي، من خلال الإنتقال من نماذج رقابية عامة إلى تطبيقات ذكية متخصّصة تعمل في الزمن الحقيقي (Real time). وتتمثّل أبرز هذه التطبيقات في التحليل السلوكي للمعاملات المالية، حيث تُستخدم خوارزميات التعلُّم الآلي لبناء ملفات سلوكية ديناميكية للعملاء، تُمكن من رصد الانحرافات غير الاعتيادية عن أنماط الاستخدام الطبيعية، حتى وإن بدت المعاملة صحيحة من الناحية الشكلية. ويُسهم هذا النهج في تحسين القدرة على التمييز بين السلوك المشروع والسلوك الإحتيالي بدقة أعلى من النماذج التقليدية.
كما تُستخدم تقنيات الذكاء الإصطناعي على نطاق واسع في مراقبة المعاملات والكشف الفوري عن الإحتيال، عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات المالية وغير المالية في الزمن الحقيقي، وربطها بعلاقات غير خطّية يصعب على الأنظمة القائمة على القواعد اكتشافها. وتشير تقارير متخصّصة إلى أن إعتماد هذه التطبيقات أدّى إلى تحسين معدّلات إكتشاف الإحتيال بنسب تُراوح بين 6 % و20 % لدى عدد من المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن تقليص زمن الإستجابة وإتخاذ القرار.
ومن التطبيقات العملية المهمة أيضاً تقليل معدّلات الإنذارات الخاطئة، التي تشكّل أحد أبرز التحديات التشغيلية في أنظمة مكافحة الإحتيال. فقد أسهمت النماذج الذكية في خفض الإنذارات غير الضرورية بشكل ملموس، مما إنعكس تحسّناً في الكفاءة التشغيلية بنسبة تراوحت بين 40 % و60 % لدى المؤسسات التي إعتمدت الذكاء الإصطناعي، من خلال توجيه موارد الإمتثال نحو الحالات الأعلى خطورة بدلاً من المعالجة اليدوية المكثّفة.
إلى جانب ذلك، يُستخدم الذكاء الإصطناعي في التنبؤ بالمخاطر الإحتيالية ودعم قرارات الإمتثال، عبر نماذج قادرة على التعلّم المستمر من الحالات السابقة وتكييف معايير التقييم تلقائياً مع تطور الأساليب الإحتيالية. ويُعزّز هذا الإستخدام الإنتقال من منطق المكافحة اللاحقة إلى نهج وقائي إستباقي، يُركّز على منع وقوع الإحتيال قبل تحقّقه، بما يدعم متانة الأنظمة الرقابية ويحدّ من الخسائر المالية في بيئة رقمية عالية المخاطر.
التحدّيات التنظيمية والأخلاقية لتطبيق الذكاء الإصطناعي في مكافحة الإحتيال المالي
رغم الفوائد التشغيلية الكبيرة التي يُوفّرها الذكاء الإصطناعي في مكافحة الإحتيال المالي، فإن تطبيقه يطرح مجموعة من التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تؤثر بشكل مباشر على فعّالية هذه الأنظمة وإستدامتها. وتتمثّل أبرز هذه التحدّيات في حوكمة البيانات وجودتها، إذ تعتمد النماذج الذكية على كميات ضخمة من البيانات الحساسة، ما يفرض متطلّبات صارمة تتعلّق بحماية الخصوصية وأمن المعلومات والإمتثال للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما تبرز مخاطر «الإنحياز الخوارزمي» بوصفها أحد التحدّيات الجوهرية، حيث قد تؤدي نماذج التعلّم الآلي، في حال تدريبها على بيانات غير متوازنة أو تاريخية، إلى قرارات تمييزية أو غير دقيقة، ما ينعكس سلباً على العدالة المالية وتجربة العملاء. ويُضاف إلى ذلك تحدّي قابلية التفسير والشفافية، إذ تُواجه العديد من المؤسسات صعوبة في تفسير قرارات النماذج المعقدة أمام الجهات الرقابية، مما يحدّ من الثقة التنظيمية ويصعّب دمج الذكاء الإصطناعي ضمن أطر الإمتثال التقليدية. وفي هذا الإطار، يُصبح نجاح تطبيق الذكاء الإصطناعي في مكافحة الإحتيال مشروطاً بتطوير أطر حوكمة واضحة، تضمن الإستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتوازن بين متطلّبات الإبتكار الرقمي وحماية الحقوق والإمتثال التنظيمي.
 حاجة المصارف العربية في ضوء التقنيات المستجدة
حاجة المصارف العربية في ضوء التقنيات المستجدة
في الخلاصة، وفي ضوء تصاعد مخاطر الإحتيال المالي في البيئة الرقمية، وما أظهرته التجارب الدولية من تحسُّن ملموس في فعّالية أنظمة المكافحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة أمام المصارف العربية إلى تبنّي مقاربة إستراتيجية متدرّجة لتوظيف هذه التقنيات. ويقتضي ذلك، بداية، إدماج الذكاء الإصطناعي ضمن أطر إدارة المخاطر والإمتثال القائمة بدل التعامل معه كحل تقني منفصل، بما يضمن تكامل أنظمة مكافحة الإحتيال مع سياسات الحوكمة والرقابة الداخلية.
كما يُوصى بإستثمار المصارف في تحسين جودة البيانات وبناء بُنى تحتية رقمية مرنة قادرة على دعم التحليل في الزمن الحقيقي، نظراً إلى كون فعّالية النماذج الذكية ترتبط مباشرة بدقة البيانات وتكاملها. وفي هذا السياق، يبرز دور التعاون بين المصارف والجهات الرقابية لتوحيد المعايير المتعلقة بحوكمة البيانات، وحماية الخصوصية، وقابلية تفسير النماذج الخوارزمية.
ومن المهم أيضاً إعتماد نهج تدريجي في تطبيق الذكاء الإصطناعي، يبدأ بالمجالات الأعلى خطورة وتأثيراً، مثل المدفوعات الرقمية والتحويلات السريعة، مع تطوير مؤشّرات أداء واضحة لقياس الأثر الفعلي على خفض الخسائر وتقليل الإنذارات الخاطئة.
كما يتعيّن الاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر تدريب فرق الإمتثال والمخاطر على فهم مخرجات النماذج الذكية، وتعزيز التعاون بين الفرق التقنية والتنظيمية.
وأخيراً، يُستحسن أن تتّجه المصارف نحو نماذج شراكة مع مزوّدي الحلول المتخصّصة بدل الإعتماد الحصري على التطوير الداخلي، بما يتيح تسريع الإستفادة من الخبرات العالمية مع الحفاظ على متطلّبات السيادة التنظيمية. ويُسهم هذا التوجّه في دعم إنتقال المصارف من نماذج رقابية تفاعلية إلى منظومات ذكية إستباقية، قادرة على تعزيز متانة النظام المالي والحدّ من مخاطر الإحتيال في ظل التحوُّل الرقمي المتسارع.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة باتت أدوات محورية
تداعيات الجرائم المالية والإقتصادية على الإستقرار المالي العربي
الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة باتت أدوات محورية
لإعادة بناء منظومات مكافحة الجرائم المالية على أسس أكثر ديناميكية وفعّالية
تُعرف الجرائم المالية والاقتصادية بأنها أفعال غير مشروعة تستهدف تحقيق منفعة مالية عبر الإحتيال، والإختلاس، والرشوة، والتلاعب المحاسبي، والتهرُّب الضريبي غير المشروع، والاتجار غير المشروع، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية داخل النظام المالي أو خارجه. وتكمن خطورة تلك الجرائم في أنها لا تُحدث خسائر مباشرة فحسب، بل تُضعف كفاءة تخصيص الموارد وتُشوّه المنافسة وترفع علاوات المخاطر والتمويل وتُقوّض نزاهة الأسواق.
لم تعد الجرائم المالية والاقتصادية ظاهرة هامشية تُعالج بأدوات إمتثال تقليدية، بل أصبحت مخاطر نظامية تتفاعل مع التحوُّل الرقمي وتدويل التدفقات المالية وإتساع الإقتصاد غير الرسمي، بما ينعكس مباشرة على سلامة القطاع المصرفي، وكلفة الإمتثال، وإستدامة علاقات البنوك المراسلة، وثقة المودعين والمستثمرين. وتزداد حدّة الإشكالية في الإقتصادات الناشئة بفعل تباين مستويات الحوكمة والشفافية، وإتساع المعاملات النقدية، وتفاوت نضج البنى الرقابية والتقنية، وإرتفاع قابلية إستغلال القنوات الرقمية العابرة للحدود.
 حجم الجرائم المالية والاقتصادية حول العالم
حجم الجرائم المالية والاقتصادية حول العالم
تشير التقديرات الدولية إلى أن الجرائم المالية والإقتصادية باتت تمثل عبئاً عالمياً واسع النطاق يتجاوز الخسائر المباشرة إلى آثارٍ ممتدة على الثقة والإستقرار المالي. فبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يُقدَّر حجم الأموال التي تُغسل سنوياً بما يعادل 2 % الى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما بين 800 مليار و2 تريليون دولار تقريباً، مع صعوبة القياس بسبب الطابع الخفي لهذه الأنشطة.
ومن زاوية الإحتيال داخل المؤسسات، تُظهر جمعية فاحصي الإحتيال المعتمدين (Association of Certified Fraud Examiners) في تقريرها لعام 2024، والمبني على 1,921 قضية من 138 دولة، أن متوسّط الخسارة في قضايا الإحتيال المهني تبلغ 145 ألف دولار، وأن 22 % من القضايا تتجاوز خسائرها مليون دولار، بما يُبرز أثر الإحتيال كخطر تشغيلي ومالي متكرّر على الشركات والقطاع المالي. وعلى مستوى الإحتيالات التي تستهدف الأفراد عبر القنوات الرقمية، تشير معطيات (Global Anti-Scam Alliance) إلى أن المستهلكين حول العالم يخسرون نحو 442 مليار دولار سنوياً بسبب عمليات الإحتيال والـ Scams، ما يعكس تسارع الجريمة المالية في بيئة رقمية عابرة للحدود.
وعلى الصعيد الإقليمي، يبرز واقع مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كعامل مؤثر مباشر على بيئات العمل المالي والإستثماري، لا سيما من خلال تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمنظومات الدول في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل القائمة الرمادية الدول التي تواجه نواقص استراتيجية في أطر الامتثال وفق معايير FATF وتخضع لمراقبة دولية مشددة لتحسين أنظمتها. ووفق تحديثات FATF حتى 24 أكتوبر/تشرين الاول 2025، تضم القائمة الرمادية ما يزيد على 20 دولة، من بينها عدد من الدول العربية كالجزائر ولبنان وسوريا واليمن، بسبب قصور في جوانب مثل التحقق من المستفيد الحقيقي ومراقبة المعاملات عالية المخاطر وتطبيق العقوبات الدولية.
وقد مثّل إدراج لبنان في القائمة الرمادية منذ أكتوبر/تشرين الاول 2024 مؤشّراً على وجود ثغرات تنظيمية هيكلية مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مما يعزّز المخاطر على قطاعه المصرفي وقدرته على استعادة الثقة الدولية. ورغم أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لا يعني رفضها كلياً في النظام المالي الدولي، فإن ذلك يرفع تكلفة المعاملات عبر الحدود ويزيد إجراءات التدقيق والتشدُّد في العلاقات المصرفية من قبل البنوك المراسلة الدولية، ويُنظر إليه كمؤشّر خطر يعكس الحاجة إلى تعزيز أطر الشفافية وحوكمة المخاطر في القطاع المالي.
يُبرز الرسم البياني رقم 1 الحجم الواسع وغير المتكافئ للجرائم المالية والإقتصادية على المستوى العالمي، حيث تشكّل عمليات غسل الأموال المكوّن الأكبر من حيث القيمة التقديرية، بمبلغ سنوي قد يتجاوز تريليوني دولار بحسب بعض التقديرات، ما يعكس الطابع المنهجي والعابر للحدود لهذه الظاهرة. وفي المقابل، تُظهر خسائر الإحتيال المالي، رغم إنخفاضها النسبي مقارنة بعمليات غسل الأموال، أثراً مباشراً ومتكرّراً على الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في ظل تصاعد الإحتيال الرقمي.
 التداعيات على القطاع المصرفي ومسارات الإحتواء
التداعيات على القطاع المصرفي ومسارات الإحتواء
في السياق المصرفي، تتجسّد أبرز التداعيات في إرتفاع تكاليف الامتثال وعبء الرقابة التشغيلية، حيث تنفق المصارف والمؤسسات المالية معاً ما يقدّر بنحو 206 مليارات دولار سنوياً على الإلتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية فقط، مع تسجيل 98 % من المؤسسات زيادة في هذه التكاليف مقارنة بالعام السابق وذلك بحسب دراسةThe True Cost of Financial Crime Compliance الصادرة عن LexisNexis Risk Solutions. وتؤدي هذه التكاليف، التي تشمل توظيف فرق إمتثال مختصة، إستثمارات في التكنولوجيا، والأنظمة التحليلية، إلى تحويل موارد من وظائف إنتاجية أساسية إلى إدارة المخاطر والإمتثال، ما يؤثر بدوره في هوامش الربحية.
وإن أحد أبرز مظاهر التأثير على القطاع المصرفي العالمي هو تراجع بعض علاقات المصارف المراسلة التي تُعد شرياناً أساسياً لمعاملات التجارة والتمويل الدوليين نتيجة التخفيف من المخاطر الذي تتبنّاه بعض المصارف الكبرى لتقليل تعرُّضها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً في البلدان ذات المخاطر العالية. يُمكن أن يؤدي هذا التراجع إلى إبطاء حركة المدفوعات عبر الحدود وارتفاع تكاليف التجارة الدولية وتقليص النفاذ إلى النظام المالي العالمي بالنسبة إلى بعض المصارف في الإقتصادات الناشئة، بما في ذلك المصارف العربية.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، تعرّضت مصارف عالمية لغرامات مالية كبيرة نتيجة ضعف نظم مكافحة الجرائم المالية، مما يسلّط الضوء على تكلفة الإهمال في هذا المجال. وفي ضوء ذلك، يُصبح واضحاً أن المصارف تُواجه بيئة معقّدة تتطلّب تعزيز الأطر التنظيمية والتكامل بين السياسات الرقابية والتشغيلية والإستخدام المتقدم للتقنيات التحليلية لتحسين فعّالية مكافحة الجرائم المالية وتقليل الأثر السلبي على الإستقرار المالي والنمو الإقتصادي.
دور الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة في تعزيز فعّالية مكافحة الجرائم المالية
أسفرت التحوُّلات الرقمية المتسارعة إلى إعادة تشكيل بيئة المخاطر المالية، بما جعل الإعتماد على المقاربات التقليدية لمكافحة الجرائم المالية غير كافٍ لمواجهة أنماط متزايدة التعقيد تتسم بالقدرة العالية على التكيّف. وفي هذا السياق، برز الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة كأدوات محورية لإعادة بناء منظومات مكافحة الجرائم المالية على أسس أكثر ديناميكية وفعّالية، عبر الإنتقال من الإمتثال القائم على رد الفعل إلى إدارة إستباقية للمخاطر.
وتتيح تقنيات التعلم الآلي والتعلُّم العميق تحليل أحجام ضخمة من البيانات التشغيلية والسلوكية في الزمن شبه الحقيقي، بما يشمل بيانات المدفوعات والحسابات والتجارة الخارجية والسلوك الرقمي للعملاء. ويُسهم هذا النهج في تحسين دقّة نماذج رصد المعاملات المشبوهة من خلال التعرُّف على الأنماط غير الإعتيادية والإنحرافات السلوكية، بدل الإكتفاء بتطبيق قواعد جامدة تؤدي غالباً إلى نسب مرتفعة من الإنذارات الكاذبة. ونتيجة ذلك، تتحسّن إنتاجية فرق الإمتثال وتنخفض الكلفة التشغيلية المرتبطة بالتحقيق اليدوي، مع تعزيز القدرة على الكشف المبكّر عن المخاطر الحقيقية. إلى جانب ذلك، تمكّن «تحليلات الشبكات» المصارف من فهم العلاقات المعقّدة بين الأطراف والمعاملات، وكشف البُنى الخفية لشبكات غسل الأموال والاحتيال، ولا سيما في الحالات المرتبطة بالشركات الوهمية، والمستفيد الحقيقي، وغسل الأموال القائم على التجارة. ويكتسب هذا البُعد أهمية خاصة للمصارف العربية في ظل الطبيعة العابرة للحدود للتدفقات المالية، وتعدّد الوسطاء، وتفاوت مستويات الشفافية بين الأسواق.
وعلى المستوى العملي، يفتح الذكاء الإصطناعي المجال أمام إعادة تصميم دورة الإمتثال بالكامل، من خلال دمج وظائف «إعرف عميلك» والعناية الواجبة المعزّزة ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير الرقابية ضمن منصة تحليلية موحّدة. ويسمح هذا التكامل ببناء ملف مخاطر ديناميكي لكل عميل، يتطور بإستمرار وفق سلوكه المالي الفعلي، بدل الإعتماد على تصنيفات ثابتة تُحدّث على فترات متباعدة. غير أن تحقيق هذه المكاسب يتطلّب معالجة جملة من التحدّيات التنظيمية والمؤسسية. فإعتماد الذكاء الإصطناعي في مكافحة الجرائم المالية يستلزم حوكمة واضحة للنماذج تضمن قابلية التفسير وتوثيق منطق إتخاذ القرار والإمتثال لمتطلّبات الجهات الرقابية، ولا سيما في ما يتعلق بالشفافية وعدم التحيُّز وحماية البيانات. كما يتطلّب الأمر إستثمارات موازية في جودة البيانات وبناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون بين إدارات الإمتثال، والمخاطر، وتكنولوجيا المعلومات.
في هذا الإطار، تتمثّل المسارات العملية المقترحة للمصارف العربية في تبنّي مقاربة تدريجية تقوم على التالي: أولاً، دمج التحليلات المتقدّمة كطبقة داعمة للأنظمة القائمة بدل إستبدالها دفعة واحدة. ثانياً، تركيز إستخدام الذكاء الإصطناعي على المجالات الأعلى مخاطر مثل المدفوعات العابرة للحدود والإحتيال الرقمي، ثالثاً، تطوير أطر حوكمة داخلية للنماذج التحليلية بالتنسيق مع السلطات الرقابية، رابعاً، الإستثمار في بناء مهارات تحليل البيانات والإمتثال الذكي. ومن شأن هذا المسار المتوازن أن يُعزّز فعّالية مكافحة الجرائم المالية، وأن يُخفّض كلفة الإمتثال على المدى المتوسط، وأن يدعم في الوقت نفسه متانة القطاع المصرفي العربي وثقته في النظام المالي العالمي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

قانون الفجوة المالية في لبنان وأبعاده
قانون الفجوة المالية في لبنان وأبعاده
إتحاد المصارف العربية يوصي البنوك بإجراء عمليات تدقيق شفّافة وتقييمات
جدوى لتحديد حجم خسائرها وتحديد المؤسسات التي يُمكن إعادة هيكلتها

ويُعتبر هذا القانون أساسياً للحصول على دعم صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية، حيث يضع إطاراً للتعافي، بما في ذلك تعهد بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات. وقد أثار القانون جدلاً واسعاً، حيث حذّرت البنوك من أن الخطة قد تُزعزع إستقرار النظام المالي، بينما يخشى المودعون من تكبّدهم خسائر فادحة، مما يجعل إقرار القانون في البرلمان إختباراً حاسماً لمستقبل لبنان الإقتصادي.
ونعرض هنا أبرز بنود قانون الفجوة المالية والإطار الزمني والمراحل الرئيسية، والتحدّيات والفرص، والتأثير على المستويين المحلي والعالمي، وآلية الإنفاذ، والجهات المعنية، والتقنيات اللازمة، ودور المصارف، مختتمين بالتوصيات لتمكين المصارف من الإمتثال للقانون، والتوقعات المستقبلية، وأفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها.
الجدول الزمني والمعالم الرئيسية
أقرّ مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية في لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأحاله إلى البرلمان للمناقشة، وتعهدت الحكومة بأنه بمجرّد إقرار القانون، سيُمكّن من إسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات (2026-2030). ويتضمّن الجدول الزمني إقرار مجلس الوزراء، ومناقشة القانون في البرلمان، وإدخال تعديلات عليه في مطلع العام 2026، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرتبطة بإقرار القانون، بالإضافة إلى مراحل مرحلية لاسترداد الودائع حتى العام 2030.
يبدأ الجدول الزمني الرسمي لقانون الفجوة المالية بموافقة مجلس الوزراء في أواخر العام 2025، وينتقل إلى المناقشة البرلمانية في العام 2026، ويُحدّد أربع سنوات لإسترداد أموال المودعين حتى العام 2030. ويتوقف نجاحه على التوافق السياسي، ودعم صندوق النقد الدولي، وقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.
الجدول الزمني والمعالم الرئيسية
 الأزمة المالية في لبنان
الأزمة المالية في لبنان
إتسمت الأزمة المالية في لبنان بانهيار القطاع المصرفي، وإنخفاض قيمة العملة بأكثر من 98 %، وتضخم تجاوز 220 % في العام 2023. وقد كانت الأزمة نتيجة سنوات من الهندسة المالية غير المستدامة التي مارسها البنك المركزي، وتفاقمت بسبب الفساد السياسي، وجائحة كوفيد-19، وإنفجار مرفأ بيروت في العام 2020، والصدمات العالمية كالحرب في أوكرانيا. ونتيجة ذلك، مُنع المودعون من الوصول إلى مدّخراتهم، وإنهارت الخدمات العامة لدرجة أن الأسر لا تحصل في كثير من الأحيان إلاّ على ساعة واحدة من الكهرباء يومياً دون مولدات كهربائية، وإرتفعت مستويات الفقر بشكل حاد، مما جعل شريحة كبيرة من السكان تعتمد على التحويلات المالية والمساعدات الإنسانية.
منظومة القانون
تضم منظومة قانون الفجوة المالية في لبنان الحكومة والبرلمان والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وكلهم يلعبون أدواراً مترابطة في صوغ القانون وتنفيذه.
منظومة قانون الفجوة المالية في لبنان
التحدّيات
يُواجه قانون سدّ الفجوة المالية في لبنان تحدّيات جمة، تبدأ بالإنقسامات السياسية العميقة في البرلمان مما يُهدّد بتأخير أو إضعاف إقرار القانون، في حين تُقاوم البنوك التجارية بشدّة تقديرات الحكومة للخسائر البالغة 70 مليار دولار، بحجّة أن الأرقام مُبالغ فيها، مُحذرةً من إنهيار النظام المالي إذا ما أُجبرت على استيعاب هذا القدر الكبير من الخسائر. ولا يثق المودعون، الذين مُنعوا بالفعل من الوصول إلى مدخراتهم منذ العام 2019، بتعهد الحكومة بإسترداد 85 % من الودائع خلال أربع سنوات. ويعتبر صندوق النقد الدولي إنفاذ القانون شرطاً أساسياً لحصول لبنان على المساعدات، مما يعني أن لبنان قد يتعرّض لمخاطر فقدان الدعم الدولي إذا تعثّر تنفيذ القانون. كما وأن ضعف المؤسسات المالية، وإنعدام الشفافية، وغياب تقييمات جدوى كل بنك، قد تُعرقل تنفيذ القانون.
التحديات الرئيسية
الفرص
يحمل قانون سدّ الفجوة المالية في طياته فرصاً هامة، إذ يُعدّ أول إعتراف رسمي بالخسائر المالية الفادحة التي تكبّدها لبنان، ويُقدّم إطاراً للتعافي بغية إستعادة مصداقية النظام المصرفي. وبتعهده بإسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، ويُعيد القانون الأمل للمودعين، كما يُمهّد الطريق لإعادة هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة المالية. والأهم من ذلك، أن إقرار القانون شرط أساسي للحصول على دعم صندوق النقد الدولي وتسهيل الحصول على المساعدات الدولية، يُساهم في إستقرار الإقتصاد، وجذب الإستثمارات، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية اللبنانية، ما يجعل القانون نقطة تحوّل في الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.
إنفاذ القانون
يتطلب تطبيق قانون الفجوة المالية في لبنان جهوداً منسّقة بين الجهات السياسية والمالية والمؤسسية، بدءاً بموافقة البرلمان، ثم وضع آليات لتوزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين. ويعتمد التنفيذ على تقييمات شفافة لجدوى كل بنك على حدة، وخطط موثوقة لإسترداد أموال المودعين، ورقابة صارمة لضمان الوفاء بتعهد الحكومة بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات.
ويُعتبر تنفيذ قانون الفجوة المالية شرطاً لإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما يجعل الإمتثال للقانون شرطاً أساسياً للحصول على المساعدات الدولية. إن التنفيذ الفعّال للقانون يساعد في استعادة الثقة في النظام المالي اللبناني ووضع أسس الإستقرار الإقتصادي.
التقنيات المطلوبة
يتطلّب تطبيق قانون سد الفجوة المالية في لبنان مزيجاً من التقنيات المالية والرقمية والتنظيمية لضمان الشفافية والكفاءة والمصداقية. وهناك حاجة إلى منصّات مصرفية رقمية وأنظمة دفع آمنة لإدارة إسترداد أموال المودعين على مراحل وتتبع المعاملات بدقة. ويمكن لسجلاّت البيانات القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوكشين) أن تُوفر سجلاّت موثقة لتوزيع الخسائر وسداد الودائع، مما يساعد على إعادة بناء الثقة في النظام المالي. وستكون تحليلات البيانات وأدوات الذكاء الإصطناعي أساسية لإجراء تقييمات جدوى لكل بنك على حدة، وإختبار قدرة المؤسسات على تحمُّل الضغوط، ومراقبة الإمتثال لمتطلبات القانون. أما على الصعيد التنظيمي، فستتيح أنظمة الإدارة المالية المركزية المتكاملة مع مصرف لبنان الإشراف الفوري على السيولة، بينما ستحمي أطر الأمن السيبراني بيانات المودعين الحساسة. ويُمكن للوحات معلومات التقارير الرقمية المتاحة للبرلمان وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني أن تعزّز الشفافية، مما يضمن القدرة على مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق تعهد الحكومة بإسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع في غضون أربع سنوات.
الآثار على النمو الاقتصادي في لبنان
إن لقانون الفجوة المالية أثراً بالغاً على النمو الإقتصادي في لبنان إذا تم تطبيقه بفعّالية، إذ يُوفِّر القانون إطاراً للإعتراف بالخسائر المالية الهائلة التي تكبَّدتها البلاد وتوزيعها، وإستعادة الثقة في النظام المصرفي، وتفعيل الدعم الحاسم من صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية. وبالتعهّد بإسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، يساعد القانون في زيادة ثقة المستهلك، وتحفيز الإنفاق، وتشجيع الإستثمار، وهي عوامل أساسية للنمو. كما وأن إعادة هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة المالية من الأمور التي تساعد في استقرار النظام النقدي، والحد من الضغوط التضخمية، وتحقيق إنتعاش مستدام. إلاّ أن نجاح القانون يعتمد على تنفيذه بشفافية وتوافق سياسي. ومع ذلك، قد تبقى وعود القانون رمزية، مما يجعل الإقتصاد اللبناني عُرضةً للركود والمزيد من التدهور.
الآثار على الصعيد العالمي
إن قانون الفجوة المالية في لبنان هو نموذج لكيفية إدارة الاقتصادات المثقلة بالديون والأزمات للخسائر المالية النظامية، حيث تراقب مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي تنفيذه عن كثب كشرط للحصول على المساعدات. ومن خلال الإعتراف الرسمي بـ 70 مليار دولار من الخسائر ومحاولة توزيعها، يُشير القانون إلى الأسواق العالمية والمستثمرين بأن لبنان مستعد لمواجهة انهياره المالي، مما يُعزّز الثقة في الإقتصادات الناشئة التي تواجه أزمات ديون مماثلة.
إن التنفيذ الناجح للقانون يُعزّز مصداقية لبنان، ويجذب الإستثمارات الأجنبية، ويُرسّخ دور صندوق النقد الدولي كقوة إستقرار في التمويل العالمي، بينما قد يُؤدي الفشل إلى تقويض الثقة في أطر الإنقاذ الدولية، ويُبرز مخاطر التشرذم السياسي في إدارة التعافي الإقتصادي.
دور البنوك
إن البنوك لها دور محوري في قانون الفجوة المالية، إذ يُتوقع منها إستيعاب جزء كبير من الخسائر المالية التي تُقدر بنحو 70 مليار دولار. وتلتزم البنوك التجارية، التي كانت قد منعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم منذ إنهيار العام 2019، بإعادة هيكلة ميزانياتها العمومية وتقاسم الخسائر مع الدولة والبنك المركزي. وتتعهّد الحكومة بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، لكن هذا يتطلب من البنوك الحفاظ على ملاءتها المالية واستمرار عملياتها. لقد قاومت البنوك القانون بشدة، معترضةً على تقديرات الحكومة للخسائر ومحذرةً من أن تقاسم الأعباء بشكل مفرط قد يؤدي إلى إنهيار النظام المالي. لذلك، وعليه فإن دور البنوك إداري وسياسي في آن واحد لتطبيق القانون بفعّالية.
التوصيات للبنوك
يُوصي إتحاد المصارف العربية البنوك بتبنّي مجموعة من الإستراتيجيات المنسّقة التي توازن بين المتطلّبات التنظيمية وحماية المودعين وإستمرارية المؤسسات:
أولاً، يجب على البنوك إجراء عمليات تدقيق شفافة وتقييمات جدوى لتحديد حجم خسائرها وتحديد المؤسسات التي يمكن إعادة هيكلتها.
ثانياً، على البنوك تنفيذ خطط إعادة هيكلة رأس المال، بما في ذلك إعادة الرسملة من خلال بيع الأصول أو عمليات الإندماج، لإستيعاب جزء من العجز المالي دون الإنهيار.
ثالثاً، على البنوك وضع آليات لإسترداد الودائع، مثل المدفوعات التدريجية أو مبادلة الديون بالأسهم أو الأدوات المالية المضمونة، بما يتماشى مع تعهد الحكومة بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع في غضون أربع سنوات.
رابعاً، يجب على البنوك تعزيز أنظمة إدارة المخاطر والإمتثال، بإستخدام الأدوات الرقمية ومعايير المحاسبة الدولية لضمان دقة التقارير وبناء الثقة مع الجهات التنظيمية والمودعين وصندوق النقد الدولي.
خامساً، على البنوك إجراء مفاوضات بنّاءة مع الحكومة والشركاء الدوليين لتحقيق التوازن بين بقائها وإنتعاش لبنان الإقتصادي، مما يجعل التعاون بديلاً لمقاومة القانون على المدى الطويل.
النظرة المستقبلية
على المدى القريب، يُتوقع أن يتم إقرار القانون في البرلمان مطلع العام 2026، إلاّ أنه قد تؤدي الإنقسامات السياسية ومقاومة القطاع المصرفي إلى تأخير القانون أو تغيير صيغته النهائية. وفي حال إقراره، يتضمّن الأفق المتوسط إعادة هيكلة البنوك، وإجراء تقييمات الجدوى، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات دولية، وهو أمر بالغ الأهمية لإستقرار الإقتصاد.
وعلى المدى البعيد، حتى العام 2030، يُساعد القانون على إستعادة ثقة المودعين، وإعادة بناء الحوكمة المالية، وتهيئة لبنان لإنتعاش إقتصادي تدريجي. وعليه، يُعتبر القانون إختباراً للإرادة السياسية في لبنان، وفرصة لإعادة ضبط النظام المالي في البلاد، ويعتمد نجاحه على تطبيق شفّاف ودعم دولي مستدام.
أفضل الممارسات المستفادة
إن من أفضل الممارسات المستفادة من قانون الفجوة المالية في لبنان أهمية الإعتراف الرسمي بالخسائر المالية بدلاً من إنكارها، فالشفافية هي الخطوة الأولى نحو التعافي وإعادة بناء الثقة. ومن الدروس الأخرى ضرورة تقاسم الأعباء بشكل شامل، حيث تُوزّع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والبنوك والمودعين، بدلاً من تركيزها على فئة واحدة، مما يُسهم في الحفاظ على إستقرار النظام المالي. كما يُبرز القانون أهمية ربط الإصلاحات بالأطر الدولية، إذ إن ربط الإمتثال بدعم صندوق النقد الدولي يضمن المساءلة ويُتيح الوصول إلى المساعدات الخارجية. إضافةً إلى ذلك، تُظهر تجربة لبنان أن تحديد جداول زمنية واضحة لإسترداد أموال المودعين، كالتعهد بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، يُمكن أن يُعيد الثقة إذا ما دُعم بإنفاذ موثوق. وأخيراً، تُؤكد هذه العملية ضرورة إشراك مختلف الجهات والتواصل معهم، إذ إن إشراك البرلمان والمجتمع المدني والقطاع المصرفي في المناقشات يُساعد على إضفاء الشرعية على الإصلاحات ويزيد من فرص نجاح وتنفيذ القانون.
د. سهى معاد – كاتبة وباحثة إستراتيجية

الدكتورة حنان مرسي في قراءة تحليلة معمقة لمواكبة التحولات الاقتصادية في أفريقيا
في قراءة تحليلية معمّقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحوّلات
الإقتصادية في القارة الأفريقية وتوصيات فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين
 الدكتورة حنان مرسي – نائب الأمين التنفيذي
الدكتورة حنان مرسي – نائب الأمين التنفيذي
وكبيرة الإقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا CEA:
* أفريقيا – مجموعة العشرين: نحو ميثاق جديد للنمو والإستقرار والإستثمار
* الإزدهار العالمي لا يتحقق إلاّ من خلال الإزدهار الشامل
* تعثُّر مسار التنمية قد يؤدي إلى خسائر تنموية تراكمية يصعب تداركها وقد تُضعف آفاق أفريقيا بشكل دائم
* على مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية أن تتحوّل إلى جهات فاعلة وأن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس إلى جانب الإبتكار المالي
في هذه المقابلة الحصرية، تقدّم الدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبيرة الإقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (CEA)، قراءة تحليلية معمّقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحوّلات الإقتصادية التي تشهدها القارّة الأفريقية. كما ترسم ملامح مسار نمو أفريقي مستدام، شامل وإستراتيجي، بما يفتح آفاقاً واسعة من الفرص الإستثمارية والتمويلية أمام المصارف العربية.
وتستند هذه المقابلة إلى تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025، الذي يدعو إلى إحداث تحوّل حاسم عبر إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين، يهدف إلى مواءمة النظام المالي العالمي مع الأسس الإقتصادية الحقيقية للقارّة، وتعزيز دورها كمحرّك رئيسي للنمو والإستقرار في الإقتصاد العالمي.
وفي لمحة مختصرة عن تقرير أفريقيا – مجموعة العشرين 2025:
يشكّل تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025 محطّة مفصلية في مقاربة الدور الإقتصادي للقارّة الأفريقية، إذ يؤكد أن أفريقيا لم تعد طرفاً هامشياً في الإقتصاد العالمي، بل باتت أحد المراكز الرئيسية المحتملة للنمو العالمي خلال العقود المقبلة، مدفوعةً بدينامية ديموغرافية فريدة، وإمكانات طاقوية هائلة، وفرص إستثمار تُعدّ من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم.
غير أن التقرير يسلّط الضوء على مفارقة هيكلية لافتة، إذ رغم متانة الأسس الإقتصادية، لا تزال أفريقيا تواجه قيوداً حادّة ناجمة عن الإرتفاع المفرط في كلفة رأس المال، وتزايد الضغوط المرتبطة بالديون السيادية، وقصور في بنية النظام المالي الدولي، ما يؤدي إلى تضخيم كلفة التمويل والحدّ من الإستثمار المنتج.
إزاء هذا الواقع، يدعو فريق الخبراء إلى إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين، يرتكز على أربعة محاور بنيوية رئيسية:
- إعتماد مقاربة شاملة وإستباقية لإدارة الدين، تتجاوز منطق إعادة الجدولة التقليدية؛
- تعزيز دور المصارف متعدّدة الأطراف والإقليمية للتنمية بهدف تعبئة مزيد من التمويلات طويلة الأجل؛
- إصلاح القواعد المالية الدولية، ولا سيما في مجالات تصنيف المخاطر والتنظيم الإحترازي؛
- إطلاق جهد إستثماري واسع النطاق في مجالات الإستثمار المنتج، والبنى التحتية، والطاقة، والتكامل الإقليمي والإبتكار.
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية العربية، تفتح هذه التوجُّهات آفاقاً إستراتيجية واعدة، إذ يُبرز التقرير أهمية تعميق التعاون المالي بين أفريقيا والعالم العربي، وتفعيل أدوات مثل تمويل المشاريع، وتمويل التجارة، والتمويل الإسلامي، وآليات التمويل الممزوج (Blended Finance)، بما يُسهم في مواكبة التحوُّل الاقتصادي للقارّة وتقاسم الفرص التي يتيحها.

* يؤكد التقرير، أن زيادة الإنتاجية في أفريقيا تُعدّ أحد أبرز المحرّكات المحتملة للإزدهار العالمي في القرن الحادي والعشرين، كيف تفسّرون هذه الخلاصة؟ وما هي برأيكم إنعكاساتها العملية على الدور الإقتصادي والإستراتيجي الذي تضطلع به أفريقيا اليوم؟
– نحن أمام تحوّل جذري في نموذج النمو الإقتصادي في أفريقيا تاريخياً، إذ كان نمو القارّة مدفوعاً بتراكم عوامل الإنتاج، أي زيادة اليد العاملة ورأس المال، أكثر من إعتماده على تحسّن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. غير أنّ هذا النموذج بلغ حدوده، إذ تمثّل أفريقيا نحو 17 % من سكان العالم، لكنها لا تسهم بأكثر من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولا يعكس هذا الفارق نقصاً في الإمكانات، بل ضعف الإستثمار في محرّكات الإنتاجية، ولا سيما البنى التحتية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا .أما الفرصة الجديدة، فتكمن في التقنيات المتقدّمة، حيث تمتلك أفريقيا نحو 60 % من إمكانات الطاقة الشمسية عالية الجودة عالميًا، وحوالي 30 % من المعادن الحيوية اللازمة للتحوُّل العالمي في مجال الطاقة.
إذا نجحت أفريقيا في رفع مستوى الإنتاجية، فإن ذلك سيُعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر أثر مضاعِف، يُترجم إلى فرص عمل جديدة، وإرتفاع في مستويات الدخل، وتوسّع في الحيّز المالي. ولن تكون هذه الدينامية معزولة عن محيطها، ففي وقت يبحث فيه الإقتصاد العالمي عن محرّكات جديدة للطلب والنمو الأخضر، تمثّل التحوّلات الهيكلية في أفريقيا فرصة مشتركة للإقتصاد العالمي بأسره. نحن نلمس هذا الإمكان اليوم، غير أن تحويله إلى واقع يتطلّب إلتزاماً واضحاً برفع الإنفاق الوطني على البحث والتطوير إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. فإزدهار الإقتصاد العالمي يحتاج إلى محرّكات جديدة للطلب، وتُعدّ أفريقيا المنتِجة والمُصنَّعة أكبر محرّك متاح حالياً.
والرسالة هنا واضحة: الإزدهار العالمي لا يتحقق إلاّ من خلال إزدهار شامل، وأفريقيا، إذا ما حظيت بالتمويل الكافي وتم دمجها بفعّالية في سلاسل القيمة، قادرة على الإسهام في تحقيق ذلك على نحو حاسم.
* يدعو التقرير إلى إطلاق مبادرة جديدة لإعادة تمويل الديون تحت مظلة مجموعة العشرين، بدل الإكتفاء بإعادة الجدولة، لماذا يُعدّ خيار إعادة التمويل أكثر ملاءمة في هذه المرحلة بالنسبة إلى البلدان الأفريقية منخفضة الدخل؟
نحن نواجه مشكلة في السيولة، وليس مجرّد مشكلة تتعلق بالملاءة المالية، ففي العام 2025 وحده، واجهت أفريقيا أعباء ديون خارجية بلغت89 مليار دولار أميركي، في حين يُقدَّر المبلغ المستحق حالياً لعام2026 بنحو 85 مليار دولار. علماً أن إعادة الجدولة لا تؤدي سوى إلى تأجيل عبء الدين، وغالباً ما يكون ذلك بمعدّلات فائدة أعلى.
ما نحتاجه فعلياً هو إعادة هيكلة إستباقية للدين (Ex-ante debt reprofiling)، أي إدارة الإلتزامات قبل الوصول إلى حالة التعثّر، بما يتيح إستعادة هامش الحركة المالية وتفادي الأزمات.
* كيف يُمكن لتعزيز شفافية وجودة البيانات، إلى جانب تطوير منهجيات التصنيف الإئتماني، أن يساهما في خفض كلفة الإقتراض في أفريقيا؟
تتحدّد كلفة رأس المال أساساً من خلال تسعير المخاطر، فيما يعتمد تسعير المخاطر بدوره على جودة المعلومات المتاحة، غير أن علاوة المخاطر الحالية المفروضة على أفريقيا لا تستند إلى الأسس الإقتصادية الحقيقية، إذ تُظهر تحليلاتنا أن الدول الأفريقية تتحمّل تكاليف إقتراض أعلى بكثير مقارنة بدول ذات أوضاع إقتصادية كلية مماثلة، وذلك حصرياً نتيجة تحيّزات قائمة على التصوّر والإنطباع لا على الوقائع.
وفي المقابل، تُسجّل مشاريع البنية التحتية في أفريقيا المدعومة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عوائد لافتة، إذ يبلغ متوسط عائدها نحو خمسة أضعاف عائد مؤشرS&P 500 ، كما تُظهر البيانات أن معدّلات التعثّر في هذه المشاريع الكبرى في الدول النامية، بعد دخولها مرحلة التشغيل، لا تتجاوز معدّلات التعثّر المسجّلة على ديون الشركات المصنّفة ضمن فئة الإستثمار الآمن (BBB-) في الإقتصادات ذات الدخل المرتفع. ويستند هذا الإستنتاج إلى أكثر من 30 عاماً من البيانات الصادرة عن إتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMS)، والذي قام بتحليل ما يقارب15 ألف قرض.
تتحمّل أفريقيا ما يمكن وصفه بـ «ضريبة نقص الشفافية»، إذ يعوّض المستثمرون في كثير من الأحيان عن التصوّر بوجود فجوات معلوماتية من خلال المطالبة بعوائد أعلى. علماً أن تعزيز شفافية البيانات الإقتصادية الكلية والمالية، إلى جانب بيانات المشاريع، يُسهم تدريجياً في تقليص فروق العوائد، غير أنّ هذه الضريبة الخفية تؤدي عملياً إلى إستنزاف مليارات الدولارات التي كان يُمكن توجيهها إلى قطاعات أساسية كالصحة والتعليم. والحل في جوهره هيكلي، إذ يتمثّل في بناء منظومة بيانات أكثر موثوقية وتوازناً. وفي هذا السياق، يجري العمل على إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الإئتماني، تهدف إلى تقديم تقييم موضوعي ومراعٍ للسياق الواقعي لمخاطر الدين السيادي، بما يُسهم في تصحيح التحيّزات القائمة في منظومة التصنيف الدولية.
ولا يقلّ أهمية عن ذلك إصلاح منهجيات التصنيف الائتماني، التي تميل في كثير من الأحيان إلى المبالغة في إبراز مواطن الضعف الخارجية مقابل التقليل من وزن الإصلاحات والسياسات المنفّذة، فعلى سبيل المثال، نجحت دول أفريقية عدّة في تحقيق فوائض أولية وتنفيذ إصلاحات جوهرية، ومع ذلك بقيت تصنيفاتها الإئتمانية على حالها دون تغيير.
إضافة إلى ذلك، ومن خلال تعزيز الرقابة التنظيمية، يتعيّن على وكالات التصنيف الإئتماني مراجعة منهجياتها بما يضع حداً لمعاقبة الإستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية عبر تصنيفها على أنها مخاطر سيولة قصيرة الأجل.
إن تحسين جودة البيانات، مقروناً بتقييمات أكثر اتساقًا وشفافية، سيُفضي إلى تكاليف إقتراض أكثر عدالة، وأن يشكّل في الوقت نفسه حافزاً لإعتماد سياسات مالية واقتصادية رشيدة.
* ما هي المتطلّبات الأساسية التي ينبغي إستكمالها لتمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) من تحقيق كامل إمكاناتها الإقتصادية؟
بحسب تقديراتنا الواردة في التقرير الإقتصادي عن أفريقيا لعام 2024، تمتلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) القدرة على زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسبة تصل إلى 45 % في حلول العام 2045، ولكن ذلك يظلّ مشروطاً بمعالجة مجموعة من العوامل التمكينية الأساسية.
أولاً: البنية التحتية
إن الفجوات القائمة في النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تجعل كلفة التجارة في أفريقيا أعلى بنحو 50 % من المتوسط العالمي، وفق بيانات الأونكتاد (UNCTAD)ما يحدّ من القدرة التنافسية، لا سيما في الدول غير الساحلية. ويُعدّ الإستثمار في الخدمات اللوجستية والربط الرقمي عنصراً حاسماً لتحرير إمكانات النمو.
ثانياً: المواءمة التنظيمية
إن تبسيط المعايير والإجراءات الجمركية وأنظمة حماية الإستثمار يُخفّض الحواجز غير الجمركية، ويُسهم في خلق حجم سوق قاري فعلي قادر على جذب الإستثمارات وتعزيز التكامل.
ثالثاً: القدرات الإنتاجية
سيبقى أثر الإتفاق محدودًا ما لم تتوافر منظومات قوية للصناعة التحويلية والتصنيع الزراعي، ويُعدّ الدعم الموجّه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق والحدائق الصناعية، إلى جانب تنمية المهارات، عناصر أساسية لضمان نجاح الإتفاق وتحقيق أهدافه التنموية.
رابعاً: خفض تكاليف المعاملات
يُتيح النظام الأفريقي الشامل للدفع والتسوية (PAPSS) إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ما يُمكن أن يخفّض تكاليف المعاملات بما يقارب النصف. غير أنّ ذلك يتطلّب بالتوازي تسريع تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية بهدف إنشاء سوق رقمية موحّدة على مستوى القارّة، فعندما نزيل عوائق تحويل العملات ونوحّد القواعد الرقمية، لا نكتفي بتبادل السلع، بل نؤسّس سلاسل قيمة إقليمية قادرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية.
وتُعدّ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) في جوهرها إصلاحاً هيكلياً وبوليصة تأمين في مواجهة تفتّت الإقتصاد العالمي. غير أن ترجمة فوائدها إلى واقع ملموس تستدعي تنسيقاً مؤسسيًاً فعّالاً، وتمويلاً كافياً، وتنفيذاً متواصلاً ومثابراً. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية وتنامي الحمائية في أسواق شريكة رئيسية، مثل الولايات المتحدة، يبقى التجارة البينية الأفريقية خط الدفاع الأكثر موثوقية لتعزيز صمود الإقتصادات الأفريقية.
* ما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) وغيرها من مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية، في ظل تراجع التمويلات الميسّرة؟
تتمتع مؤسسات مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بموقع فريد يؤهلها لسدّ فجوات التمويل، إذ تجمع بين المعرفة العميقة بالسياقات المحلية والمصداقية العالية لدى الأسواق، ولا سيما في ظل التراجع الحاد في المساعدات الإنمائية الثنائية، التي إنخفضت بنحو 70 % في قطاعات أساسية مثل الصحة.
وفي هذا الإطار، ينبغي أن تركّز هذه المؤسسات على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعظيم الرافعة المالية: توسيع إستخدام الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر، بحيث يتمكّن كل دولار من رأس المال القابل للاستدعاء من تحفيز أضعافه من التمويل الخاص.
- تحقيق الأثر بالحجم المناسب: إعادة رسملة النوافذ التمويلية الميسّرة، مثل صندوق التنمية الأفريقي (ADF) لضمان إستمرار نفاذ الدول الهشّة إلى التمويل ودعم جهود التكيّف مع تغيّر المناخ.
- الإبتكار المالي: الإضطلاع بدور ريادي في تطوير أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك السندات المرتبطة بالإستدامة، ومنصّات التمويل الممزوج (Blended Finance)، إلى جانب بناء محافظ مشاريع قابلة للتوسّع لتمويل البنية التحتية الخضراء.
في ظل ركود تدفقات التمويل الميسّر على المستوى العالمي، يتعيّن على مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية أن تتحوّل إلى جهات فاعلة في الصفوف الأمامية، وأن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس إلى جانب الإبتكار المالي. ولضمان دعم أكثر توحيداً وقوة لمسار التنمية في أفريقيا، يُصبح من الضروري تعزيز التعاون وخلق مزيد من التكامل والتآزر بين مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى الإسراع في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو البنوك متعدّدة الأطراف للتنمية، مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على شكل رأس مال هجين. ويُتيح هذا الإجراء تحويل كل دولار من حقوق السحب الخاصة إلى ما بين ثلاثة وأربعة دولارات من الإقراض الجديد. وهو نهج مُجرَّب وغير تضخمي لتوسيع ميزانيات هذه المؤسسات، من دون تحميل ميزانيات المساهمين أعباءً إضافية.
* ما هي، برأيكم، الإجراءات الثلاثة الأكثر إلحاحًا التي ينبغي على مجموعة العشرين والقادة الأفارقة إتخاذها في المرحلة الراهنة؟
نحن بحاجة إلى الإنتقال من التشخيص إلى التنفيذ، إذ إن تعثّر مسار التنمية قد يؤدي إلى خسائر تنموية تراكمية يصعب تداركها قد تُضعِف آفاق أفريقيا بشكل دائم.
أولاً: تفعيل آلية عملية لإعادة تمويل الديون لصالح البلدان الأكثر هشاشة، تركّز على خفض كلفة التمويل، وإطالة آجال الإستحقاق، وربط تخفيف عبء الدين بالإستثمار في بناء القدرة على الصمود. كما يجب أن يكون إطار مجموعة العشرين المشترك بصيغته المُعاد إصلاحها محدّداً زمنياً وشفافاً، وأن يتضمن تعليقاً تلقائياً لخدمة الدين فور تقدّم الدولة بطلب الإنضمام.
ثانياً: تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف عبر الإلتزام بتحسين كفاءة الميزانيات العمومية، ورفع حصة الضمانات إلى ما بين 20 و25 %، ومراجعة الأطر التنظيمية التي تُثقل كاهل الإقراض للمشاريع الأفريقية ذات الأثر المرتفع. وفي هذا السياق، يجب إعطاء أولوية قصوى لإعادة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، إلى جانب قيادة جهود رسملة بنوك التنمية متعددة الأطراف، إذ تحتاج أفريقيا إلى مستويات أعلى بكثير من التمويل الميسّر لمواكبة حجم أزمتي المناخ والتنمية، بما يفوق بكثير ما هو متاح حالياً.
ثالثًا: ترسيخ الحضور المؤسسي لأفريقيا في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وينبغي أن يُترجَم مقعد الإتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين إلى قدرة فعلية على التأثير في السياسات، ولا سيما في ملفّات التجارة الدولية، وإدارة الديون السيادية، وقواعد تمويل العمل المناخي.
رابعاً: الإستثمار في إقتصاد البيانات، إذ يتعيّن التعامل مع البنية التحتية الرقمية، مثل مراكز البيانات وشبكات النطاق العريضBroadband بوصفها أصولًا سيادية. لذا من الضروري الإمتلاك والتحكّم في البنية التحتية التي ستُشكّل الأساس لنمو قطاعات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في المستقبل.
إن نافذة الإصلاح ضيّقة، فالخطوات التدريجية لن تكون كافية لسدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا المقدّرة بنحو 1.3 تريليون دولار. في هذا السياق، المطلوب، تحرّك هيكلي شامل يُوفّق بين إمكانات أفريقيا الكامنة ومتطلّبات الإستقرار الإقتصادي العالمي.
(المصدر: إتحاد المصارف العربية)

محفظة شامل موني تشارك في معرض الدفع الرقمي في عدن
محفظة شامل موني التابعة لمصرف اليمن البحرين الشامل
تشارك في معرض الدفع الرقمي في عدن

وإنطلقت فعّاليات حفل تدشين معرض الدفع الرقمي تحت عنوان «سوق من غير كاش»، برعاية البنك المركزي اليمني، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والمحافظ الإلكترونية وذلك في مدينه عدن – عدن مول .وقد إستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام (ما بين 22 يناير/كانون الثاني و24 منه 2026).
ويهدف المعرض إلى التعريف بخدمات الدفع الرقمي وتشجيع المواطنين والتجار على إستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في عمليات الشراء والدفع، بما يُسهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الأمان والسرعة في التسوق.
وأكد القائمون على المعرض أهمية هذه الفعّاليات، من خلال دعم توجُّهات الإقتصاد الرقمي، وخلق بيئة مالية أكثر شمولاً، تُواكب التطوُّرات التقنية في القطاع المصرفي.

Revue UBA: L’EXCELLENCE EN FINANCE ET ECONOMIE
Revue UBA:
L’EXCELLENCE EN FINANCE ET ECONOMIE
au Maghreb et dans le Monde Arabe Fondee en 2022
Revue UBA
est la publication francophone de référence de l’Union des Banques Arabes, conçue comme une plateforme stratégique de dialogue entre le secteur bancaire arabe et ses partenaires régionaux et internationaux. À travers ses éditions thématiques, ses contributions d’experts de haut niveau et ses entretiens exclusifs avec des leaders institutionnels, la Revue UBA favorise le partage de connaissances, la coopération interrégionale et la mise en valeur des initiatives bancaires innovantes. Elle constitue un vecteur privilégié de visibilité pour les institutions financières, les organisations internationales et les partenaires engagés dans le développement économique durable, la stabilité financière et l’intégration des marchés.
À Propos de la Revue
Revue phare de l’Union des Banques Arabes (UBA), la Revue UAB se distingue par son engagement à fournir un contenu de qualité exceptionnelle sur l’économie, la finance, et l’innovation technologique. Avec des analyses rigoureuses et des perspectives enrichissantes, elle s’adresse aux décideurs, banquiers, chercheurs, et économistes des pays du Maghreb et du monde arabe.
Mission et Vision
La Revue UAB aspire à devenir une référence incontournable pour :
- Partager les meilleures pratiques bancaires et financières.
- Soutenir l’innovation et le développement économique durable.
- Offrir une plateforme d’échanges pour les professionnels et les institutions du secteur.
Diffusion et Accessibilité
- Tirage : 1 000 exemplaires par numéro, avec une distribution ciblée auprès des banques membres de l’UBA, des institutions gouvernementales et régionales, ainsi que lors des grandes conférences internationales de l’UBA.
- Format : Disponible en version papier, numérique, et par abonnement annuel.
Contactez-Nous
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre :
Téléphone : +961 1 377800 / +961 1 364885-7
Email : [email protected]
Sur la base de toutes les informations recueillies, découvrez l’éditions complète via le lien ci-dessous à tous les numéros publiés en 2025 :
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2026/01/Index-revue-2025-compressed-1.pdf

Revue Index 2025
Tables des matières
الدكتور حنان مرسي في قراءة تحليلية معمّقة لمواكبة التحوّلات الإقتصادية في القارة الأفريقية
في قراءة تحليلية معمّقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة
التحوّلات الإقتصادية في القارة الأفريقية وتوصيات فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين
الدكتورة حنان مرسي – نائب الأمين التنفيذي وكبيرة الإقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا CEA:
* أفريقيا – مجموعة العشرين: نحو ميثاق جديد للنمو والإستقرار والإستثمار
* الإزدهار العالمي لا يتحقق إلاّ من خلال الإزدهار الشامل
* تعثُّر مسار التنمية قد يؤدي إلى خسائر تنموية تراكمية يصعب تداركها وقد تُضعف آفاق أفريقيا بشكل دائم
* على مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية أن تتحوّل إلى جهات فاعلة وأن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس إلى جانب الإبتكار المالي
في هذه المقابلة الحصرية، تقدّم الدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبيرة الإقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (CEA)، قراءة تحليلية معمّقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحوّلات الإقتصادية التي تشهدها القارّة الأفريقية. كما ترسم ملامح مسار نمو أفريقي مستدام، شامل وإستراتيجي، بما يفتح آفاقاً واسعة من الفرص الإستثمارية والتمويلية أمام المصارف العربية.
وتستند هذه المقابلة إلى تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025، الذي يدعو إلى إحداث تحوّل حاسم عبر إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين، يهدف إلى مواءمة النظام المالي العالمي مع الأسس الإقتصادية الحقيقية للقارّة، وتعزيز دورها كمحرّك رئيسي للنمو والإستقرار في الإقتصاد العالمي.
وفي لمحة مختصرة عن تقرير أفريقيا – مجموعة العشرين 2025:
يشكّل تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025 محطّة مفصلية في مقاربة الدور الإقتصادي للقارّة الأفريقية، إذ يؤكد أن أفريقيا لم تعد طرفاً هامشياً في الإقتصاد العالمي، بل باتت أحد المراكز الرئيسية المحتملة للنمو العالمي خلال العقود المقبلة، مدفوعةً بدينامية ديموغرافية فريدة، وإمكانات طاقوية هائلة، وفرص إستثمار تُعدّ من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم.
غير أن التقرير يسلّط الضوء على مفارقة هيكلية لافتة، إذ رغم متانة الأسس الإقتصادية، لا تزال أفريقيا تواجه قيوداً حادّة ناجمة عن الإرتفاع المفرط في كلفة رأس المال، وتزايد الضغوط المرتبطة بالديون السيادية، وقصور في بنية النظام المالي الدولي، ما يؤدي إلى تضخيم كلفة التمويل والحدّ من الإستثمار المنتج.
إزاء هذا الواقع، يدعو فريق الخبراء إلى إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين، يرتكز على أربعة محاور بنيوية رئيسية:
- إعتماد مقاربة شاملة وإستباقية لإدارة الدين، تتجاوز منطق إعادة الجدولة التقليدية؛
- تعزيز دور المصارف متعدّدة الأطراف والإقليمية للتنمية بهدف تعبئة مزيد من التمويلات طويلة الأجل؛
- إصلاح القواعد المالية الدولية، ولا سيما في مجالات تصنيف المخاطر والتنظيم الإحترازي؛
- إطلاق جهد إستثماري واسع النطاق في مجالات الإستثمار المنتج، والبنى التحتية، والطاقة، والتكامل الإقليمي والإبتكار.
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية العربية، تفتح هذه التوجُّهات آفاقاً إستراتيجية واعدة، إذ يُبرز التقرير أهمية تعميق التعاون المالي بين أفريقيا والعالم العربي، وتفعيل أدوات مثل تمويل المشاريع، وتمويل التجارة، والتمويل الإسلامي، وآليات التمويل الممزوج (Blended Finance)، بما يُسهم في مواكبة التحوُّل الاقتصادي للقارّة وتقاسم الفرص التي يتيحها.
وهنا نص المقابلة الحصرية:
* يؤكد التقرير، أن زيادة الإنتاجية في أفريقيا تُعدّ أحد أبرز المحرّكات المحتملة للإزدهار العالمي في القرن الحادي والعشرين، كيف تفسّرون هذه الخلاصة؟ وما هي برأيكم إنعكاساتها العملية على الدور الإقتصادي والإستراتيجي الذي تضطلع به أفريقيا اليوم؟
– نحن أمام تحوّل جذري في نموذج النمو الإقتصادي في أفريقيا تاريخياً، إذ كان نمو القارّة مدفوعاً بتراكم عوامل الإنتاج، أي زيادة اليد العاملة ورأس المال، أكثر من إعتماده على تحسّن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. غير أنّ هذا النموذج بلغ حدوده، إذ تمثّل أفريقيا نحو 17 % من سكان العالم، لكنها لا تسهم بأكثر من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولا يعكس هذا الفارق نقصاً في الإمكانات، بل ضعف الإستثمار في محرّكات الإنتاجية، ولا سيما البنى التحتية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا .أما الفرصة الجديدة، فتكمن في التقنيات المتقدّمة، حيث تمتلك أفريقيا نحو 60 % من إمكانات الطاقة الشمسية عالية الجودة عالميًا، وحوالي 30 % من المعادن الحيوية اللازمة للتحوُّل العالمي في مجال الطاقة.
إذا نجحت أفريقيا في رفع مستوى الإنتاجية، فإن ذلك سيُعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر أثر مضاعِف، يُترجم إلى فرص عمل جديدة، وإرتفاع في مستويات الدخل، وتوسّع في الحيّز المالي. ولن تكون هذه الدينامية معزولة عن محيطها، ففي وقت يبحث فيه الإقتصاد العالمي عن محرّكات جديدة للطلب والنمو الأخضر، تمثّل التحوّلات الهيكلية في أفريقيا فرصة مشتركة للإقتصاد العالمي بأسره. نحن نلمس هذا الإمكان اليوم، غير أن تحويله إلى واقع يتطلّب إلتزاماً واضحاً برفع الإنفاق الوطني على البحث والتطوير إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. فإزدهار الإقتصاد العالمي يحتاج إلى محرّكات جديدة للطلب، وتُعدّ أفريقيا المنتِجة والمُصنَّعة أكبر محرّك متاح حالياً.
والرسالة هنا واضحة: الإزدهار العالمي لا يتحقق إلاّ من خلال إزدهار شامل، وأفريقيا، إذا ما حظيت بالتمويل الكافي وتم دمجها بفعّالية في سلاسل القيمة، قادرة على الإسهام في تحقيق ذلك على نحو حاسم.
* يدعو التقرير إلى إطلاق مبادرة جديدة لإعادة تمويل الديون تحت مظلة مجموعة العشرين، بدل الإكتفاء بإعادة الجدولة، لماذا يُعدّ خيار إعادة التمويل أكثر ملاءمة في هذه المرحلة بالنسبة إلى البلدان الأفريقية منخفضة الدخل؟
نحن نواجه مشكلة في السيولة، وليس مجرّد مشكلة تتعلق بالملاءة المالية، ففي العام 2025 وحده، واجهت أفريقيا أعباء ديون خارجية بلغت89 مليار دولار أميركي، في حين يُقدَّر المبلغ المستحق حالياً لعام2026 بنحو 85 مليار دولار. علماً أن إعادة الجدولة لا تؤدي سوى إلى تأجيل عبء الدين، وغالباً ما يكون ذلك بمعدّلات فائدة أعلى.
ما نحتاجه فعلياً هو إعادة هيكلة إستباقية للدين (Ex-ante debt reprofiling)، أي إدارة الإلتزامات قبل الوصول إلى حالة التعثّر، بما يتيح إستعادة هامش الحركة المالية وتفادي الأزمات.
* كيف يُمكن لتعزيز شفافية وجودة البيانات، إلى جانب تطوير منهجيات التصنيف الإئتماني، أن يساهما في خفض كلفة الإقتراض في أفريقيا؟
تتحدّد كلفة رأس المال أساساً من خلال تسعير المخاطر، فيما يعتمد تسعير المخاطر بدوره على جودة المعلومات المتاحة، غير أن علاوة المخاطر الحالية المفروضة على أفريقيا لا تستند إلى الأسس الإقتصادية الحقيقية، إذ تُظهر تحليلاتنا أن الدول الأفريقية تتحمّل تكاليف إقتراض أعلى بكثير مقارنة بدول ذات أوضاع إقتصادية كلية مماثلة، وذلك حصرياً نتيجة تحيّزات قائمة على التصوّر والإنطباع لا على الوقائع.
وفي المقابل، تُسجّل مشاريع البنية التحتية في أفريقيا المدعومة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عوائد لافتة، إذ يبلغ متوسط عائدها نحو خمسة أضعاف عائد مؤشرS&P 500 ، كما تُظهر البيانات أن معدّلات التعثّر في هذه المشاريع الكبرى في الدول النامية، بعد دخولها مرحلة التشغيل، لا تتجاوز معدّلات التعثّر المسجّلة على ديون الشركات المصنّفة ضمن فئة الإستثمار الآمن (BBB-) في الإقتصادات ذات الدخل المرتفع. ويستند هذا الإستنتاج إلى أكثر من 30 عاماً من البيانات الصادرة عن إتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMS)، والذي قام بتحليل ما يقارب15 ألف قرض.
تتحمّل أفريقيا ما يمكن وصفه بـ «ضريبة نقص الشفافية»، إذ يعوّض المستثمرون في كثير من الأحيان عن التصوّر بوجود فجوات معلوماتية من خلال المطالبة بعوائد أعلى. علماً أن تعزيز شفافية البيانات الإقتصادية الكلية والمالية، إلى جانب بيانات المشاريع، يُسهم تدريجياً في تقليص فروق العوائد، غير أنّ هذه الضريبة الخفية تؤدي عملياً إلى إستنزاف مليارات الدولارات التي كان يُمكن توجيهها إلى قطاعات أساسية كالصحة والتعليم. والحل في جوهره هيكلي، إذ يتمثّل في بناء منظومة بيانات أكثر موثوقية وتوازناً. وفي هذا السياق، يجري العمل على إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الإئتماني، تهدف إلى تقديم تقييم موضوعي ومراعٍ للسياق الواقعي لمخاطر الدين السيادي، بما يُسهم في تصحيح التحيّزات القائمة في منظومة التصنيف الدولية.
ولا يقلّ أهمية عن ذلك إصلاح منهجيات التصنيف الائتماني، التي تميل في كثير من الأحيان إلى المبالغة في إبراز مواطن الضعف الخارجية مقابل التقليل من وزن الإصلاحات والسياسات المنفّذة، فعلى سبيل المثال، نجحت دول أفريقية عدّة في تحقيق فوائض أولية وتنفيذ إصلاحات جوهرية، ومع ذلك بقيت تصنيفاتها الإئتمانية على حالها دون تغيير.
إضافة إلى ذلك، ومن خلال تعزيز الرقابة التنظيمية، يتعيّن على وكالات التصنيف الإئتماني مراجعة منهجياتها بما يضع حداً لمعاقبة الإستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية عبر تصنيفها على أنها مخاطر سيولة قصيرة الأجل.
إن تحسين جودة البيانات، مقروناً بتقييمات أكثر اتساقًا وشفافية، سيُفضي إلى تكاليف إقتراض أكثر عدالة، وأن يشكّل في الوقت نفسه حافزاً لإعتماد سياسات مالية واقتصادية رشيدة.
* ما هي المتطلّبات الأساسية التي ينبغي إستكمالها لتمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) من تحقيق كامل إمكاناتها الإقتصادية؟
بحسب تقديراتنا الواردة في التقرير الإقتصادي عن أفريقيا لعام 2024، تمتلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) القدرة على زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسبة تصل إلى 45 % في حلول العام 2045، ولكن ذلك يظلّ مشروطاً بمعالجة مجموعة من العوامل التمكينية الأساسية.
أولًا: البنية التحتية
إن الفجوات القائمة في النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تجعل كلفة التجارة في أفريقيا أعلى بنحو 50 % من المتوسط العالمي، وفق بيانات الأونكتاد (UNCTAD)ما يحدّ من القدرة التنافسية، لا سيما في الدول غير الساحلية. ويُعدّ الإستثمار في الخدمات اللوجستية والربط الرقمي عنصراً حاسماً لتحرير إمكانات النمو.
ثانيًا: المواءمة التنظيمية
إن تبسيط المعايير والإجراءات الجمركية وأنظمة حماية الإستثمار يُخفّض الحواجز غير الجمركية، ويُسهم في خلق حجم سوق قاري فعلي قادر على جذب الإستثمارات وتعزيز التكامل.
ثالثًا: القدرات الإنتاجية
سيبقى أثر الإتفاق محدودًا ما لم تتوافر منظومات قوية للصناعة التحويلية والتصنيع الزراعي، ويُعدّ الدعم الموجّه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق والحدائق الصناعية، إلى جانب تنمية المهارات، عناصر أساسية لضمان نجاح الإتفاق وتحقيق أهدافه التنموية.
رابعا: خفض تكاليف المعاملات
يُتيح النظام الأفريقي الشامل للدفع والتسوية (PAPSS) إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ما يُمكن أن يخفّض تكاليف المعاملات بما يقارب النصف. غير أنّ ذلك يتطلّب بالتوازي تسريع تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية بهدف إنشاء سوق رقمية موحّدة على مستوى القارّة، فعندما نزيل عوائق تحويل العملات ونوحّد القواعد الرقمية، لا نكتفي بتبادل السلع، بل نؤسّس سلاسل قيمة إقليمية قادرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية.
وتُعدّ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) في جوهرها إصلاحاً هيكلياً وبوليصة تأمين في مواجهة تفتّت الإقتصاد العالمي. غير أن ترجمة فوائدها إلى واقع ملموس تستدعي تنسيقاً مؤسسيًاً فعّالاً، وتمويلاً كافياً، وتنفيذاً متواصلاً ومثابراً. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية وتنامي الحمائية في أسواق شريكة رئيسية، مثل الولايات المتحدة، يبقى التجارة البينية الأفريقية خط الدفاع الأكثر موثوقية لتعزيز صمود الإقتصادات الأفريقية.
* ما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) وغيرها من مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية، في ظل تراجع التمويلات الميسّرة؟
تتمتع مؤسسات مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بموقع فريد يؤهلها لسدّ فجوات التمويل، إذ تجمع بين المعرفة العميقة بالسياقات المحلية والمصداقية العالية لدى الأسواق، ولا سيما في ظل التراجع الحاد في المساعدات الإنمائية الثنائية، التي إنخفضت بنحو 70 % في قطاعات أساسية مثل الصحة.
وفي هذا الإطار، ينبغي أن تركّز هذه المؤسسات على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعظيم الرافعة المالية: توسيع إستخدام الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر، بحيث يتمكّن كل دولار من رأس المال القابل للاستدعاء من تحفيز أضعافه من التمويل الخاص.
- تحقيق الأثر بالحجم المناسب: إعادة رسملة النوافذ التمويلية الميسّرة، مثل صندوق التنمية الأفريقي (ADF) لضمان إستمرار نفاذ الدول الهشّة إلى التمويل ودعم جهود التكيّف مع تغيّر المناخ.
- الإبتكار المالي: الإضطلاع بدور ريادي في تطوير أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك السندات المرتبطة بالإستدامة، ومنصّات التمويل الممزوج (Blended Finance)، إلى جانب بناء محافظ مشاريع قابلة للتوسّع لتمويل البنية التحتية الخضراء.
في ظل ركود تدفقات التمويل الميسّر على المستوى العالمي، يتعيّن على مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية أن تتحوّل إلى جهات فاعلة في الصفوف الأمامية، وأن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس إلى جانب الإبتكار المالي. ولضمان دعم أكثر توحيداً وقوة لمسار التنمية في أفريقيا، يُصبح من الضروري تعزيز التعاون وخلق مزيد من التكامل والتآزر بين مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى الإسراع في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو البنوك متعدّدة الأطراف للتنمية، مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على شكل رأس مال هجين. ويُتيح هذا الإجراء تحويل كل دولار من حقوق السحب الخاصة إلى ما بين ثلاثة وأربعة دولارات من الإقراض الجديد. وهو نهج مُجرَّب وغير تضخمي لتوسيع ميزانيات هذه المؤسسات، من دون تحميل ميزانيات المساهمين أعباءً إضافية.
* ما هي، برأيكم، الإجراءات الثلاثة الأكثر إلحاحًا التي ينبغي على مجموعة العشرين والقادة الأفارقة إتخاذها في المرحلة الراهنة؟
نحن بحاجة إلى الإنتقال من التشخيص إلى التنفيذ، إذ إن تعثّر مسار التنمية قد يؤدي إلى خسائر تنموية تراكمية يصعب تداركها قد تُضعِف آفاق أفريقيا بشكل دائم.
أولاً: تفعيل آلية عملية لإعادة تمويل الديون لصالح البلدان الأكثر هشاشة، تركّز على خفض كلفة التمويل، وإطالة آجال الإستحقاق، وربط تخفيف عبء الدين بالإستثمار في بناء القدرة على الصمود. كما يجب أن يكون إطار مجموعة العشرين المشترك بصيغته المُعاد إصلاحها محدّداً زمنياً وشفافاً، وأن يتضمن تعليقاً تلقائياً لخدمة الدين فور تقدّم الدولة بطلب الإنضمام.
ثانياً: تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف عبر الإلتزام بتحسين كفاءة الميزانيات العمومية، ورفع حصة الضمانات إلى ما بين 20 و25 %، ومراجعة الأطر التنظيمية التي تُثقل كاهل الإقراض للمشاريع الأفريقية ذات الأثر المرتفع. وفي هذا السياق، يجب إعطاء أولوية قصوى لإعادة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، إلى جانب قيادة جهود رسملة بنوك التنمية متعددة الأطراف، إذ تحتاج أفريقيا إلى مستويات أعلى بكثير من التمويل الميسّر لمواكبة حجم أزمتي المناخ والتنمية، بما يفوق بكثير ما هو متاح حالياً.
ثالثًا: ترسيخ الحضور المؤسسي لأفريقيا في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وينبغي أن يُترجَم مقعد الإتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين إلى قدرة فعلية على التأثير في السياسات، ولا سيما في ملفّات التجارة الدولية، وإدارة الديون السيادية، وقواعد تمويل العمل المناخي.
رابعاً: الإستثمار في إقتصاد البيانات، إذ يتعيّن التعامل مع البنية التحتية الرقمية، مثل مراكز البيانات وشبكات النطاق العريضBroadband بوصفها أصولًا سيادية. لذا من الضروري الإمتلاك والتحكّم في البنية التحتية التي ستُشكّل الأساس لنمو قطاعات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في المستقبل.
إن نافذة الإصلاح ضيّقة، فالخطوات التدريجية لن تكون كافية لسدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا المقدّرة بنحو 1.3 تريليون دولار. في هذا السياق، المطلوب، تحرّك هيكلي شامل يُوفّق بين إمكانات أفريقيا الكامنة ومتطلّبات الإستقرار الإقتصادي العالمي.
(المصدر: إتحاد المصارف العربية)

Revue UBA: L’EXCELLENCE EN FINANCE ET ECONOMIE
 Revue UBA:
Revue UBA:
L’EXCELLENCE EN FINANCE ET ECONOMIE
au Maghreb et dans le Monde Arabe Fondee en 2022
Revue UBA
est la publication francophone de référence de l’Union des Banques Arabes, conçue comme une plateforme stratégique de dialogue entre le secteur bancaire arabe et ses partenaires régionaux et internationaux. À travers ses éditions thématiques, ses contributions d’experts de haut niveau et ses entretiens exclusifs avec des leaders institutionnels, la Revue UBA favorise le partage de connaissances, la coopération interrégionale et la mise en valeur des initiatives bancaires innovantes. Elle constitue un vecteur privilégié de visibilité pour les institutions financières, les organisations internationales et les partenaires engagés dans le développement économique durable, la stabilité financière et l’intégration des marchés.
À Propos de la Revue
Revue phare de l’Union des Banques Arabes (UBA), la Revue UAB se distingue par son engagement à fournir un contenu de qualité exceptionnelle sur l’économie, la finance, et l’innovation technologique. Avec des analyses rigoureuses et des perspectives enrichissantes, elle s’adresse aux décideurs, banquiers, chercheurs, et économistes des pays du Maghreb et du monde arabe.
Mission et Vision
La Revue UAB aspire à devenir une référence incontournable pour :
- Partager les meilleures pratiques bancaires et financières.
- Soutenir l’innovation et le développement économique durable.
- Offrir une plateforme d’échanges pour les professionnels et les institutions du secteur.
Diffusion et Accessibilité
- Tirage : 1 000 exemplaires par numéro, avec une distribution ciblée auprès des banques membres de l’UBA, des institutions gouvernementales et régionales, ainsi que lors des grandes conférences internationales de l’UBA.
- Format : Disponible en version papier, numérique, et par abonnement annuel.
Contactez-Nous
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre :
Téléphone : +961 1 377800 / +961 1 364885-7
Email : [email protected]
Sur la base de toutes les informations recueillies, découvrez l’éditions complète via le lien ci-dessous à tous les numéros publiés en 2025 :
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2026/01/Index-revue-2025-compressed-1.pdf
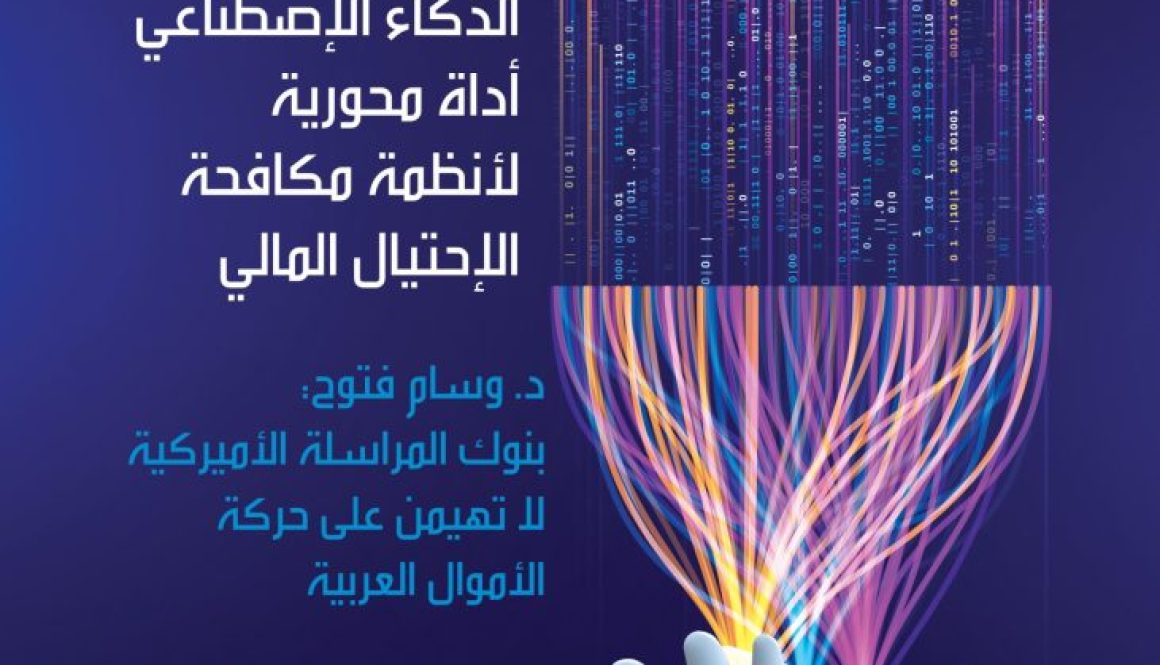
العدد 542 كانون الثاني 2026

بنوك المراسلة الأميركية لا تُهيمن على حركة الأموال العربية
بنوك المراسلة الأميركية لا تُهيمن على حركة الأموال العربية
والعملات الرقمية للبنوك المركزية تُعدُّ أداة رسمية للمدفوعات

ولا شك في أن بنوك المراسلة الأميركية تقوم بعمليات «العناية الواجبة» لأي تحويل مالي، للتحقُّق من خلوّها من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو فساد، ما يُسهم في خلق نظم مالية مستقرة ومنتظمة. علماً أن المصارف العربية يجب أن تلتزم القوانين الدولية الصارمة في هذا المجال، وأن البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُعزّز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي.
إن دور البنك المراسل إيجابي لكنه مكلف في الوقت نفسه، إذ يتعيّن على البنك الذي يتعامل معه، أي البنك المستفيد أو المجيب، الإلتزام الكامل بجميع القوانين والأنظمة المرعية. كما أن الإلتزام بهذه المعايير يضمن وصول المعاملات المالية إلى الأسواق العالمية بسلاسة، ويجنّب البنوك أي مخاطر مرتبطة بالعقوبات أو الرقابة الدولية، ما يحافظ على إستقرار النظام المالي ويحدّ من المخاطر التشغيلية.
أما عن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، فإنها تصدر فعلياً عن البنك المركزي ومدعومة منه، وتختلف عن العملات المشفّرة مثل البتكوين، التي تُعدُّ سلعة وليست وسيلة دفع قانونية عامة. علماً أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تُعد أداة رسمية للمدفوعات، مدعومة بحسابات مصرفية فعلية، لكنها لا تشكل بديلاً عن عمليات التسوية والمقاصة التي تنفذها بنوك المراسلة التقليدية، على الأقل في المرحلة الحالية.
من جهة أخرى، في ما يخص مشروع «بُنى»، فإنها منصّة ممتازة أنشأتها البنوك المركزية العربية برعاية صندوق النقد العربي، وتختص بالمقاصة الإقليمية داخل الدول العربية وليست الدولية. وتُتيح المنصّة تسوية المدفوعات بين الدول العربية بفعّالية، مع الإلتزام الكامل بجميع القوانين الدولية المعمول بها، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات بازل. علماً أن منصّة «بُنى» معترف بها دولياً، وتمتلك تواصلاً مباشراً مع الجهات الرقابية العالمية، وتطبّق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، ما يُعزّز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي، ويُسهم في تقليل الإعتماد على آليات التسوية الدولية بالدولار عند الحاجة. كما أن بنوك المراسلة الأميركية تُسهم في الإستقرار والإنتظام المالي العالمي، وأن الهيمنة الفعلية على الأموال العربية تعود إلى إعتماد الدولار عملة رئيسية في التجارة الدولية، وليس لبنوك المراسلة دور إستراتيجي في فرض السيطرة السياسية.
ويبرز كذلك أن العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصّة «بُنى» تشكل بدائل مهمة لتسهيل المدفوعات الإقليمية، لكنها لا تزال مكملة للنظام القائم ولا تشكل تهديداً مباشراً للدولار أو للبنية التحتية المالية التقليدية. ويعكس هذا التوجُّه نهجاً متوازناً بين الإستفادة من الإستقرار العالمي الذي توفّره بنوك المراسلة الأميركية، وبين تطوير أدوات إقليمية حديثة لتعزيز السيولة والمرونة المالية في العالم العربي، بما يدعم الإستقلال المالي التدريجي من دون الإخلال بالإندماج في النظام المالي الدولي.

مصارف البحرين عضواً في لجنة المصارف الإسلامية لدى إتحاد المصارف العربية
«مصارف البحرين» عضواً في لجنة المصارف الإسلامية
لدى إتحاد المصارف العربية

ويُمثّل جمعية مصارف البحرين في عضوية اللجنة كل من الدكتور عبدالناصر عمر آل محمود، رئيس لجنة المعايير المصرفية الإسلامية والشرعية في جمعية مصارف البحرين، والدكتور حمد فاروق الشيخ، نائب رئيس لجنة المعايير المصرفية الإسلامية والشرعية في الجمعية.
ومن خلال هذه المشاركة، تدعم جمعية مصارف البحرين عمل لجنة المصارف الإسلامية لدى إتحاد المصارف العربية في مناقشة التحدّيات المشتركة التي تواجه المصارف الإسلامية، وإقتراح حلول عملية تُعزّز الإستدامة والحوكمة والإمتثال الشرعي، إلى جانب دعم الإبتكار في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بما يُواكب المتغيّرات الإقتصادية والتقنية في المنطقة.

من جهته ، أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، «أن إنضمام جمعية مصارف البحرين إلى عضوية لجنة المصارف الإسلامية يُشكّل إضافة نوعية ومهمة لأعمال اللجنة، لما تتمتع به مملكة البحرين من خبرة عريقة ومكانة ريادية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي»، موضحاً «أن الإتحاد يعمل على إطلاق لجنة المصارف الإسلامية كإطار مؤسسي متخصّص يهدف إلى تلبية إحتياجات القطاع المصرفي والمالي الاسلامي، وتطويره ودعم قدراته البشرية بأعلى المؤهلات والكفاءات وفق أعلى المعايير التنافسية، وإعداد مادة علمية متخصّصة تقدم بموجبها شهادات مهنية معتمدة دولياً لإعداد خبراء في مجالات الصيرفة والتمويل الاسلامي».


بنك الشام بفوز بجائزة «الريادة في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوريا لعام 2025»
منحها له الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت
بنك الشام بفوز بجائزة
«الريادة في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوريا لعام 2025»

 أعرب بنك الشام عن فخره بإعلان فوزه بجائزة «الريادة في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوريا لعام 2025»، التي منحها له الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال حفل أُقيم في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا، في العاصمة اللبنانية بيروت.
أعرب بنك الشام عن فخره بإعلان فوزه بجائزة «الريادة في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوريا لعام 2025»، التي منحها له الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال حفل أُقيم في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الشام، السيد أحمد يوسف اللحام: «إن هذه الجائزة تعكس إلتزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، ونسعى دائماً إلى تحقيق تطلُّعات عملائنا والمساهمة في تنمية الإقتصاد السوري، حيث إختُتم العام 2025 بهذا النجاح المميّز، ونتطلّع إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال العام 2026».

خلاصة مسار أبرز الأحداث المصرفية والاقتصادية – 2025
فهرس الأعداد لعام 2025
خلاصة مسار أبرز الأحداث المصرفية والاقتصادية
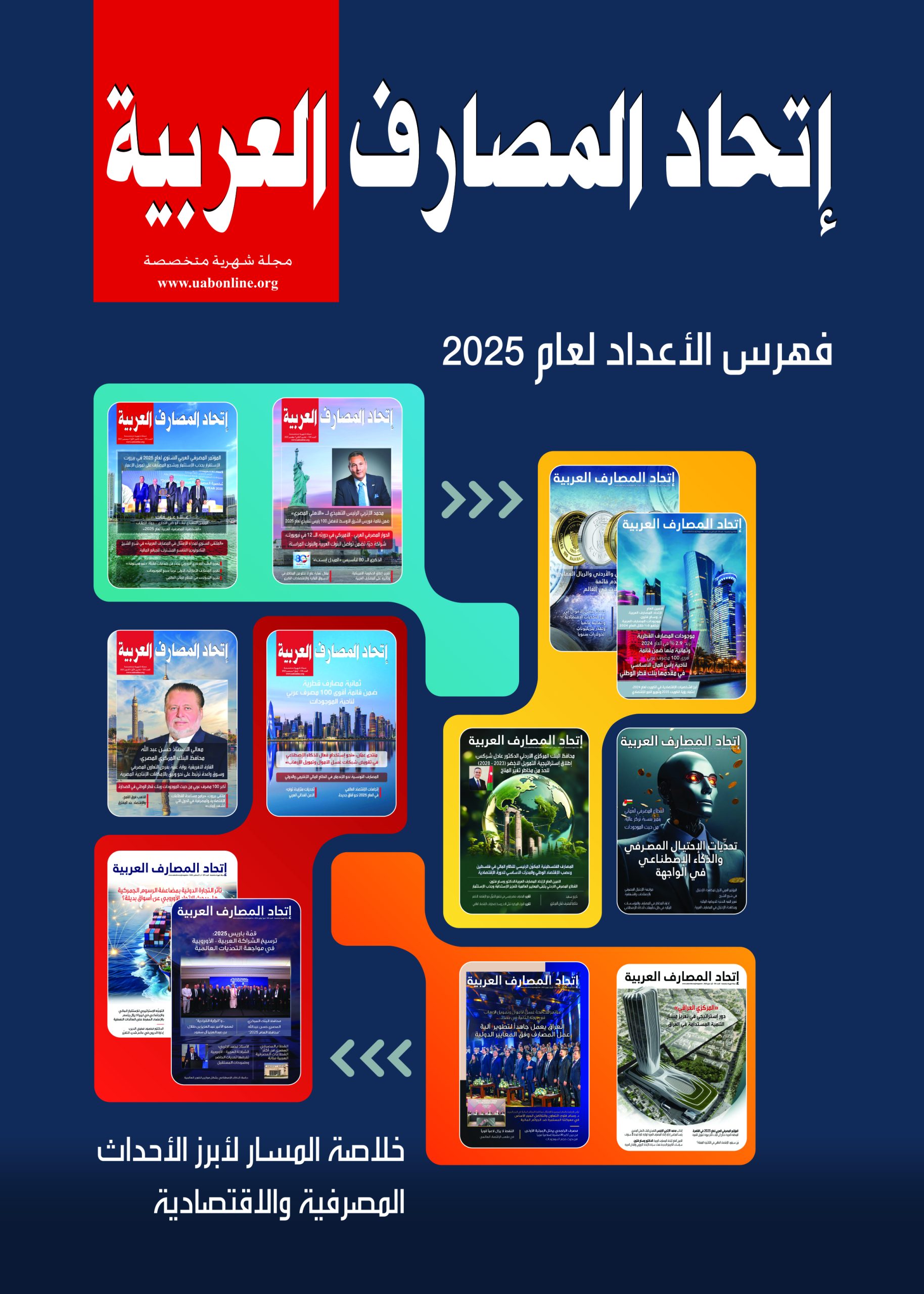
وخلال عام 2025، ركّزت المجلة على إعداد دراسات حديثة وتقارير معمّقة تناولت أبرز القضايا المصرفية والاقتصادية، مستندة إلى أسس علمية ومنهجيات تحليلية رصينة، أسهمت في دعم الحوار الاقتصادي، وتعزيز الثقافة المالية، وتسليط الضوء على الابتكار المصرفي، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطور السياسات النقدية والمالية.
وانطلاقاً من إيمان المجلة بأهمية التكامل والتعاون في تطوير المشهد الإعلامي والاقتصادي، فإنها تدعو قرّاءها الكرام، والمؤسسات المصرفية والاقتصادية، والخبراء والمختصين، إلى المشاركة الفاعلة من خلال الإعلانات، أو تزويد المجلة بالأخبار والتقارير الإعلامية، أو الإسهام بالمقالات والدراسات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة ويدعم بناء محتوى هادف يخدم المصلحة العامة.
ويأتي هذا الفهرس السنوي ليكون مرجعاً توثيقياً لما نُشر خلال العام، ودعوة مفتوحة لشراكة إعلامية مثمرة، ونرجو من خلالها بأن التعاون البنّاء هو السبيل نحو مزيد من التطور والتميّز، وتحقيق الأفضل للقطاعين المصرفي والاقتصادي.
وعليه، تتشرف مجلة إتحاد المصارف العربية بدعوتكم للمشاركة في أعدادها المميزة والخاصة في عام 2026 ، وموافاتنا بتطورات مصرفكم الموقر ومشاركتكم الإعلانية،مع العلم أن أعدادنا توزع على البنوك والمؤسسات العربية، والمشاركين خلال أعمال جميع المؤتمرات التي سيعقدها الاتحاد خلال العام، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للمجلة.
ولكم منا كل التقدير والاحترام.
لمزيد من المعلومات الاتصال بمجلة إتحاد المصارف العربية:
Rona Bou Assi – Magazine Department
E: [email protected] – [email protected]
M: +96171575724

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2026/01/index-magazine-A-UAB-2025-compressed-1.pdf


Union des Banques Arabes: Une année d’impact, de partenariats et un message d’espoir pour l’année à venir
Union des Banques Arabes:
Une année d’impact, de partenariats et
un message d’espoir pour l’année à venir

L’année à venir s’inscrira dans une dynamique renforcée en faveur du développement durable. Du partenariat historique avec la Banque mondiale en faveur du financement des PME, jusqu’au lancement en cours de préparation, avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), de la SME Digital Platform Initiative (DPI), l’UBA consolidera son rôle de catalyseur de l’inclusion financière et de l’investissement productif. En parallèle, sa coordination avec les agences des Nations Unies se renforcera autour des Objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de l’énergie, des systèmes alimentaires, de la transformation numérique et de la biodiversité.
Point d’orgue attendu de cet engagement: la poursuite de l’objectif de mobilisation d’un trillion de dollars d’ici 2030, en partenariat avec la CESAO, pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans les 22 pays arabes.
Sur le plan de la gouvernance et de la lutte contre la criminalité financière, l’UBA continuera d’exercer son leadership régional à travers le Dialogue bancaire arabo-américain, en partenariat avec la Réserve fédérale et le Trésor américain, ainsi que par son rôle fondateur au sein du MENA Financial Crime Compliance Group (MENA-FCCG). Les programmes de formation, conférences et accords de coopération avec le MENA-FATF, les cellules de renseignement financier et le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se poursuivront afin de renforcer durablement la culture de conformité, de transparence et d’intégrité financière dans la région.

L’autonomisation économique des femmes et des jeunes demeurera un pilier stratégique majeur. Aux côtés de l’OCDE et de l’Union pour la Méditerranée, l’UBA poursuivra ses initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Le déploiement attendu de la compétition régionale InspireHer, lancée en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, continuera d’incarner une plateforme structurante pour soutenir les femmes entrepreneures et renforcer l’inclusion financière à l’échelle régionale.
À la veille de cette nouvelle étape, l’Union des Banques Arabes réaffirme sa vocation de plateforme fédératrice du secteur bancaire arabe, au service de la stabilité financière, de la croissance inclusive et du développement durable. Plus que jamais, l’UBA entend s’inscrire comme un acteur stratégique au cœur des transformations économiques de la région.
Dans cet esprit, l’équipe éditoriale de la Revue UBA adresse ses vœux les plus sincères à l’ensemble de ses lecteurs, partenaires, contributeurs et à toute la grande famille bancaire arabe. Que l’année à venir soit porteuse de stabilité, de confiance renouvelée, d’innovations fécondes et de succès partagés. Nous formons le vœu que les défis se transforment en opportunités et que les projets portés par l’Union continuent de rayonner au service du développement durable, de l’inclusion financière et de la prospérité des économies arabes.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Success Story – InspireHer
Success Story – InspireHer
 Dans le dossier consacré aux finalistes du concours InspireHer, nous avons le plaisir de vous présenter le parcours inspirant de Bara’ Abu Sharefeeh, lauréate du 2e prix dans la catégorie Established Business.
Dans le dossier consacré aux finalistes du concours InspireHer, nous avons le plaisir de vous présenter le parcours inspirant de Bara’ Abu Sharefeeh, lauréate du 2e prix dans la catégorie Established Business.
Coach You : rendre le coaching accessible dans le monde arabe
Dans un monde professionnel en constante mutation, l’accès au développement personnel et au coaching reste souvent réservé à une élite.
Pourtant, la région arabe regorge de talents, notamment parmi les jeunes et les femmes, qui manquent encore d’un accompagnement adapté à leur langue, leur culture et leurs réalités. C’est pour répondre à ce besoin que la plateforme Coach You a vu le jour, portée par une vision claire: démocratiser le coaching de qualité dans le monde arabe.

En quelques années, Coach You est devenue un partenaire de référence pour de grandes institutions publiques et privées en Jordanie et dans la région MENA, parmi lesquelles le Ministère de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat (MoDEE), Housing Bank, Orange, Banque Misr, USAID, Flat6Labs et Endeavor. À ce jour, la plateforme a délivré plus de 15 000 heures de coaching à plus de 3 500 bénéficiaires, dont près de 60 % de femmes, avec des taux de satisfaction dépassant 85 %.

En parallèle de son impact social, Coach You valorise également les femmes coachs de la région, en leur offrant un espace digital de visibilité, de travail flexible et de rayonnement transfrontalier.
La participation de Coach You au programme InspireHer et à l’événement de Palerme a marqué un tournant décisif, apportant reconnaissance internationale, nouvelles opportunités de partenariats et renforcement de son positionnement comme acteur régional de la transformation humaine par le coaching.
Aujourd’hui, Coach You poursuit son développement à l’intersection du digital, de l’intelligence artificielle et de l’humain, avec l’ambition de toucher des dizaines de milliers de bénéficiaires dans toute la région MENA, et de faire du coaching un véritable levier stratégique de performance, d’inclusion et de bien-être.

l’UAB et l’ICC renforcent la formation des juristes arabes
Un programme d’arbitrage international dédié au secteur bancaire:
l’UAB et l’ICC renforcent la formation des juristes arabes
Dans le cadre de son engagement à accompagner le secteur bancaire arabe dans les pratiques juridiques internationales les plus avancées, l’Union des Banques Arabes (UAB) lance, en partenariat avec la Chambre de Commerce Internationale (ICC) – Dispute Resolution Services, un programme de formation inédit consacré au « International Commercial and Banking Arbitration ».
Ce programme spécialisé, conçu sur la base du PIDA Training de l’ICC et adapté aux besoins des professionnels du secteur financier, propose une immersion complète dans les mécanismes de l’arbitrage international, de la rédaction de la requête jusqu’à la simulation d’un tribunal arbitral.
Deux sessions, deux capitales internationales
Le programme se déploie en deux volets complémentaires :
• Riyad – 13 au 15 janvier 2026
Une formation introductive sur les fondements de l’arbitrage selon les règles de l’ICC, les spécificités de l’arbitrage dans le secteur bancaire, les modes alternatifs de règlement des différends (ADR), ainsi que les étapes clés de la constitution d’un tribunal arbitral.
• Paris – 12 et 13 mai 2026
Une session avancée comprenant une simulation d’audience, l’étude approfondie du processus de « scrutiny » des sentences arbitrales, et un éclairage sur l’exécution des sentences étrangères.
 Un programme bilingue avec certification conjointe
Un programme bilingue avec certification conjointe
Dispensé en arabe et en anglais, le séminaire offre aux participants une double perspective juridique, conciliant pratique régionale et standards mondiaux.
À l’issue du programme, une certification conjointe UAB–ICC sera remise aux participants ayant validé l’ensemble des sessions, attestant de leur maîtrise des procédures d’arbitrage international.
Avec cette initiative, l’UAB confirme une nouvelle fois son rôle stratégique dans la montée en compétences des cadres bancaires arabes et dans la diffusion des meilleures pratiques internationales en matière d’arbitrage et de gouvernance juridique.

La Finance Durable en Mouvement: 33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes pour les ODD en 2024
La Finance Durable en Mouvement:
33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes
pour les ODD en 2024
Une première enquête régionale qui révèle progrès,
déséquilibres et perspectives d’accélération
Dans le cadre de son engagement à suivre et à renforcer la contribution du secteur bancaire arabe aux Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Union des Banques Arabes (UAB), en partenariat avec la CESAO (ESCWA), a mené en 2024 une enquête pionnière sur les crédits mobilisés au profit du développement durable. Il s’agit du premier exercice régional permettant d’évaluer, chiffres à l’appui, l’alignement des institutions financières arabes sur les priorités de l’Agenda 2030. Cette étude met en lumière 33,9 milliards USD de financements ODD, tout en dévoilant des écarts persistants dans l’allocation du crédit, notamment en matière d’égalité de genre, de soutien aux jeunes entrepreneurs, de transformation digitale et d’environnement. Elle constitue désormais une base essentielle pour orienter les politiques publiques, renforcer les partenariats et développer des solutions financières durables à grande échelle.

Les vingt-deux banques participantes ont déclaré un total de 33,9 milliards USD de prêts alignés sur les ODD, soit 18 % de leurs portefeuilles de crédit.
La répartition montre une forte concentration des financements vers le secteur public :
• 76 % (25,9 Mds USD) destinés aux gouvernements et entreprises publiques
• 19 % (6,3 Mds USD) attribués aux grandes entreprises
• 5 % (1,7 Md USD) alloués aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
Quatre domaines absorbent près de 70 % des financements :
• Éradication de la pauvreté et protection sociale (ODD 1) : 11,2 Mds USD
• Logement durable (ODD 11) : 6,4 Mds USD
• Industrie durable (ODD 9) : 2,7 Mds USD
• Tourisme durable (ODD 8 & 12) : 2,4 Mds USD
À l’inverse, des enjeux cruciaux de développement restent très insuffisamment financés:
• Égalité femmes-hommes (ODD 5): 135 M USD
• Transformation digitale (ODD 9): 64 M USD
• Environnement et biodiversité (ODD 14 & 15): 56 M USD
• Paix, justice et institutions solides (ODD 16): 0 USD
Inclusion financière : un décalage notable entre politiques et impact réel
Si de nombreux établissements déclarent soutenir l’inclusion financière, les résultats montrent que ces engagements peinent encore à se traduire en crédits effectifs:
• 43 % des banques offrent des programmes pour les femmes entrepreneures, mais les femmes ne reçoivent que 14 % du crédit MPME (1 Md USD), contre 6,1 Mds USD pour les entreprises dirigées par des hommes.
• 87 % proposent des initiatives pour les jeunes, pourtant ceux-ci ne représentent que 10 % des prêts aux MPME.
Ces chiffres reflètent un problème structurel: l’existence de programmes n’assure pas leur impact, et des mécanismes plus efficaces sont nécessaires pour toucher les bénéficiaires ciblés.
Partenariats: le rôle moteur des gouvernements
L’enquête confirme que les gouvernements restent les principaux acteurs facilitant le financement lié aux ODD :
• 43 % des banques déclarent avoir bénéficié d’un soutien gouvernemental
• 27 % ont collaboré avec des banques de développement
• 23 % avec des ONG
• 20 % avec le secteur privé
Cependant, 27 % n’ont noué aucun partenariat, ce qui souligne un besoin urgent d’élargir la coopération entre les parties prenantes pour stimuler la finance durable.
Soutien public aux MPME : entre instruments efficaces et lacunes persistantes
Les programmes étatiques jouent un rôle déterminant dans l’appétence des banques pour le financement des MPME :
• 80 % considèrent les prêts subventionnés comme un outil clé (47 % très important)
• 37 % jugent les garanties publiques essentielles pour réduire les risques
• 27 % seulement estiment que les réserves obligatoires réduites sont très influentes
En parallèle, près d’un tiers des banques signale l’absence ou la méconnaissance de programmes de cofinancement, révélant un chantier majeur pour les autorités publiques.
Produits durables: la FinTech progresse mais l’offre reste limitée
Les banques arabes amorcent progressivement l’intégration de produits financiers durables:
• La FinTech arrive en tête, notamment via la réduction des coûts des transferts.
• Les cartes vertes et fonds durables restent peu répandus (20 %).
• Les obligations durables et instruments de finance mixte sont encore plus rares (17 %).
• Un quart des banques n’offre aucun produit lié aux ODD, révélant une marge d’innovation importante.
Échantillon étudié : un reflet diversifié du secteur bancaire arabe
L’enquête a recueilli les réponses de 30 institutions financières de neuf pays arabes, représentant 8,7 % des membres de l’UAB.
Statut juridique:
• 50 % banques privées
• 43 % banques publiques
• 7 % banques étrangères
Type d’institution :
• 40 % banques commerciales
• 33 % banques islamiques
• 7 % banques d’investissement
• 20 % institutions spécialisées
Conclusion : un premier référentiel régional qui appelle à une montée en puissance
Cette enquête offre, pour la première fois, un diagnostic chiffré du financement des ODD dans la région arabe.
Elle met en évidence des volumes significatifs mobilisés, mais aussi des déséquilibres structurels dans les domaines du genre, de l’environnement, de la jeunesse et du numérique.
Les résultats appellent à :
• Renforcer les partenariats institutionnels,
• Améliorer les mécanismes d’incitation nationaux,
• Intégrer plus profondément les ODD dans les stratégies bancaires,
• élargir l’offre de produits verts et sociaux.
Cette première référence régionale prépare le terrain pour suivre les progrès en vue de l’objectif ambitieux de l’UAB : mobiliser 1 000 milliards USD pour les ODD d’ici 2030, conformément au Sevilla Commitment et aux efforts internationaux pour une architecture financière durable plus équitable.

Le Calendrier 2026 des Événements UAB
Le Calendrier 2026 des Événements UAB: Coopération, Innovation et Développement Durable
Un programme annuel qui illustre la vision régionale et internationale de
l’Union des Banques Arabes.Coopération, Innovation et Développement Durable
L’Union des Banques Arabes entame l’année 2026 avec un programme ambitieux d’événements régionaux et internationaux, reflétant sa mission de renforcer la coopération interbancaire arabe, d’accompagner les transformations numériques et de promouvoir la finance durable.
L’agenda s’ouvrira en janvier à Louqsor (Égypte) avec la deuxième Conférence arabe sur la lutte contre la fraude, organisée en partenariat avec la Banque Centrale d’Égypte et l’Université Arabe Naif des Sciences de la Sécurité, suivie en février à Beyrouth du Forum sur la gouvernance dans les banques, en collaboration avec l’Institut des Finances et de la Gouvernance (ESA). En avril, deux rendez-vous majeurs marqueront le calendrier: la troisième Conférence sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Bagdad, puis la Conférence bancaire arabe 2026 au Caire.
Le mois de mai sera consacré à l’innovation et à la durabilité, avec un forum à Doha sur les actifs numériques et le deuxième Forum stratégique (ESG) à Amman.
En juin, Paris accueillera le Sommet bancaire arabe-international 2026, tandis qu’Abou Dhabi abritera un forum dédié à l’innovation dans la gestion des risques et la conformité. L’été sera marqué par un forum sur l’inclusion financière à Tripoli en juillet et un autre sur les banques digitales à Beyrouth en août.
La rentrée de septembre mettra en avant la cybersécurité à Amman et la rencontre annuelle des directeurs des risques à Charm El-Cheikh.
En octobre, l’Union tiendra le Forum économique du Koweït et la quatrième Rencontre internationale de Mascate sur la gestion des risques. L’année s’achèvera par la Conférence bancaire arabe annuelle à Casablanca en novembre, puis par le Forum annuel des directeurs de la conformité à Hourghada en décembre.
À travers ce programme riche et diversifié, l’Union des Banques Arabes réaffirme son rôle de plateforme régionale de dialogue, de réflexion et d’action en faveur du développement durable et de la stabilité financière dans le monde arabe.

Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025 – Beyrouth
Sous le Haut Patronage de Son Excellence Le Président de la République Libanaise
le Général Joseph Aoun
Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025 – Beyrouth
«Investir dans la Reconstruction et le Rôle des Banques»
Stabilité régionale: l’étincelle qui dynamise l’investissement et engage les banques dans la reconstruction
Organisé par l’UAB en coopération avec l’Union Internationale des Banquiers Arabes et l’Association des Banques du Liban, l’événement intervient dans un contexte où de nombreux pays arabes sortent affaiblis par deux décennies de conflits ayant gravement touché les infrastructures, freiné la croissance et fait reculer l’investissement. Routes, ports, aéroports, logements et installations publiques portent encore les stigmates de destructions massives, nécessitant des financements colossaux et une mobilisation exceptionnelle des banques pour relever les défis de la reconstruction.
Yassine Jaber, ministre des Finances du Liban, représentant le Président Joseph Aoun: «Nous mettons en œuvre un plan de redressement économique fondé sur les réformes et le rôle moteur du secteur privé.
Dans ce contexte, la reconstruction s’impose désormais comme une priorité incontournable pour rétablir la stabilité politique et sociale, relancer l’activité économique, créer des emplois et soutenir un développement durable. Mais le principal défi réside dans l’ampleur des financements nécessaires, largement supérieure aux capacités budgétaires des États concernés. D’où la nécessité de recourir à des sources de financement alternatives, au premier rang desquelles figure le secteur bancaire arabe, fort de son expertise, de ses réseaux régionaux et de sa capacité à attirer les investissements internationaux.
La Conférence Bancaire Arabe Annuelle, tenue dans la capitale libanaise, a réuni de hautes personnalités officielles, économiques et bancaires du Liban et du monde arabe. Parmi les participants figuraient notamment le ministre Yassine Jaber, représentant le Président de la République, le général Joseph Aoun ; M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes ; le Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes ; M. Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises; le Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban; S.E. Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix et ancien membre du Conseil National Fédéral des Émirats Arabes Unis ; ainsi que l’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes.
Il convient de noter que le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique à l’occasion de la remise du Prix de la « Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025 », décerné à M. Ala’a Eraiqat, Directeur général du groupe Abu Dhabi Commercial Bank, aux Émirats Arabes Unis.
Dans son allocution, le ministre libanais des Finances, Yassine Jaber, a dressé un tableau sans précédent de la crise que traverse le Liban depuis 2019, marquée par l’effondrement du PIB, la dépréciation de la monnaie nationale, une inflation dépassant 200 %, le défaut souverain, l’effondrement du secteur bancaire et des pertes matérielles supérieures à 7 milliards de dollars dues aux conflits. Il a exposé la vision du gouvernement pour le redressement, fondée sur la restructuration du secteur bancaire et de la dette publique, une utilisation plus efficiente des ressources, la restauration de la confiance, le renforcement du cadre légal et des autorités de supervision, ainsi que la protection équitable des droits des déposants. Soulignant le rôle central du secteur privé, des infrastructures et de la transformation numérique, il a affirmé que, malgré l’ampleur de l’effondrement, le Liban demeure résolument engagé sur la voie du relèvement, fidèle à son image de pays-phénix renaissant de ses cendres, porté par un plan gouvernemental structuré autour de la réforme financière avec le FMI, de la modernisation du secteur public et du renforcement de la gouvernance pour attirer l’investissement.
 Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes: «La phase actuelle exige une feuille de route pour attirer les investissements et soutenir la croissance 60% de la main-d’œuvre arabe est composée de jeunes.»
Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes: «La phase actuelle exige une feuille de route pour attirer les investissements et soutenir la croissance 60% de la main-d’œuvre arabe est composée de jeunes.»
M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et Directeur général de la Banque Nationale d’Égypte, a déclaré que « la période actuelle requiert une vision d’avenir globale et un soutien aux trajectoires de développement afin de surmonter les défis présents ». Il a souligné «l’importance d’adopter une feuille de route intégrant des réformes économiques profondes, le renforcement du rôle du secteur financier et bancaire dans la stimulation de la croissance, ainsi que l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre de réformes sociales plus larges».
El Etreby a ajouté que « les principaux défis auxquels sont confrontés les pays de la région concernent le ralentissement des taux de croissance, la volatilité des taux de change et la montée du chômage ». Il a relevé que « les pays arabes disposent d’un formidable potentiel de jeunesse, qui représente 60 % de la main-d’œuvre, ainsi que d’un large éventail d’opportunités d’investissement dans l’ensemble des secteurs économiques ». Il a enfin insisté sur « la nécessité de renforcer l’attraction des investissements directs étrangers et d’appuyer la coopération interarabe ».
 Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes: «Le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international afin d’adopter les réformes économiques nécessaires et d’obtenir des prêts concessionnels.»
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes: «Le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international afin d’adopter les réformes économiques nécessaires et d’obtenir des prêts concessionnels.»
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes, a souligné que le retour de l’Assemblée générale à Beyrouth après quatre ans témoigne de la confiance arabe et internationale dans la capacité du Liban à retrouver son rôle. Il a salué le soutien constant apporté par les banques arabes au secteur bancaire libanais dans cette phase critique.
Il a rappelé que la région traverse « des défis sans précédent », marqués par les conflits, les crises monétaires et les pressions budgétaires qui ont affaibli la confiance dans plusieurs systèmes bancaires et réduit l’attractivité des investissements. Dans ce contexte fragile, la crise libanaise se distingue, selon lui, par son caractère unique : « une crise de liquidité avant tout, et non de solvabilité », aggravée par la contraction de l’activité bancaire et la baisse du crédit.
Le Dr Torbey a indiqué que le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international pour adopter les réformes nécessaires et obtenir des financements concessionnels, soulignant que la plupart des exigences financières ont déjà été satisfaites, à l’exception de l’annulation des dépôts une mesure qu’il juge « inacceptable », les dépôts constituant selon lui « le point de départ de toute solution de redressement ».
Il a rappelé les efforts menés par l’Union des Banques Arabes depuis 2023 pour proposer des pistes de sortie de crise avec l’appui d’experts internationaux, affirmant que la Banque du Liban reste, malgré la crise, l’une des plus solides de la région en termes d’avoirs. Il a également insisté sur le fait que les banques libanaises conservent des relations de correspondance internationales actives et continuent d’assurer les transferts financiers, malgré la liste grise et les notations souveraines dégradées.
Dr Torbey a mis en garde contre toute solution qui consisterait à annuler les capitaux propres des banques, avertissant qu’une telle approche « détruirait leur solvabilité, couperait leurs liens internationaux et plongerait le pays dans une isolation financière dangereuse », tout en aggravant les pertes des déposants.
Enfin, il a plaidé pour une réforme bancaire fondée sur le renforcement des fonds propres, la gestion des risques et la numérisation, ainsi qu’une réforme monétaire reposant sur l’indépendance des banques centrales et la stabilité des prix, conditions essentielles pour restaurer la confiance et attirer les investissements.
 Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban: « Nous sommes déterminés à reconstruire nos fonds propres et à restaurer la confiance des déposants. Il ne pourra y avoir de véritable reconstruction sans un financement bancaire sain. »
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban: « Nous sommes déterminés à reconstruire nos fonds propres et à restaurer la confiance des déposants. Il ne pourra y avoir de véritable reconstruction sans un financement bancaire sain. »
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban, a affirmé que les banques libanaises sont un « partenaire stratégique de la reconstruction économique », soulignant qu’« il ne peut y avoir de véritable relance sans un financement bancaire sain, ni de croissance durable sans un secteur bancaire solide et efficace».
Il a rappelé l’engagement des banques à « travailler aux côtés des secteurs productifs industrie, agriculture, tourisme, technologies et services afin de transformer l’épargne en investissements productifs et de financer les projets créateurs d’emplois et de valeur ajoutée ». Il a insisté sur la nécessité d’une « véritable collaboration entre le secteur bancaire et l’ensemble de l’économie, fondée sur la confiance et l’intérêt national ».
Dr Sfeir a appelé à « un dialogue constructif, des politiques claires et un plan de réformes globales qui traite les causes profondes de la crise ». Il a souligné que les banques « sont prêtes à faire partie de la solution, mais ne peuvent assumer seules la responsabilité de décennies de déséquilibres », plaidant pour « une approche équitable et inclusive où chaque institution assume pleinement ses responsabilités ».
Évoquant la crise depuis 2019, il a rappelé que les banques ont fait face à « une tempête sans précédent provoquée par des décennies de politiques financières erronées et de dépenses publiques incontrôlées », mais qu’elles ont « maintenu leur structure institutionnelle et continué à servir leurs clients malgré les difficultés ». Il a réaffirmé trois priorités :
– reconstruire les fonds propres selon les standards internationaux ;
– restaurer la confiance des déposants et des investisseurs par une gouvernance exemplaire ;
– développer des services innovants et numériques adaptés à l’économie du XXIe siècle.
Enfin, Dr Sfeir a exprimé le souhait d’une coopération plus étroite avec les autorités, déplorant que la participation de l’Association des Banques aux débats législatifs reste « consultative plus que partenariale ». Il a appelé à une approche plus inclusive afin de renforcer le rôle du secteur bancaire dans la relance économique, affirmant que « le rôle des banques dépasse désormais celui d’un simple intermédiaire financier ».
 Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises: « L’une des priorités majeures aujourd’hui est la relance du secteur bancaire libanais. »
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises: « L’une des priorités majeures aujourd’hui est la relance du secteur bancaire libanais. »
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises, a souligné que le Liban entre dans « une nouvelle phase » après l’élection du Président Joseph Aoun et la formation du gouvernement, marquant le retour au fonctionnement normal des institutions et le début d’un processus de restauration de la confiance.
Il a affirmé que le pays dispose de « capacités et de potentialités considérables », mais fait face à des priorités urgentes : la reconstruction des zones détruites, la modernisation des infrastructures, la réduction de la fracture financière et le renforcement de la protection sociale. Il a insisté sur le fait qu’« aucun plan de relance ne peut réussir sans le redressement du secteur bancaire libanais et sa capacité à retrouver son rôle au cœur de l’économie ».
Choucair a appelé les banques arabes à « s’intéresser au marché libanais » et à explorer les opportunités d’investissement, soulignant qu’il s’agit d’« investissements profitables, contribuant en parallèle au développement d’un pays arabe frère ». Selon lui, les opportunités sont nombreuses, tant dans le secteur privé industrie, tourisme, agriculture, technologies, immobilier que dans le secteur public, où l’État adopte de nouvelles approches fondées sur les partenariats public-privé, les BOT et des formes ciblées de privatisation.
En conclusion, il a mis en avant plusieurs indicateurs positifs, estimant que l’économie libanaise pourrait enregistrer une croissance de 5 % en 2025, et que le PIB, tombé à 18 milliards de dollars au plus fort de la crise, atteint désormais entre 38 et 40 milliards de dollars. Il a également relevé l’arrivée d’investissements d’un montant estimé entre 5 et 6 milliards de dollars ces dernières années.
 Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix: «Nous sommes prêts à coopérer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives conjointes qui soutiennent les efforts de reconstruction et stimulent le développement durable.»
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix: «Nous sommes prêts à coopérer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives conjointes qui soutiennent les efforts de reconstruction et stimulent le développement durable.»
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix, a décrit Beyrouth comme « la page blanche de la région », soulignant que « soutenir le Liban est un devoir arabe » et saluant le rôle mondial des élites libanaises.
Il a évoqué la visite attendue du Pape Léon XIV au Liban (27 novembre – 2 décembre 2025), la qualifiant de « message international clair de soutien au rôle historique du pays comme plateforme de dialogue et de rencontre civilisationnelle ». Selon lui, le choix du thème « Investir dans la reconstruction et le développement durable » reflète « une conscience arabe profonde des priorités de l’après-crise, où la reconstruction constitue la clé du retour de la confiance et de l’attractivité économique ».
Al Jarwan a affirmé que « le développement durable offre le cadre le plus complet pour garantir une reconstruction équilibrée, génératrice de croissance, de justice et de stabilité », ajoutant que la tenue de la conférence à Beyrouth «confirme son statut de capitale arabe de l’expertise bancaire, économique et du dialogue stratégique».
Il a présenté les initiatives du Conseil, notamment l’approche « Business Diplomacy », qui met l’accent sur le rôle de l’économie et de la création d’opportunités productives comme première ligne de défense contre l’extrémisme. Il a indiqué que le Conseil « œuvre à la tenue d’une conférence internationale élargie sur le rôle de l’économie dans la protection des sociétés ».
Enfin, Al Jarwan a rappelé que « la reconstruction ne se limite pas aux infrastructures, mais implique la reconstruction de l’humain, de la confiance et des institutions », soulignant « la nécessité d’intégrer développement durable, bonne gouvernance, médias responsables et secteur financier performant ». Il a réaffirmé « la pleine disponibilité du Conseil à collaborer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives communes renforçant la reconstruction, le développement durable et la stabilité dans la région ».
 L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes: « Une nouvelle Convention arabe d’investissement
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes: « Une nouvelle Convention arabe d’investissement
est en préparation pour faciliter la circulation
des capitaux. »
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint de la Ligue des États Arabes, a annoncé que la Ligue travaille à l’élaboration d’une nouvelle Convention arabe d’investissement visant à stimuler les flux d’investissement, faciliter la circulation des capitaux entre les pays arabes et renforcer la coopération face aux défis économiques mondiaux.
Il a souligné l’attachement de la Ligue au renforcement de l’intégration économique arabe et au rôle moteur du secteur privé dans le développement, insistant sur la nécessité de valoriser le potentiel des jeunes et d’accroître la coopération interarabe pour soutenir la croissance.
L’ambassadeur Zaki a affirmé la capacité du Liban à « absorber les chocs et bâtir un avenir meilleur » grâce à un renforcement de la coopération arabe et à l’orientation des investissements vers des projets à rendement durable. Il a conclu en appelant à une mobilisation collective des institutions arabes pour « assurer la compétitivité durable de la région et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement ».

Le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique en l’honneur d’Ala’a Eraiqat, récipiendaire du Prix de la Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025.
Dans une déclaration à la presse, il a souligné l’intérêt croissant d’investisseurs arabes pour le marché libanais, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier. Il a rappelé qu’il convient de distinguer entre les opportunités d’investissement disponibles, même dans un contexte difficile, et la capacité limitée du secteur bancaire libanais à financer ces projets dans sa phase actuelle.
Dr. Fattouh a précisé que « des investisseurs arabes et étrangers sont prêts à financer des projets industriels, immobiliers ou autres, y compris au Liban », ajoutant que l’Union des Banques Arabes « joue un rôle clé pour attirer des investisseurs internationaux et soutenir le secteur bancaire arabe et libanais ». Il a insisté sur l’importance de « bâtir des leviers alternatifs en matière de financement » en attendant la pleine reprise du secteur bancaire.
Il a affirmé que l’intérêt d’investisseurs arabes pour le Liban est réel, comme en témoigne la forte participation arabe à la conférence, traduisant « une volonté régionale de renouer avec le marché libanais et de restaurer progressivement la confiance, malgré l’ampleur des défis ».
Dr. Fattouh a enfin souligné que si l’Union des Banques Arabes joue pleinement son rôle, « il appartient également au gouvernement libanais d’avancer sur les réformes législatives et économiques attendues ». Il a conclu en réaffirmant l’objectif de l’UAB : « reconstruire la confiance entre le Liban et son environnement arabe, pour rouvrir la voie à de nouveaux investissements arabes et internationaux ».
SOMMAIRE OFFICIEL DES GRANDES RECOMMANDATIONS
CONFÉRENCE BANCAIRE ARABE ANNUELLE 2025 – BEYROUTH
1. Élaboration d’une vision arabe unifiée de la reconstruction, fondée sur un cadre stratégique commun entre gouvernements et institutions bancaires, visant à définir les priorités sectorielles et à renforcer la capacité de la région à capter les financements internationaux.
2. Renforcement du rôle des banques arabes dans le financement des projets d’infrastructures et de reconstruction, à travers le développement de produits spécialisés et l’élargissement des mécanismes de co-financement avec les fonds arabes et régionaux.
3. Généralisation des partenariats public-privé (PPP) comme instrument structurant de financement des grands projets, avec la nécessité de moderniser les cadres législatifs, renforcer la gouvernance et garantir la transparence.
4. Accélération des réformes économiques, fiscales et administratives, en vue d’améliorer l’environnement des affaires, stimuler l’investissement privé et renforcer la compétitivité des économies arabes.
5. Intégration stratégique du numérique, de la fintech et de l’intelligence artificielle dans les processus d’évaluation, de financement, de gestion des risques et de suivi des projets de reconstruction.
6. Lancement d’initiatives arabes communes de financement en faveur des PME productives, en tant que moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et de la stabilité sociale.
7. Renforcement de la coopération avec les grandes institutions financières internationales – Banque mondiale, FMI, BERD – afin de mobiliser des ressources additionnelles, fournir des garanties et sécuriser les grands projets structurants.
8. Confirmation que la stabilité politique, la bonne gouvernance et la transparence constituent le socle fondamental de toute reconstruction durable, sans lesquelles aucun investissement ne peut s’inscrire dans la durée.

De la fragilité à l’investissement: redéfinir le financement de la paix en Afrique
De la fragilité à l’investissement:
redéfinir le financement de la paix en Afrique
Lors du Forum sur la Résilience de la Banque Africaine de Développement (BAD), du 1er au 3 octobre à Abidjan, auquel a participé le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des solutions concrètes pour financer la paix et la résilience en Afrique ont été présentées pour transformer les régions dites « fragiles » en opportunités d’investissements durables.
Comment les marchés financiers peuvent-ils financer la paix et renforcer la résilience sur le continent africain ? Cette question a rythmé les échanges du Forum sur la Résilience organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD), qui a réuni investisseurs institutionnels, partenaires au développement et représentants gouvernementaux.
Le «coût de la fragilité»:
un frein à l’investissement en Afrique
Lors d’une des sessions, intitulée « Catalyser les marchés de capitaux pour financer la paix et libérer les opportunités d’investissement », Mme Blerta Cela, Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, a lancé un appel fort. « Le problème n’est pas le manque d’opportunités en Afrique, mais la manière dont le risque est perçu. Il faut changer la narration : passer de “fragile” à “investissable”, a-t-elle déclaré devant l’audience.
L’Afrique offre en effet des rendements sur les investissements directs étrangers (IDE) souvent supérieurs à ceux observés en Amérique latine ou en Asie. Pourtant, elle reste paradoxalement sous-financée. En cause : une prime de risque élevée, surnommée « prime de fragilité », qui augmente les coûts d’emprunt et dissuade les investisseurs.
Cette perception biaisée du risque, amplifiée par les méthodologies de notation de crédit, coûtent à l’Afrique 74,5 milliards de dollars par an en intérêts excessifs et en prêts non obtenus. Un manque à gagner quasi équivalent à son déficit annuel de financement des infrastructures africaines.
Pourtant, pour les investisseurs, l’Afrique ne devrait plus être une promesse lointaine : c’est un marché en pleine expansion, diversifié, jeune et innovant. Dans un contexte mondial en quête de nouvelles sources de croissance et de durabilité, le continent africain apparaît comme une évidence stratégique.
Une nouvelle approche: rendre
la paix “bancable”
Ainsi, pour inverser cette tendance, plusieurs institutions dont la BAD et le PNUD, aident les pays à renforcer leur solvabilité en comblant les lacunes de données et en facilitant le dialogue avec les agences de notation. Des programmes sont en cours en Côte d’Ivoire, en Somalie et en Éthiopie pour améliorer la perception des investisseurs et ainsi faciliter l’accès aux marchés financiers.
Ces institutions soutiennent également la conception et l’émission d’instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes, sociales ou bleues, qui permettent de financer des investissements durables. Le PNUD a par exemple appuyé le Mexique, qui est devenu en 2020 le premier pays au monde à émettre une obligation souveraine liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD), et en Côte d’Ivoire, a accompagné l’émission d’un emprunt souverain de 2,6 milliards USD dont une partie a été labellisée « durable » ainsi que la conception d’une obligation bleue de 375 millions USD liée à des indicateurs de cohésion sociale et de prévention des conflits.
Enfin, cette agence des Nations Unies s’est engagée à développer des pipelines de projets bancables et à soutenir l’écosystème des jeunes et des PME, comme l’illustrent des programmes comme timbuktoo et UNIPOD, qui valorisent l’investissement dans la formation, l’innovation locale « Made in Cote d’Ivoire » et le financement des jeunes entrepreneurs.
Des résultats concrets: électrification, réformes et confiance des investisseurs
L’approche de financement mixte commence déjà à porter ses fruits. Dans le Sahel, le PNUD a aussi mobilisé 50 millions USD de capitaux privés pour déployer des mini-réseaux solaires, électrifiant 350 villages et touchant près d’un million de personnes. Par ailleurs, des cadres régionaux d’émission d’obligations de durabilité sont en cours d’élaboration pour renforcer la transparence et la confiance des investisseurs.
Avec des outils financiers adaptés, il a été démontré qu’il était possible de transformer les défis de la fragilité en opportunités d’investissement à impact, pour une Afrique résiliente et tournée vers l’avenir . « La fragilité n’est pas une fatalité. Avec les bons mécanismes financiers, la jeunesse africaine, ses ressources et sa résilience peuvent devenir la prochaine frontière d’investissement à mille milliards de dollars », a conclu Mme Blerta Cela.
Transformer la paix en opportunité bancable constitue donc une approche utile pour aligner stabilité et développement sur les logiques financières internationales, mais elle ne peut réussir que si elle s’accompagne de réformes structurelles, d’une gouvernance crédible, et d’une redéfinition des critères de solvabilité pour y inclure la paix, la cohésion sociale et la résilience.
Source PNUD – COTE D’IVOIRE

L’Arabie saoudite domine la liste Forbes des banques les plus importantes de la région Mena pour 2025
L’Arabie saoudite domine la liste Forbes des banques les plus importantes de la région Mena pour 2025
- Les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées
- Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars
L’Arabie saoudite a dominé le classement Forbes des «30 banques les plus importantes en 2025», avec 10 entrées affichant une valeur de marché combinée de 269 milliards de dollars (1 dollar = 0,92 euro).
Selon le média spécialisé dans les affaires, les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées.
Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars, tandis que le Qatar détient six banques d’une valeur de 76,7 milliards de dollars. Le Maroc et le Koweït se targuent de trois et deux banques sur la liste, avec des valeurs de marché de 23,7 milliards de dollars et 68,4 milliards de dollars, respectivement.
Selon un récent rapport d’Ernst & Young, le secteur bancaire de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord reste solide et devrait connaître une forte croissance en 2025, grâce à la diversification économique, à des conditions financières favorables et à une expansion économique prévue de 3,5%, alimentée par des projets d’infrastructure et une augmentation de l’activité non pétrolière.
Dans un communiqué annonçant son dernier classement, Forbes a déclaré: «La liste de cette année comprend des banques de sept pays, dont 26 sont basées dans le Golfe. L’Arabie saoudite représente un tiers de la liste avec 10 entrées, pour une valeur de marché totale de 269 milliards de dollars.»
Le groupe de presse a noté que la valeur de marché totale des 30 banques a augmenté de 3,4% d’une année sur l’autre, passant de 581,1 milliards de dollars en février 2024 à 600,8 milliards de dollars au 31 janvier 2025.
La banque Al-Rajhi occupe la première place

Elle est suivie par la Saudi National Bank, avec 54,7 milliards de dollars, et la First Abu Dhabi Bank des Émirats arabes unis, évaluée à 43,7 milliards de dollars.
En dehors de ces trois premières banques, le groupe QNB du Qatar et la Kuwait Finance House occupent les quatrième et cinquième places, avec des valeurs de marché respectives de 41,2 milliards de dollars et 38,3 milliards de dollars.
Elles sont suivies par le groupe Emirates NBD des Émirats arabes unis, avec 28,9 milliards de dollars, et la National Bank of Kuwait du Koweït, avec 27,1 milliards de dollars.
Parmi les autres banques notables du classement figurent Abu Dhabi Commercial Bank et Riyad Bank. La liste comprend également des banques du Maroc et d’Oman.
Un secteur résilient
Le secteur bancaire de la région Mena a fait preuve de stabilité au cours de l’année écoulée, grâce à la hausse des taux d’intérêt et à la vigueur des prix du pétrole.
Selon un rapport de Fitch Ratings publié en 2024, l’environnement économique de la région a permis à la plupart des banques du Conseil de coopération du Golfe de maintenir leurs niveaux de liquidité, leur rentabilité et leurs solides réserves de capital.
Forbes Middle East a établi ce classement sur la base des valeurs de marché déclarées des banques cotées en bourse dans le monde arabe au 31 janvier 2025. Les filiales des sociétés cotées en bourse ont été exclues du classement et les taux de change ont été calculés à la même date.
Source: Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business
Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business
pour accélérer l’inclusion financière
et la digitalisation des TPE et des professionnels au Maroc

La carte Visa Business d’Al Barid Bank a été conçue pour soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets dans l’optimisation de la gestion de leur trésorerie et de leurs opérations financières professionnelles au Maroc et à l’étranger. Elle leur offre également un accompagnement au quotidien, grâce à des réductions et des avantages exclusifs proposés par Visa sur plus de 30 partenaires internationaux.
« Le lancement de cette nouvelle carte Visa Business d’Al Barid Bank constitue une nouvelle étape pour adresser efficacement les professionnels et la TPE grâce à une proposition de valeur forte, cohérente avec leurs besoins au quotidien, et qui leur ouvre la voie à la croissance. Cette offre reflète notre ferme volonté de soutenir les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs, les professionnels et la TPE, pour renforcer leur compétitivité à l’ère du digital » déclare Al Amine NEJJAR, Président du Directoire d’Al Barid Bank.
« Avec Al Barid Bank, nous œuvrons à élargir l’accès aux paiements numériques et à booster l’inclusion financière, en particulier pour les TPE et les commerçants qui sont le moteur essentiel de l’économie marocaine. Ce nouveau lancement avec Al Barid Bank est une étape clé dans notre roadmap stratégique dans le Royaume », affirme Sami Romdhane, Directeur Général Visa au Maroc
Fidèle à ses valeurs d’inclusivité et de proximité, Al Barid Bank propose désormais la carte Visa Business dans toutes ses agences, situées sur tout le Royaume même dans les localités les plus reculées.
Source : site AL BARID BANK

Les Assemblées annuelles 2025 du FMI
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI
et de la Banque mondiale: Un tournant majeur pour la gouvernance financière mondiale
Les Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se sont tenues à Washington D.C. du 13 au 18 octobre 2025, ont constitué l’un des rendez-vous économiques mondiaux les plus marquants de ces dernières années. Dans un contexte international traversé par des tensions géopolitiques persistantes, un ralentissement économique généralisé et une montée des vulnérabilités financières, les réunions de Washington ont placé au centre des discussions la question essentielle de la reconstruction de la confiance dans le système financier mondial, tout en répondant aux besoins urgents du développement durable et du climat.
Ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants d’organisations internationales, investisseurs institutionnels, experts et représentants de la société civile ont participé à une semaine dense de débats et de consultations, au cours desquels plusieurs messages clés ont émergé : la nécessité d’une gouvernance financière plus équitable, l’urgence de moderniser les outils de financement du développement, et l’importance de renforcer les partenariats entre secteurs public et privé.
Le représentant du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad, en compagnie du Président du Groupe de la Banque mondiale, M. Ajay Banga, lors des Assemblées annuelles 2025.
Un contexte économique international qui appelait à des réponses structurantes
Les travaux des Assemblées annuelles ont été dominés par les préoccupations liées au ralentissement de la croissance mondiale et aux implications d’un cycle prolongé de taux d’intérêt élevés. La fragmentation géoéconomique, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement et les pressions sur les finances publiques ont pesé lourdement sur les perspectives économiques de 2025.
Le FMI a rappelé que près de 60 % des économies émergentes faisaient face à des niveaux de dette préoccupants, nécessitant des solutions plus rapides, plus transparentes et plus inclusives pour les restructurations. Les discussions ont souligné l’importance d’accélérer le Global Sovereign Debt Roundtable et d’améliorer la coordination entre créanciers officiels et privés.
Les institutions de Bretton Woods ont également insisté sur la nécessité de renforcer les banques multilatérales de développement. La Banque mondiale a présenté l’avancement de sa transformation en une « Banque du Climat et du Développement », un repositionnement stratégique visant à étendre son effet de levier pour répondre aux besoins colossaux de financement de la transition énergétique, de l’adaptation climatique et des infrastructures résilientes.
 Le financement climatique et la transition énergétique au cœur des priorités
Le financement climatique et la transition énergétique au cœur des priorités
L’édition 2025 a donné une place centrale au financement climatique, thème devenu incontournable dans les débats internationaux. Les besoins mondiaux, estimés à plus de 2 400 milliards USD par an, ont rappelé l’urgence d’une mobilisation accrue du capital privé et d’une utilisation plus innovante des instruments financiers.
La Banque mondiale a mis en avant de nouveaux mécanismes de garanties, financements mixtes et partenariats public–privé, destinés à attirer des investissements dans les secteurs de l’énergie propre, de la gestion de l’eau, de la mobilité durable et de l’agriculture résiliente.
Les discussions ont également porté sur l’amélioration de l’accès aux financements concessionnels pour les pays vulnérables, ainsi que sur les conditions nécessaires pour que les transitions énergétiques restent justes, inclusives et compatibles avec les priorités nationales de développement.
Des enjeux stratégiques majeurs pour le monde arabe
Les délégations arabes ont été particulièrement actives durant ces Assemblées annuelles, mettant en avant une vision commune fondée sur la stabilité macroéconomique, l’intégration régionale, et l’accélération des réformes structurelles. Les pays du monde arabe ont souligné la nécessité :
• d’élargir l’accès à des financements abordables pour soutenir la transition énergétique et hydrique;
• d’approfondir les marchés de capitaux et de renforcer la supervision bancaire ;
• de soutenir l’investissement privé, notamment dans les infrastructures et les PME ;
• de promouvoir la transformation numérique, les fintech et l’inclusion financière.
Plusieurs pays ont insisté sur l’urgence d’établir des mécanismes plus efficaces pour restructurer la dette et élargir l’espace budgétaire dans les économies en crise ou en transition.
Les délégations ont également mis en lumière les progrès accomplis dans le domaine de la finance verte, avec une adoption croissante des cadres ESG, l’essor des marchés d’obligations vertes et durables, et l’intérêt grandissant pour les projets d’hydrogène, de désalinisation et d’infrastructures résilientes.
Le rôle central du secteur bancaire arabe
Le secteur bancaire arabe a été reconnu pour sa résilience, sa solvabilité et sa capacité d’adaptation face aux mutations économiques mondiales. Les banques arabes, soutenues par des cadres prudentiels solides et une forte dynamique de digitalisation, ont été identifiées comme des acteurs clés pour :
• le financement des transitions énergétique et écologique ;
• l’expansion des solutions fintech et la modernisation des paiements ;
• l’accélération de l’inclusion financière dans la région ;
• la mobilisation de capitaux privés pour les infrastructures ;
• la promotion des partenariats avec les banques multilatérales de développement.
Dans ce cadre, l’Union des Banques Arabes (UAB) a été largement sollicitée comme plateforme régionale de coopération et de plaidoyer, permettant de relier les institutions financières arabes aux grandes initiatives mondiales en matière de développement, de finance durable et de stabilité bancaire.
 Vers un nouveau contrat de gouvernance financière
Vers un nouveau contrat de gouvernance financière
L’un des enseignements majeurs des Assemblées annuelles 2025 réside dans la prise de conscience collective que l’architecture financière internationale doit évoluer pour répondre efficacement aux crises actuelles et futures. Les discussions ont mis en avant :
• une demande croissante pour une gouvernance plus inclusive ;
• un rôle accru des économies émergentes dans la prise de décision ;
• une plus grande mobilisation du secteur privé dans le financement du développement ;
• la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des crises ;
• l’importance d’intégrer les impératifs climatiques au cœur des politiques économiques.
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale auront marqué une étape déterminante dans la réflexion mondiale sur l’avenir de la finance, du développement et de la gouvernance économique.
Elles ont confirmé l’entrée dans une nouvelle phase, où the financement du climat, la transformation énergétique, la résilience économique et l’innovation financière constituent désormais les piliers d’une croissance durable.
Pour le monde arabe, cette édition aura été l’occasion d’affirmer une vision commune, d’exposer des priorités régionales structurantes, et de renforcer la position du secteur bancaire arabe comme partenaire incontournable des transitions économiques à venir.
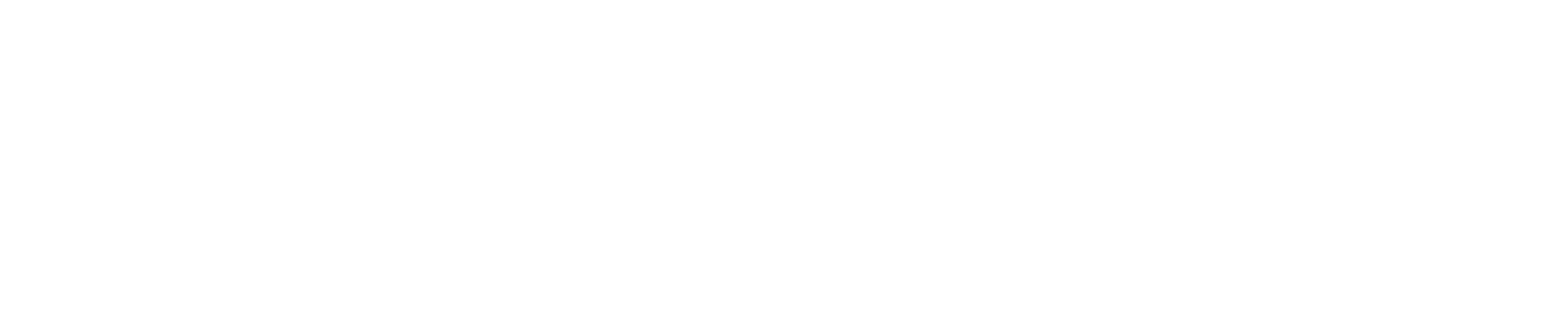

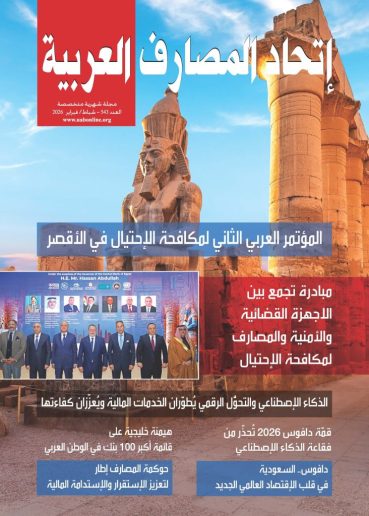












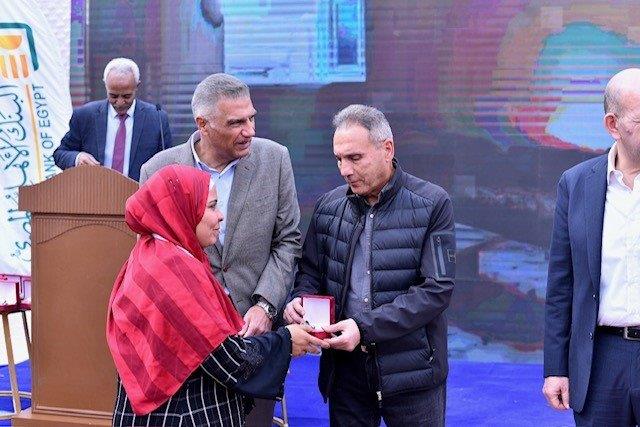


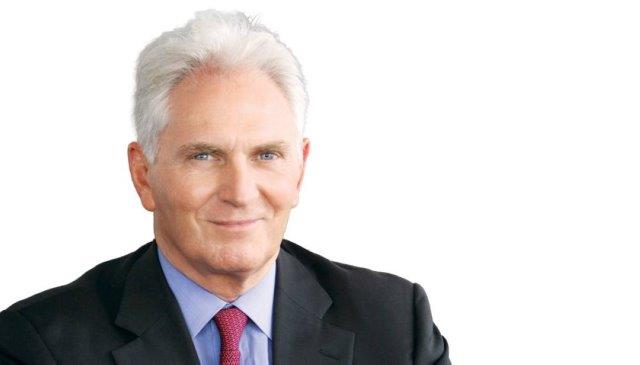
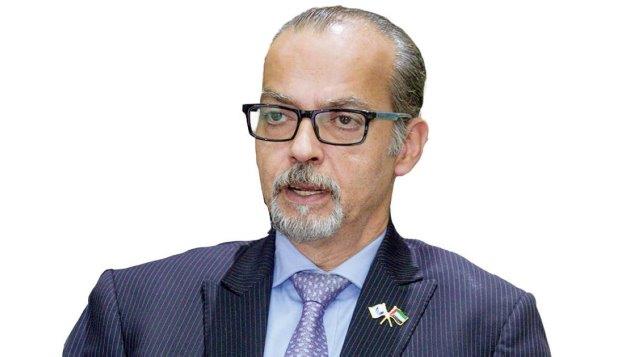


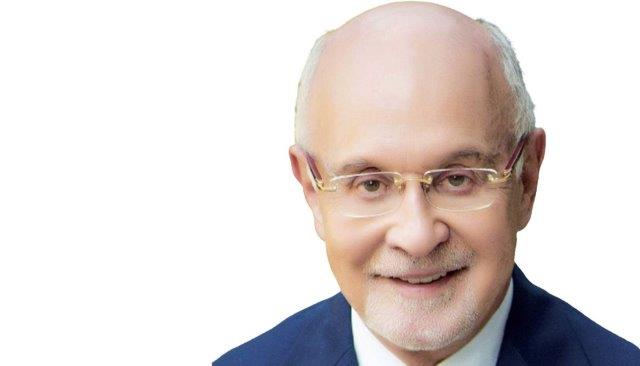








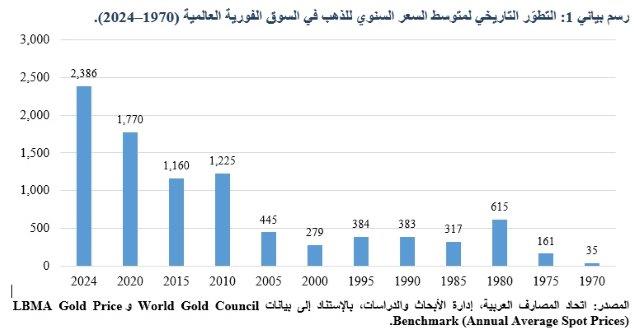
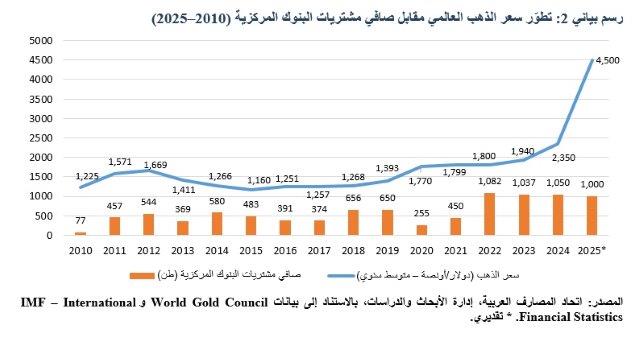 إحتياطات المصارف المركزية من الذهب
إحتياطات المصارف المركزية من الذهب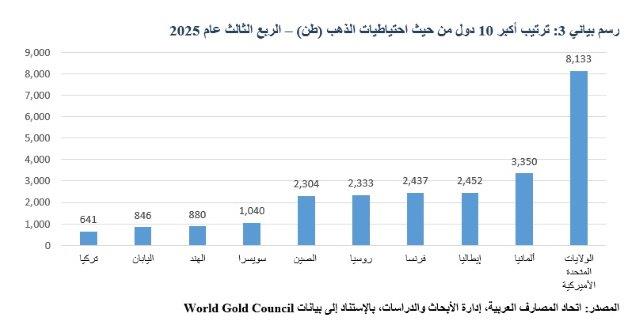


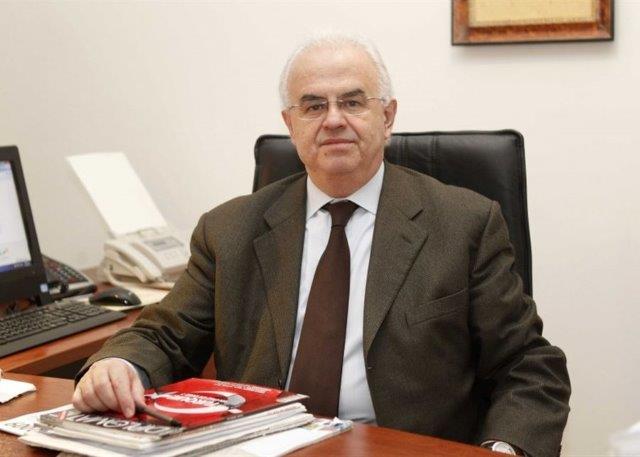 ا
ا