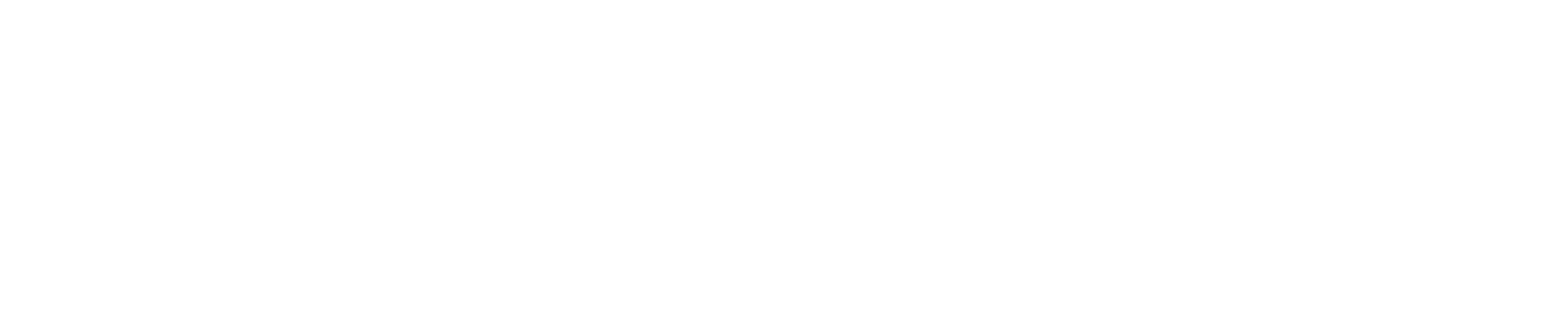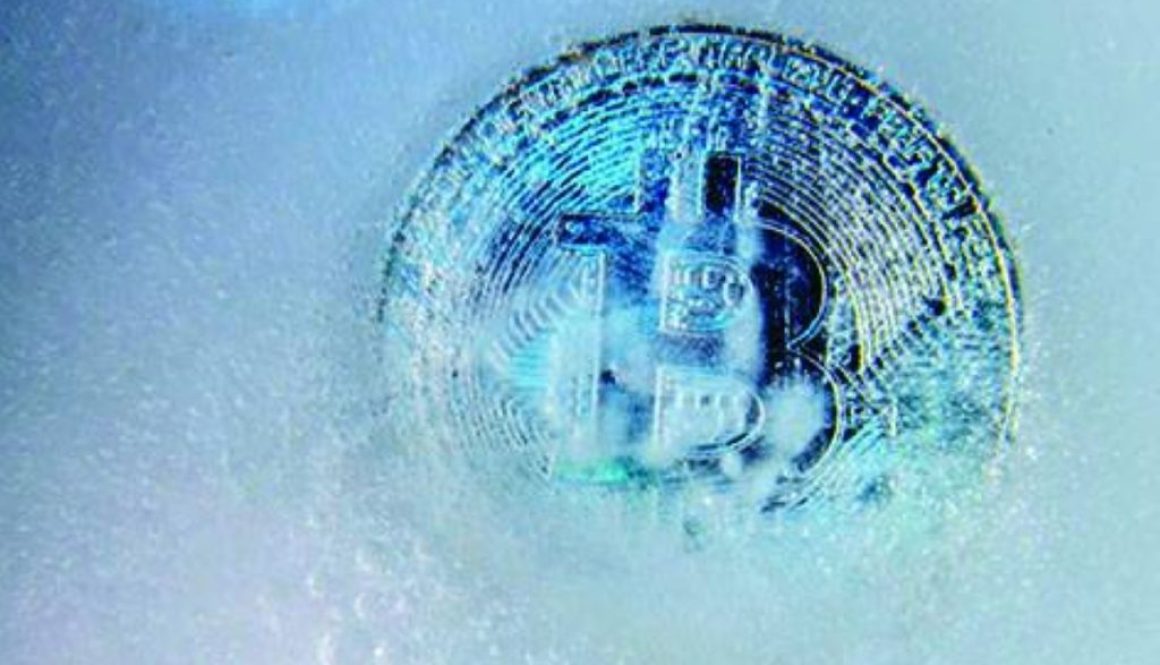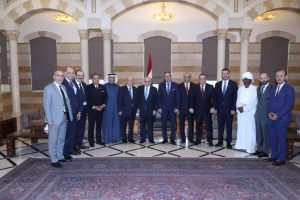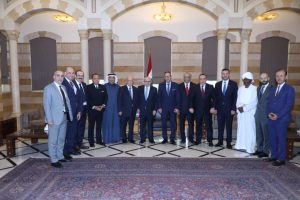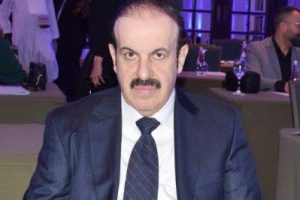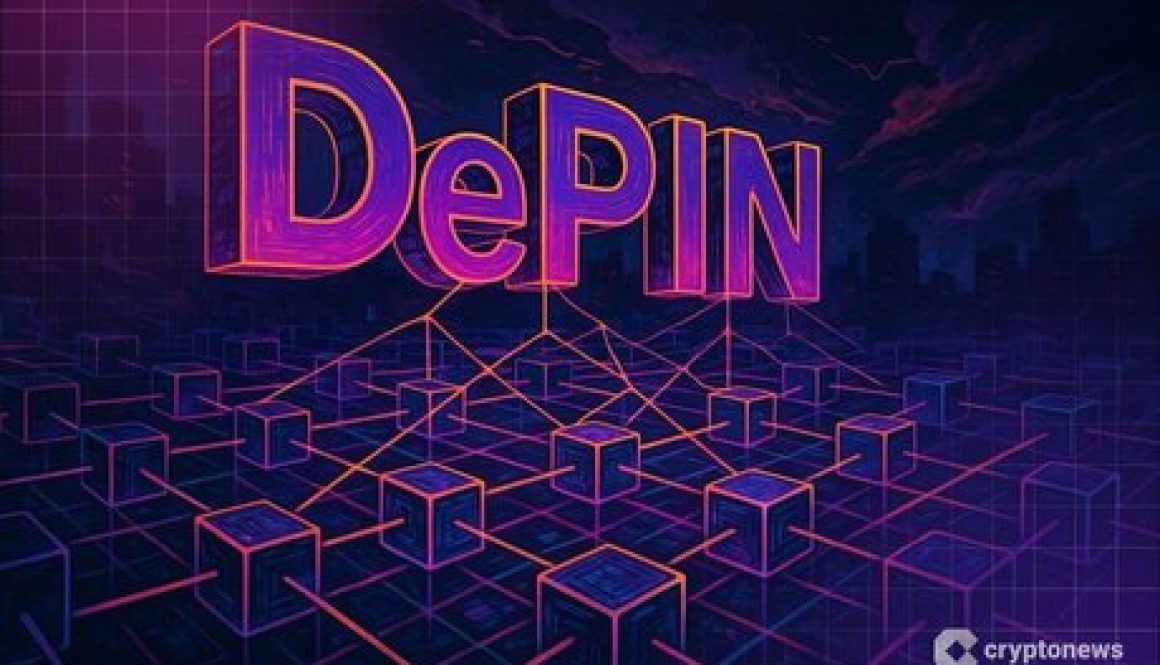الإمارات ضمن الأعلى عالمياً في الامتثال الضريبي
(البيان)-08/12/2025
بلغ عدد المسجلين بضريبة الشركات أكثر من 640 ألف مسجل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ما يعكس الارتفاع الكبير في مستوى الامتثال الضريبي نتيجة زيادة الوعي وانتشار الثقافة الضريبية، وسهولة إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر منصة «إمارات تاكس»، حسبما أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريحات لـ «البيان».
وقال البستاني: يتم تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بضريبة الشركات عبر منصة (إمارات تاكس للخدمات الضريبية الرقمية) من خلال خطوات تستغرق دقائق محدودة، فيما يتم إجراء تحسينات مستمرة على المنصة لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الضريبية بسهولة وكفاءة.
وأضاف: منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات حرصت الهيئة على تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة للتعريف بضريبة الشركات ومتطلبات الامتثال للضريبة، وذلك من خلال استراتيجية توعية متكاملة شملت الفئات المعنية بجميع إمارات الدولة، فمنذ شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نفذت الهيئة أكثر من 155 فعالية حضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للتوعية بضريبة الشركات استفاد منها أكثر من 48 ألف مشارك.
بين الأعلى عالمياً
وحول تقييمه لمستوى التزام الشركات والأفراد بدفع الضرائب، قال البستاني: «على الرغم من إرساء المنظومة الضريبية في الإمارات قبل 8 سنوات فقط، إلا أن معدل الامتثال الضريبي شهد تحسناً ملحوظاً، سواء من الشركات أم الأفراد الخاضعين للضريبة؛ فقد أصبحت نسب الالتزام الضريبي من بين الأعلى عالمياً، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أبرزها زيادة الوعي الضريبي في مجتمع الأعمال، والتفاعل الإيجابي من فئات المجتمع عموماً والخاضعين للضريبة بصفة خاصة الذين أظهروا تجاوباً كبيراً مع الإجراءات والسياسات الضريبية التي تطبقها الهيئة الاتحادية للضرائب. كما أسهمت جهود التوعية المكثفة التي تبذلها الهيئة من خلال الحملات التوعية والبرامج التدريبية والتواصل المستمر في تعزيز فهم الالتزامات الضريبية وترسيخ ثقافة الامتثال.
وذكر أنه من العوامل الرئيسية التي عززت التحسن المستمر في معدلات الامتثال الضريبي، كذلك المبادرات العديدة التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتسريع الإجراءات الضريبية في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية» الذي يهدف لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، فتم اعتماد أكثر من 100 عملية لتصفير خدمات الهيئة عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية، اكتمل منها 64 عملية تصفير، حيث تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 53%، وتقليل الحقول بنسبة 55%، وتقليص وقت إنجاز الخدمة بنسبة 77%، وجاري استكمال بقية عمليات تصفير البيروقراطية الرقمية وتقديم التسهيلات وإلغاء المزيد من الإجراءات، وتقليل مدد إنجاز خدمات الهيئة بما يتماشى مع هذا البرنامج الطموح.
التحديات
وحول التحديات التي واجهتها الهيئة في تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي، قال البستاني: مع بدء تطبيق النظام الضريبي واجهت الهيئة بعض التحديات؛ أبرزها حداثة التجربة الضريبية في المجتمع الإماراتي، ومحدودية المعرفة بآليات الامتثال والتعامل مع المنظومة الضريبية، إضافة إلى قلة الوعي بأهمية النظام الضريبي ودوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التنمية المستدامة.
وأكد أنه نجحت دولة الإمارات في ترسيخ نموذج يحتذى به في مجال الامتثال الضريبي الطوعي، نتيجة قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات والإجراءات الأساسية؛ حيث تم توفير منظومة رقمية سلسة، تشجع الخاضعين للضريبة على انتهاج نموذج الامتثال الطوعي في إطار السياسات الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات المتعاملين وبما يلبي تطلعاتهم.
وتابع: تطبق الهيئة استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الضريبي، وتقوم بصفة متواصلة بتوسيع وتنويع قنوات التوعية باستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية لدى جميع فئات الأعمال والمجتمع، ونفذت آلاف الفعاليات الحضورية في جميع إمارات الدولة وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بالقطاع الضريبي، كما شهدت الفترة الماضية إصدار أكثر من 1950 توضيحاً ضريبياً ودليلاً إرشادياً استهدفت رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي عبر توضيح وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتوفر الهيئة معلومات إرشادية يتم تحديثها بصفة مستمرة تتميز بالتنوع وسهولة ووضوح المحتوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتيح كذلك مجموعة من برامج التعلم الإلكتروني، وأفلام التوعية القصيرة.
وعن الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتبسيط الامتثال وضمان وضوح القوانين أمام مجتمع الأعمال، أوضح البستاني أنه منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات حرصت الهيئة على تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة للتعريف بضريبة الشركات ومتطلبات الامتثال للضريبة، وذلك من خلال استراتيجية توعية متكاملة شملت الفئات المعنية بجميع إمارات الدولة، فمنذ شهر يوليو 2023 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نفذت الهيئة أكثر من 155 فعالية حضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للتوعية بضريبة الشركات استفاد منها أكثر من 48 ألف مشارك.
التواصل المباشر
وذكر أنه يتم التواصل المباشر مع الخاضعين للضريبة عبر مركز دعم دافعي الضرائب، وخدمة الدردشة الحية، ومركز الاتصال بالهيئة، ورسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى الرسائل النصية، والتوعية عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقيام المختصين بالهيئة بتنفيذ اتصالات هاتفية بالخاضعين لضريبة الشركات لتذكيرهم بالقيام بالاستحقاقات الضريبية في فتراتها المحددة.
ولفت إلى أنه انعكست هذه الجهود على النتائج الإيجابية التي سجلت خلال الفترة الضريبية الماضية، حيث بادر الخاضعون للضريبة إلى التسجيل المبكر وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية خلال الفترات القانونية المحددة لكل فئة، كما أكدت الأعداد الكبيرة من طلبات التسجيل والإقرارات وعمليات سداد المستحقات الضريبية نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تطبق آليات امتثال رقمية متكاملة تعد الأحدث من نوعها عالمياً، حيث أتاحت الهيئة منصة «إمارات تاكس» التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة.
وأوضح أنه شهدت هذه الخدمات تطوراً ملحوظاً بمزيد من التسهيلات بتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية، سواء فيما يتعلق بآليات عملها وتنفيذها داخلياً، أم في التسهيلات الإجرائية الكبيرة التي انعكست إيجابياً بصورة ملحوظة على تجربة المتعامل نتيجة تبسيط الإجراءات وتقليص جهد المتعامل، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي عبر إلغاء مجموعة كبيرة من الأعباء والقيود في قطاع الأعمال، ما ساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات.